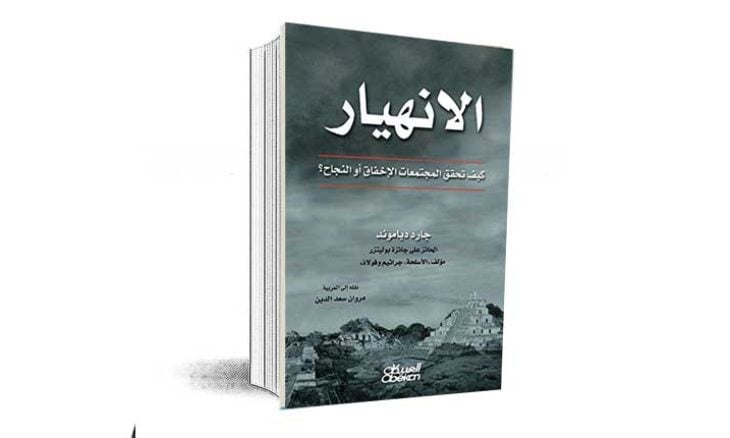: في سياق أي ثورة، يتطلب تحليل المصطلحات التي تنتج عنها وعياً عميقاً لتأثير تلك المصطلحات على الفهم الجماعي للحركة الثورية. الثورة السورية، بأبعادها المعقدة وآثارها العميقة، أفرزت مجموعة من المصطلحات التي وصفت مختلف الفئات التي تفاعلت معها، سواء بالمشاركة أو الصمت أو التأييد للنظام البائد. هذه المصطلحات أصبحت أداة أساسية لفهم تركيبة المجتمع السوري خلال تلك الفترة، ولكنها أحياناً تتحول إلى أدوات مغلوطة تُستخدم لتشويه الحقائق أو إرباك المفاهيم. من هنا، تصبح الحاجة ماسة إلى الحذر في استخدامها، وإعادة ضبط معانيها بما يخدم الحقيقة دون الوقوع في فخ التحريض أو المغالطات.
فهم المصطلحات في ظل الثورة:
الشبيحة
الشبيحة هم الفئة التي جسدت القمع الصريح للنظام السوري البائد. كانوا أداة النظام لضمان بقائه من خلال العنف المباشر، سواء الجسدي أو النفسي. دورهم يتخطى الدعم العلني إلى التورط في أعمال وحشية، سواء بالتحريض أو المشاركة الفعلية. من المهم أن نذكر هنا ما قاله الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو عن علاقة السلطة بالعنف: “السلطة ليست فقط ما يُقال، بل هي ما يُمارس”، والشبيحة مثال حي لهذه الممارسة العنيفة التي تعمل في خدمة السلطة. ولا يخفى على أي مطلع، أن المرحوم الكاتب والشاعر السوري الكبير ممدوح عدوان، قد قدم لوصفهم في كتابه حيونة الإنسان بشكل واف وكاف.
الرماديون
الرماديون هم الأشخاص الذين اختاروا الحياد الظاهري في مواجهة النظام والثورة، مفضلين الصمت على اتخاذ موقف علني. هذا الصمت، رغم كونه موقفاً شخصياً، يظل محاطاً بالتساؤلات. فقد قال الشاعر الألماني بيرتولت بريخت: “الحياد في زمن الظلم هو بحد ذاته اختيار للظالم”. من هنا، يتجاوز وصف الرمادي مجرد موقف صامت إلى حالة قد تُفهم على أنها تأييد ضمني للنظام بسبب غياب المعارضة الواضحة. ومع ذلك، لا يمكن المساواة بين الرماديين والشبيحة، لأن مواقفهم لا تنطوي على عنف موجه، بل على خوف أو تردد.
المندسون والإرهابيون
هذه المصطلحات صنعها النظام السوري كسلاح نفسي لتشويه صورة الثوار الأحرار. وصف الثوار بـ”الإرهابيين” أو “المندسين” لم يكن مجرد استهداف شخصي، بل كان استراتيجية تهدف إلى تفكيك الحركة الثورية وتقليل الدعم الشعبي لها. هنا يمكننا أن نتذكر كلمات جوزيف غوبلز، وزير الدعاية النازي: “اكذب حتى يُصدقك الناس”. هذه الأكاذيب كانت تهدف إلى تقويض مصداقية الثورة، لكنها أيضاً أظهرت هشاشة النظام الذي اعتمد على خطاب دعائي بدلاً من مواجهة حقيقية للأزمات.
المكوعون
المكوعون هم الفئة التي انتقلت من تأييد النظام إلى الانضمام للثورة بعد سقوطه، مدعية أن مواقفها السابقة كانت بدافع الخوف أو الجهل بطبيعة النظام. هذه الفئة موجودة في كل ثورة، إذ إن كثيراً من الناس يميلون للانحياز إلى الطرف الأقوى أو المنتصر لضمان مصالحهم الشخصية. التاريخ مليء بهذه الأمثلة؛ فقد شهدت الثورة الفرنسية حالات مشابهة عندما انقلب بعض المؤيدين للملكية على مواقفهم لينضموا إلى الثورة بعد انتصارها. المقهورون هذه الفئة، رغم صمتها، كانت تحمل في قلوبها الأمل والتأييد للثورة، لكنها لم تكن قادرة على التعبير بسبب ظروفها القاهرة. هؤلاء هم “معذبو الأرض”، كما وصفهم فرانز فانون. إنهم يمثلون الضحية الصامتة، التي لم تتمكن من المشاركة الفعلية، لكنها عاشت كل لحظة من الثورة بفرح داخلي لكل انتصار وبألم لكل هزيمة. المقهورون لا ينبغي أن يُخلطوا مع الرماديين أو المكوعين، لأن صمتهم كان مفروضاً عليهم، وليس خياراً واعياً.
بشأن الشبيحة والرماديين ومن يحاول أن يتستر خلفهم:
الشبيحة، الذين مثلوا الوجه الأوضح للعنف والقمع، لم يكونوا مجرد أداة للنظام، بل كانوا نموذجاً للقسوة التي تجعل المجتمع ينفر من أي محاولة لتبرير أفعالهم أو الاستشهاد بسلوكهم. أما الرماديون، الذين اختاروا الصمت أو الحياد، فهم فئة معقدة يجب التعامل معها بفهم أعمق؛ صمتهم لا يُبرر ولكنه أيضاً لا يجعلهم في مصاف الشبيحة. غير أن الأخطر هو محاولات بعض الأفراد أو الجهات اليوم التستر خلف هذه المصطلحات لتوجيه سهام التحريض ضد الثوار أو محاولة تقويض إنجازات الثورة. مثل هذه الخطابات التحريضية تسعى لتشويه الصورة العامة للثورة عبر المساواة بين الضحية والجلاد، أو عبر استغلال مواقف الرماديين لتبرير السلوكيات السلبية أو التخاذل. هنا تتضح الحاجة إلى تفكيك هذا الخطاب وكشف تناقضاته. فالتحريض ضد الثورة باسم النقد أو الحرية لا يختلف في جوهره عن خطاب النظام الذي كان يسعى لشيطنة الثورة والثوار. كما قال الروائي الروسي دوستويفسكي: “الكذب على الذات أخطر من الكذب على الآخرين؛ لأنه يُمهد الطريق للهاوية”.
استخدام الشبيحة والرماديين كذريعة لشن هجمات ضد الثورة أو الثوار الحقيقيين هو في جوهره شكل من أشكال التضليل الذي يعيد إنتاج أدوات النظام القمعية، وإن في سياق مختلف. المطلوب من كل من يطرح خطاباً عاماً اليوم هو الحذر من الوقوع في فخ التحريض المبطن، سواء بقصد أو دون قصد. المسؤولية الأخلاقية والفكرية تتطلب خطاباً نزيهاً لا يُفرّق ولا يُحرّض، بل يُشجع على النقد البناء والتقييم العادل. وكما أتاح سقوط النظام حرية التعبير، فإن استخدام هذه الحرية يجب أن يكون موجهاً نحو البناء لا الهدم، ونحو الوحدة لا الانقسام. وماذا حول انتقاد الثوار أنفسهم: واحدة من القضايا المثيرة للجدل في النقاشات العامة هي الميل لوصف بعض الثوار بـ”الشبيحة الجدد”، وهو وصف يفتقر إلى الدقة والإنصاف. إذا ظهرت بعض التيارات الثورية التي تشكر رموزاً أو قيادات معينة، مظهرة نوعا من الامتنان العميق، الذي يحاول البعض من ذوي الغايات تقديمه بصورة مضخمة كتقديس أو تطبيل، فإن هذا لا يعني أبداً أنها تعادل في طبيعتها الشبيحة الذين مارسوا العنف وساهموا في تدمير البلاد. النقد لهذه التيارات ممكن ومشروع، لكنه يجب أن يكون نقداً بناءً ومبنياً على توضيح نقاط الضعف أو التناقضات بدلاً من الوقوع في فخ المقارنات الظالمة.
الثورات عبر التاريخ، من الفرنسية إلى الروسية، شهدت انقسامات وصراعات داخلية، لكن ذلك لم يكن يعني إدانة كاملة لهذه الحركات أو مساواتها بأعدائها. كما أشار برتراند راسل: “النقد هو محاولة لفهم الحقيقة، وليس لنفيها”. لذلك، يجب أن يُمارَس النقد بحذر ودقة، لتجنب تعزيز الانقسامات أو التشكيك في شرعية الثورة ذاتها. يغدو مفهوما أيضا أن هنالك من يشعر بالتهديد بسبب انخراطه مجبرا في الفترة السوداوية السابقة بالعمل والتعاون مع من كان مؤيدا علنا لساوك النظام البائد، ولذلك وبدافع الخشية من احتسابه على تيار معين، ينحو للخشونة اللفظية في تقديم مخاوفه، مشيطنا كل ما لا يعتبره خطابا تسامحيا! خالطا بذلك الحابل بالنابل، متناسيا في طروحاته أن العدالة شرط أساسي وضروري ليس فقط للمسامحة وبناء الدولة الجديدة، بل لفهم أعمق لظروفه نفسها التي نحت به نحو الصمت. في أي مجتمع ما بعد ثوري، تصبح الكلمات أدوات ذات تأثير كبير. الخطاب العام الذي يروج لتحريض فئة ضد أخرى لا يخدم سوى إعادة إنتاج أساليب النظام القمعي الذي ثارت عليه الجماهير. هنا يكمن دور المثقفين والناشطين في استخدام منصاتهم لبناء جسور الحوار بدلاً من تعميق الانقسامات. وكما قال الكاتب جيمس بالدوين: “أن تقول الحقيقة هو فعل ثوري بحد ذاته”. بدلاً من استغلال الحرية المكتسبة في التحريض أو الانتقاص، يجب أن يُوجه الخطاب نحو البناء والنقد الإيجابي. فالمسؤولية الأخلاقية للمثقف حتى لو صمت سابقا، تكمن في احترام تلك الحرية وتوظيفها لتعزيز الحوار البناء. والمراحل الانتقالية بعد أي ثورة تتطلب مراجعة دقيقة للغة والخطاب. اللغة، كما وصفها الناقد الأدبي رولان بارت، ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وسيلة لبناء التصورات الجماعية. لذا، يجب على الخطاب أن يتجنب المغالطات والمصطلحات التحريضية، أن يوضح الفروق بين الفئات المختلفة بدقة وإنصاف. أن يستثمر الحرية المكتسبة في خلق حوار شامل وبناء. أن يحترم التضحيات التي قُدمت من أجل الثورة، ويُظهر الامتنان لمن مهدوا الطريق للحرية. الكلمات التي نقولها اليوم تُحدد المسار الذي ستتبعه الأجيال القادمة، لذلك علينا أن نختارها بحكمة ومسؤولية.