ترجمة محمد حبيب
ذاتَ مساء من العقد الأخير في القرن الماضي، كنتُ أحتسي البيرة مع زميلٍ أكبرَ منِّي سنّاً. كما هو الحالُ غالباً، عندما يجتمع علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة، تطرَّقنا إلى مواضيعَ عديدةٍ في تلك الأمسية. في أفضل وأسوأ حالاتها، تتميَّزُ الأنثروبولوجيا بالاستطرادِ الهوسيِّ. فبعدَ جولةٍ مثيرةٍ للاهتمام، لكن طويلةٍ ومتشعّبةِ المواضيعِ بدءاً من طقوسِ القرابين في أفريقيا الوسطى مروراً بعلمِ الكونيّات الأمازونيّة، خلصَ زميلي إلى القول: «كما تعلم يا توماس، يقومُ معنى الحياة على ثلاثة أشياء: الإيمانُ بالله، وإنجابُ الأطفال، وأضاف بعد صمتٍ… يبدو أنني نسيتُ الشيء الثالث”.
جاءت هذه الملاحظة، التي نادراً ما كانت تُؤخذ على محمل الجد، من أحد اللا أدريين الذين لم ينجبوا أطفالاً. لكن من الواضح أن صديقي، وإن لم يكن جاداً، فقد كان على وشك الإفصاح عن شيءٍ ما. فما هو بالضبط هذا المعنى الثالث الذي نسيه؟
للمتشائمين مقاربتُهم المختلفة عن الذين يبحثون عن هذا المعنى الثالث، والذي نسوا ما هو. وهم يفترضون مسبقاً أنّ الحياة لا معنى لها. في عمله الكبير “عن المأساوي”، الذي نُشر في عام 1941، أوضح الفيلسوف بيتر فيسيل زابفه[1] السبب: نحن البشر مجهَّزون أكثر من اللازم. ولدينا، مثل أنواع الحيوانات الأخرى، احتياجات الثدييات للطعام والنوم والتكاثر وما إلى ذلك، لكننا مجهَّزون أيضاً بالحاجة إلى المعنى الكامل للحياة، والذي لا يمكن إشباعه إلا من خلال خداع الذات، بينما يتمُّ التعبير عنه عادةً من خلال الإيمان بإلهٍ واحد، أو عدّة آلهة غير موجودة، وعندما ينكشف خداع الذات، يدرك الإنسان أن لا معنى للحياة. وهنا يكمن تفسير عنوان كتاب زابفه.
بعد أربعين عاماً، نشر زابفه مجلّداً صغيراً يتضمّن حواراً مع زميله الفيلسوف هيرمان تونيسن بعنوان “أنا أختار الحقيقة”. لم يكن تونيسن وافداً جديداً على انعدام المعنى الأساسي للحياة، ففي ستينيات القرن الماضي، أثار ضجّةً طفيفة بمقاله الأكاديمي “السعادة للخنازير: الفلسفة في مواجهة العلاج النفسي”. لم يكن الخلاف بينهما مستعصياً على الحلّ، لكن في حين أصرَّ زابفه على أنّ الحياة لا معنى لها، أكّد تونيسن على أنّ الحياة ليست حتى بلا معنى، بل مجرّد طرحِ السؤال يفترض مسبقاً أنّ مفهوم “معنى الحياة” كان تأطيراً معقولاً لمشكلةٍ قابلة للطرح.
يقول الفيلسوف البيئي آرنه نايس في تعليقه على الحوار، إنّ زابفه وتونيسن يطرحان السؤال الخطأ. ويضيف إنه لا يمكن العثور على معنى الحياة على المستوى الميتافيزيقي، ومن الخطأ البحث عن معنى شامل للحياة البشرية على هذا النحو. على العكس من ذلك، تكمن معاني الحياة المتعدّدة في الأشياء الصغيرة، مثل جمال أوراق الخريف التي تغطّي الأرض في أواخر أكتوبر.
الموضوع ليس جديداً تماماً. فقد سعى البشر وراء الكمال في الكون وتحديدِ توجُّهٍ لوجودهم، منذ نشأة اللغة على الأقلّ، لكن لديَّ أسبابي الخاصّة للاهتمام به أكثر من غيري. فبسبب عملي كعالم أنثروبولوجيا اجتماعية، كنت طوال حياتي في حوارٍ مستمرٍّ مع أشخاصٍ من ثقافاتٍ مختلفة، توصّلت من خلالها إلى أنَّ الناس في كلّ مكان يهتمّون بمعنى الحياة إذا ما أُتيحت لهم فرصة التفكير فيه، لكنّهم يقدّمون إجاباتٍ مختلفةً تماماً. بالنسبة للبعض، تصبح الحياة ذاتَ معنى عندما تقوم بأعمالٍ خيريّةٍ أو تقيّةٍ تضمن لك مكاناً أفضل عندما تنتهي حياتُك الدنيويّة. بالنسبة للبعض الآخر، يكمن المعنى في أن تكون ابناً بارّاً أو والداً صالحاً، أو أن تستمتع بما لديك سواء كان ذلك سيارةً كهربائية أو حبيباً، أو قربك من روائح الحياة البرية في الغابات المطيرة. ولم أشعر قطّ أن أياً من هذه الإجابات خاطئ، أو أنها تتناقض في الجوهر، لأنّ المعنى يعتمد على السياق. كما ألحَّ السؤال عليَّ بشكلٍ خاصٍ في السنوات الأخيرة، بعد أن تمّ تشخيص إصابتي بسرطان الدم في عام 2016 ووجدت نفسي على شفير الموت لبضع سنوات. في تلك الفترة، تعلّمت الكثير، بما في ذلك حذف كلمة “لا يُشفى” من معجم مفرداتي النشطة.
في الواقع، من غير المرجَّح أن نتمكن من الإجابة على هذا السؤال بالعلم. وربّما لن نقتربَ أبداً من الإجابات النهائيّة في هذا المجال، على الرَّغم من أنّ هذا الفكر غير مألوف للأشخاص الذين تعلّموا الإيمان بالتقدّم والتنمية. بمعنى ما، نحن لا نزال خارج فتحة الكهف، أو في أغورا سقراط، أو في ظلِّ شجرة البانيان عند قدمي غوتاما بوذا. إنّ الرسائل الواردة من السكَّان الأصليين الأميركيين والتي مفادُها أنّه لا يمكن لأحدٍ أن يمتلك الطبيعة، أو من الحكايات الشعبية في غرب أفريقيا التي تُعَلِّم أنّ الغطرسة تعني السقوط، هي رسائل خالدة. ربما كانت سيغريد أوندست، الحائزة على جائزة نوبل عام 1927، على حقّ عندما كتبت أن “معتقدات الناس تتغيَّر، وأنّهم يفكِّرون بشكلٍ مختلفٍ في أشياء كثيرة. لكنّ قلوبَ الناس لا تتغيَّر على الإطلاق مع مرور الزمن”. انزع الغطاء الثقافي الزاهي، والقواعد والأعراف الخارجيّة، والتكنولوجيا والشكل المجتمعيّ، فسوف تكتشف أنه مهما بدا أننا مختلفون، فإنّنا في النهاية مدفوعون بالدوافع نفسها. لقد تمكّن البشر من فهم بعضهم البعض بشكلٍ جيدٍ عبر الزمان والمكان، كما أنه من الممكن أن تفهم تماماً الأشخاص الذين يختلفون عنك كليّاً. الشيء الوحيد المطلوب هو الصبر والفطرة السليمة والقدرة على الاستماع.
عندما نتأمَّل في معنى الحياة وما هي الحياة الكريمة، يبدو الأمر كما لو كنا معاصرين لجميع البشر الذين عاشوا قبلنا. نطرح الأسئلة ذاتها مراراً وتكراراً، وهناك قواسم مشتركة كثيرة في إجاباتنا. لم يعتقد أي شخص عاقل أن معنى الحياة يكمن في امتلاك أكبر قدرٍ ممكنٍ من الأشياء. رأيت في ستوكهولم قميصاً كُتب عليه: “من يمُتْ وفي حوزته أكبر عددٍ من الأشياء فقد فاز”. لم أشترِه لأنه عندئذٍ سيكون لدي قميصٌ آخر لست بحاجةٍ إليه. كان لدي بالفعل قميص عليه صورة زجاجة بيرةٍ فوَّارة كتب عليها: “إنها دائماً الساعة الخامسة في مكانٍ ما في العالم”.
من غير المؤكَّد أنَّ السعيَ الدائم لتحقيق المزيد من الإنجازات، دون الشعور بالرضا أو الاستمتاع بالحياة هو الطريق الصحيح. قد يكون معنى الحياة في الاستمتاع بما لا يؤدّي إلى أيِّ شيء محدَّد. وهذا ما أشار إليه زابفه بالأفعال التلقائيّة، على عكس الأفعال غير المتجانسة، التي لها هدفٌ خارج نفسها. بالنسبة للبعض منا، لا شيء يضاهي الشعور بالاستلقاء في الأرجوحة أثناء قراءة روايةٍ ملحميّة، أو الصيد دون الاهتمام بنتيجة الصيد. قد يقول البعض معترضاً: ما الفائدة المرتجاة من نشاطٍ بلا هدف؟ في ترينيداد، تمَّ الارتقاء بفنِّ الخمول الإبداعيّ بطريقةٍ أسلوبيةٍ وأنيقةٍ إلى مستوى فنّ المعيشة المتقدّم. يُسمى هذا النشاط بالتجيير. لقد أنتجت هذه العلامة التجارية الكاريبية الخاصة بالخمول الإبداعيّ الكثير من الفكاهة والموسيقى الرائعة، وبعض الشعر الجيّد، لأنه فقط عندما لا يحدث شيء محدّد يمكن أن يحدث أيُّ شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بيتر فيسل زابفه (1899-1990): فيلسوف نرويجي متشائم ومُتسلق جبال. اشتهر برؤيته المتشائمة للوجود الإنساني، والتي تأثرت بأفكار الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور. تُعتبر أعماله الفلسفية، مثل “المسيح الأخير” (1933) و “عن المأساوي” (1941)، من أهم الأعمال الفلسفية في النرويج. ركزت فلسفة زابفه على مفارقة الوجود البشري. جادل بأن رغباتنا وتطلعاتنا لا يمكن إشباعها أبداً، مما يؤدي إلى شعور دائم بالمعاناة. دعا زابفه إلى الوعي التام بعبثية الوجود كوسيلة للتعامل مع المعاناة. على الرغم من تشاؤمه، فقد آمن بأهمية العيش والأصالة والبحث عن المعنى في الحياة، حتى لو كان ذلك معنىً مؤقتاً. المترجم
*موقع أوكسجين

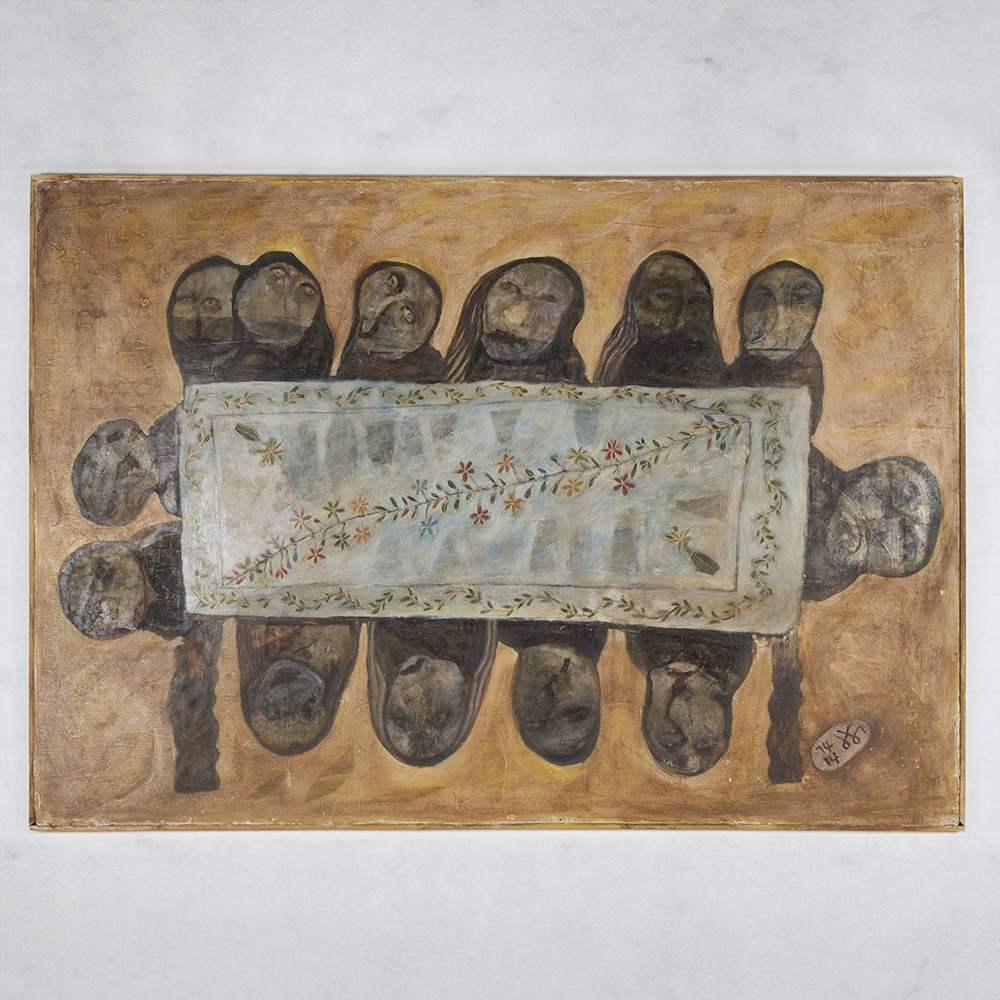


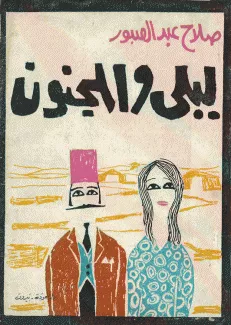
Leave a Reply