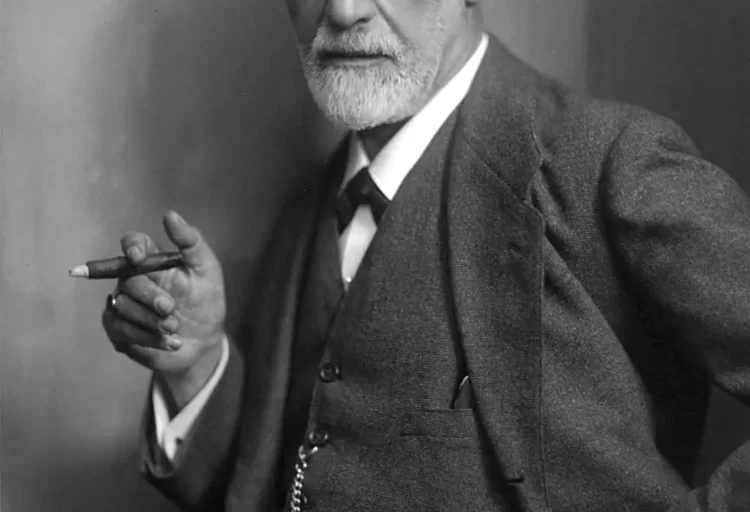ترجمة عارف حمزة
للأسف لا يحبّ القرّاء في ألمانيا القصة القصيرة، وفي تفضيلاتهم القرائيّة صارت تأتي بعد الرواية القصيرة (النوفيلا)، وحتى بعد الشعر؛ إذ يجدون أن القصة القصيرة لا تصلح كقراءة هروبية (عند ذهاب المرء للراحة في عطلة من العمل ومن الضغوط، المترجم) على الشاطئ لأنها قصيرة جدًا، ولا تصلح كأدب جاد يستحضر “روح العالم”، فهي عديمة الأهمية، وبالطبع لا يُنظر إليها كعمل فنيّ يسمو على الواقع، لأنها بسيطة جدًا. إنهم يتمسّكون بقول كورماك مكارثي (1) الذي زعم أّنه لا يستحق الكتابة إلا ما يُكلّفكَ، على الأقل، سنتين من حياتك، ويدفعك إلى حافة الانتحار.
لكن يبدو أنه ليس القرّاء (والناشرون) وحدهم مَن يتحفّظون على الشكل القصير للكتابة، فالكتّاب كذلك يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع إلى سوق النشر، والابتعاد عن الأشكال القصيرة في الكتابة، خاصة عندما يكونون في بداية مسيرتهم الأدبيّة. فمَن يُريد أن يجد موطئ قدم له في عالم الأدب، فمن الأفضل له أن يحتفظ بفكرة رواية واحدة، على الأقل، في درج مكتبه. مع أنه، لأسباب عملية، تشترط أغلب المسابقات والمجلات الأدبية الألمانية تقديم نصوص قصيرة ضمن شروط المشاركة.
لكن مَن يفوز بجائزة “أوبن مايك” (أو الميكرفون المفتوح)- (2) وغيرها، عادة ما يختفي عن الساحة الأدبية لعام أو عامين، ليعود بعد ذلك، لكي يثبت موهبته الأدبية، مزوّدًا بعقد نشر، ولكن من أجل نشر روايته الأولى. وربما تظهر قصته تلك، الفائزة في المسابقة الماضية، كفصل في تلك الرواية، أو تختفي تمامًا في أنطولوجيا الجائزة.
يختلف الأمر تقليديًا في أميركا، حيث تحظى “القصة القصيرة الأميركيّة” بمكانة أعلى بكثير، بسبب سهولة تناولها السرديّ. وفي هذا التقليد – الذي أسسه كتّاب “الجيل الضائع” مثل إرنست همنغواي (1899 – 1961) وفرنسيس سكوت فيتزجيرالد (1896 – 1940)، وتابعه لاحقًا دونالد بارتِلم (1931 – 1989)، وأليس مونرو (1931 – 2024)، وأخيرًا جورج سوندرز (1958) – تُعد القصة القصيرة تصويرًا مجزّأً للواقع؛ بحثًا عن المشترك الإنساني في جذور الذاتية الراديكالية للتجربة الأميركية.
الذاتي الراديكالي (3)
تستمد القصة القصيرة قوتها من كثافة وتراكب خيوط السرد المستمدة من الحياة اليومية الأميركية، حيث تقدّم الذاتية المتطرفة بدون أن تكون مغلقة أو عصية على الفهم – إذ إن الوضوح وإمكانية التماهي يظلّان متاحَين دائمًا عبر الواقعية الأدبية.
يتجلّى هذا بوضوح خاصة في قصص جورج سوندرز، التي نُشرت مؤخرًا بالألمانية عن دار “لوخترهاند” تحت عنوان “يوم التحرير”. إذ تعكس هذه القصص تعدد الأصوات بشكل استثنائي؛ فهي تحتوي على “الجموع” التي تحدّث عنها والت ويتمان (1819 – 1892)، في ذات الوقت الذي تضمّ فيه تشوّهات لغة الدردشة الحديثة.
وتُثبت هذه القصص، كذلك، أن مكارثي كان مخطئًا في تقليله من شأن القصة القصيرة، إذ يتّضح جليًا أن الجهد والدقّة المبذولين في كتابتها لا يقلّان عنهما عند العمل على كتابة رواية. وفي الحقيقة، فإن التكثيف الشديد الذي تتطلبه القصة القصيرة يمثّل تحدّيًا أدبيًا حقيقيًا، أكثر منه شكلًا تافهًا أو بسيطًا.
ومن جهة أخرى، فإن المشهد الأدبي الأميركي، بما فيه من مؤسسات مثل Iowa Writers Workshop والذي يعكس الطابع الحِرفي، غير المرتبط بالعبقرية الفردية، للكتابة من خلال اسمه نفسه، ومجلات مثل Granta وThe New Yorker وOne Story، يُجسّد هذا الانفتاح تجاه القصص القصيرة القصيرة ذات الطابع السردي الأطول.
فالنشر في “ذا نيويوركر” لا يعني أنّكَ الآن “جاهز، كعمل تال، لكتابة رواية أميركية عظيمة”، بل يعني: “هذه القصة القصيرة جيدة بما يكفي لتقف بذاتها؛ هذا القطعة تمثّل نصًا أدبيًا في مكانٍ ولحظة زمنية معينة، وهي، رغم ذاتيتها المطلقة، تسعى نحو فهم إنساني شامل، لما يشعر به المرء كأميركي في تلك اللحظة الزمنيّة، بمعنى: هنا والآن”.
صناعة الخطاب خارج المؤسسة الأدبية
تُظهر القصص القصيرة، على وجه الخصوص، مرارًا وتكرارًا، أنها تمتلك القدرة، حتى في زمننا الحاضر، على تشكيل الخطاب العام خارج حدود المؤسسة الأدبية التقليدية. فعندما نُشرت قصة “مُطارد القطة” لكريستين روبنيان (1982) في مجلة “ذا نيويوركر”، في عام 2017، وانتشرت عالميًا بين ليلة وضحاها، كانت تلك لحظة فارقة في الأدب؛ إذ أحدثت القصة فجوة في البنية الذكورية للمجتمع الذي يغلب عليه طابعه التمييزي ضد النساء. لقد كانت قصة قصيرة كلاسيكية البناء، لكنها أصبحت نصًا محوريًا في حركة “مي تو” رغم أن النصوص الأساسية لهذه الحركة غالبًا ما تنتمي إلى أجناس أدبية غير خيالية، أو هجينة على الأقل.
وعندما أصدر جورج سوندرز، في عام 2013، مجموعته القصصية “العاشر من ديسمبر (كانون الأول)” أحدث ذلك ضجّة يمكن مقارنتها، في زمن ما بعد كورونا، بإطلاق مسلسل تلفزيوني جديد.
ومؤخرًا، شهدنا حالة مشابهة جزئيًا مع زاك ويليامز (1978)، الذي نالت مجموعته القصصية “ستأتي أيام جميلة” استحسان النقاد والقراء، بل وحتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. أثبت هذا العمل مدى التأثير الذي يمكن أن يُحدثه الأدب على روح العصر، وذلك عندما تتحلّى دور النشر بالشجاعة، وتمنح الفرصة إلى كتّاب غير معروفين لتقديم ظهورهم الأول من خلال قصص قصيرة متقنة. رغم قصرها الشديد، تُشكّل هذه القصص شظايا تتّحد لتكوّن صورة مكتملة ومؤثرة لأميركا.
وإذا تذكرنا أي آداب محلية (في ألمانيا) كانت قادرة على إحداث تأثير مماثل انطلاقًا من ذاتها، وليس بسبب دعاية إعلامية مسبقة، بل قادرة على تأسيس خطاب جديد، فإننا نعود مجددًا — وبشكل لا مفر منه — إلى القصة القصيرة.
لا بد لنا من العودة عشرين سنة إلى الوراء، إلى أدب يوديت هيرمان (كاتبة وسيناريست ألمانية ولدت في عام 1970) وظاهرة “معجزة الآنسة”، فقد شكّلت لغتها، وبداياتها المفاجئة، على طريقة رايموند كارفر (كاتب أميركي، 1938 – 1988) في مجموعته “بيت الصيف، لاحقًا”، محطة أثارت التساؤل حول الأشكال التقليدية للكتابة النسائية، وأثّرت في جيلٍ كامل على مستوى الأسلوب واللغة، بل وأثارت موجات تجاوزت حدود المؤسسة الأدبية نفسها.
شكلان من القصة القصيرة الألمانية المعاصرة
إذا ألقينا نظرة اليوم على القصة القصيرة في البلدان الناطقة بالألمانية، نجد أنها قد تبلورت، على نحو ما، في شكلين مختلفين. الشكل الأول، وهو الأقصر والأكثر تجريبًا لغويًا، يحاول مقاربة الواقع من خلال بنيته الخارجية. ولا يعتمد على التقاليد السردية المعروفة، بل يركّز بالكامل على الخصوصيات الأسلوبية والانغلاق الذاتي.
هذه القصص لا تستسلم أمام سطوة الكلمات، لكنها لا تحاول مواجهة فوضى ما بعد الحداثة عبر التنظيم أو التوضيح، بل تعمل كأنشودة، لعدم قابلية اللحظة الراهنة على الفهم. ويُجسّد هذا النوع من الكتابة، خاصةً في مسابقة أوبن مايك، وكذلك في مجلات مثل “إديت” و”بيلا تريستي”، الصوت الأول للعديد من الكتّاب الشباب، الذين يشقّون طريقهم نحو المشهد الأدبي.
لكن النوع الآخر من القصة القصيرة، الأطول والأسهل بالنسبة للقارئ، يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد. فإلى جانب جائزة فالتر زيرنر المرموقة، ظهرت مؤخرًا جائزة جديدة تُدعى بوكاسيو. سي. سي والتي تقدم بدعمٍ من مجلة “فول تكست” وتتمتّع بجائزة مالية أكبر (10 آلاف يورو. ونالتها في العام الماضي الكاتبة الألمانية من أصول أوكرانية ناتشا فودين، المترجم).
وفي مسابقة أوبن مايك نفسها، فاز في العام الماضي نص “وليمة البركة” لإيسر أكتاي (1992)، والذي كان عمليًا النص الوحيد الذي اتبع بنية درامية تقليدية. وقد اقترب بأسلوبه متعدد الطبقات، من خلال تعدد الأصوات، من أسلوب جورج سوندرز، بدون أن يغفل الهدف الأساسي؛ وهو رواية قصة ترتبط بزمننا الراهن.
قصص قصيرة منشورة بشكل متسلسل
منذ عام 2021 تصدر مجلة “داس جرام”، وهي مجلة أدبية تُكرّس نفسها بوضوح لهذا الشكل الأدبي المُهمَل، والمتعامل معه بتجاهل، على غرار مجلة “ون ستوري” الأميركية. تنشر المجلة قصة قصيرة واحدة فقط كل شهرين، كعمل مستقل قائم بذاته. ويُولي الناشر باتريك زيليمان — الذي يعمل أيضًا محررًا في دار النشر “كاين أوند أبير” ويعرف كلا جانبي المشهد الأدبي — أهمية كبيرة لهذا التقدير للشكل القصير.
فرغم أن “داس جرام” تُثبت أن القصص القصيرة، خلافًا لسمعتها المشكوك فيها، يمكنها أن تجد جمهورًا قارئًا في الدول الناطقة بالألمانية، إلا أنها، كما يقول زيليمان، لا تزال تواجه صعوبة حين تُنشر في شكل كتاب.
لكن في عالمٍ باتت فيه السرديات الكبرى للتاريخ السياسي المعاصر تُشبه فعلًا الخيال، بل وتتّخذ باستمرار منعطفات مهدّدة ومفاجئة، يبدو السرد الواقعي المجزأ أكثر ملاءمة لزمننا من أي وقت مضى. لأنه عندما تُكتب القصص القصيرة بشكل جيّد، فإنها تُجسّد ما وصفته سوزان سونتاغ (كاتبة وناقدة ومخرجة أميركية، 1933 – 2004) بـ”إيروتيكيّة الفن”، وتُلغي الحاجة إلى هرمنيوطيقا تفسيرية تشبه الدروس المدرسية.
عندها تحمل القصص القصيرة أسرارها على سطحها، ويختفي الطابع الذاتي للحكاية خلف شعور كوني بالوجود الإنساني، لأن هذه الأسرار التي تبوح بها، هي في الأصل أسرارنا نحن، تلك التي تجاهلناها طويلًا، وها هي الآن تحدّق فينا بكل عريها الذي لا يُطاق.
(*) هذه المقالة نشرها الكاتب الألماني يانيك فالتر في صحيفة “تاتس” الألمانية بتاريخ 30/3/2025، تحت نفس العنوان.
هوامش:
(1) كورماك مكارثي (1933 – 2023): قاص وروائي ومسرحي وسيناريست سينمائي أميركي.
(2) Open Mike أو جائزة الميكروفون المفتوح: هي جائزة دولية باللغة الألمانية، وتعتبر، إلى جانب جائزة كلاجين فورتر إنجبورج باخمان، المسابقة الأهم لاكتشاف أصوات جديدة باللغة الألمانية.
(3) الذاتي الراديكالي أو الذاتية المتطرفة يُقصد بها التركيز العميق على التجربة الشخصية والفردية بشكل مكثّف، بحيث تصبح وجهة نظر الفرد وعواطفه ومشاعره مركزًا للرؤية والسرد، حتى ولو على حساب الموضوعية أو الشأن العام.