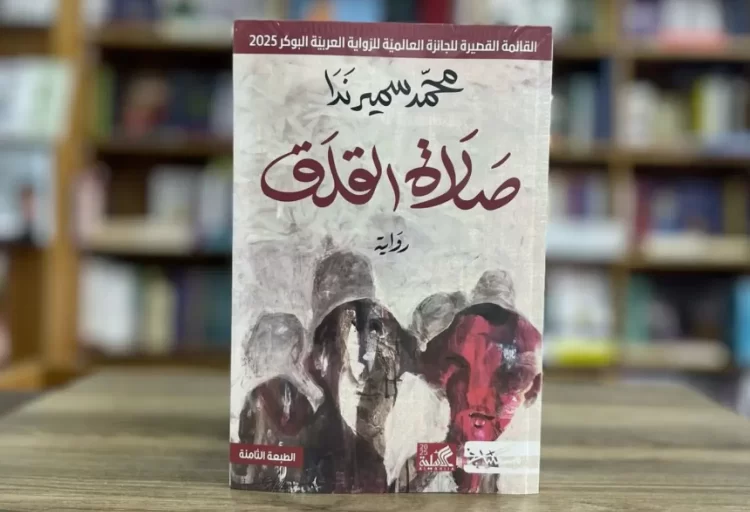كان ربيعي الحادي عشر يدثر جسدي النحيل، عندما التقيتها أول مرة.. قطة صغيرة بلون الزيتون، تتبعتْ خطواتي بتردد
يُشبه تحليق فراشة خائفة، تحاذر السيارات المندفعة كوحوش، تتوقف عند حافة الرصيف، ثم تلحق بي مهرولةً كأنّما
تخشى أن أغيب عن نظرها..!
لا أعرف لماذا اختارتني..؟ لكنها انتظرت عند باب المنزل حتى فتحته، ثم دخلت تجرجر أقدامها على استحياءٍ.
منحتها اسم “زيتونة”، شاركتني فراشي، لعبت مع أوراقي المبعثرة، بل رافقتني إلى الحمام. كنت أشمُّ رائحة التراب في
فرائها كلما اقتربت.. رائحة تذكّرني بجذور قديمة لم أعرفها.
ذات ظهيرة ماطرة، عدتُ من المدرسة، فركضت نحوي، سمعتُ صرير فرامل كصرخة طائرٍ مذعورٍ، ثم هبط صمت
ثقيل.
وجدتُ جسدها الصغير مسحوقاً وسط بركة دم، حملتُها كقطعة قماش ممزقة، ودفنتُها تحت شجرة الصنوبر التي كانت
تُحب تسلُّقها.
لم تكن دموعي تخصها وحدها.. بل كانت جنازة لبراءة سُحِقت تحت عجلات العالم.
كبرتُ، وابتسمت الحياة في وجهي بسخريةٍ قاسية. قادتني خطاي التائهة إلى بلادٍ بعيدة، داخل ورشة بناء، حيث الإسمنت
والحديد، والغرباء الذين يطحنهم الوقت.
في ذلك المكان، لمحتُ عيونًا تشبه مجرتين غارقتين في الظلام.. قطة مشردة، تسرق فتات الطعام، تحدّق بي كأنها تفهم
أكثر مما تقول.
قاسمتها رغيف خبزي اليابس، فراحتْ تجلس بجانبي كظلٍّ صامت، تراقب يداي المتشققتين وكأنها تفك شفرة الألم.
ذات ظهيرة، اشتد الجوع بنا.. لم أملك إلا نظرة الاعتذار. غادرتْ مسرعةً، ثم عادت تجر كيس قمامة بأسنانها. فتحتُه..
فخذ دجاج نصف مأكول. وضعتُه أمامها، لكنها دفعتْهُ بأنفها نحوي، ثم جلستْ في سكون، كأمٍّ تحاول إقناع طفلها الجائع
بتناول الطعام قبلها.
عندما نظرتُ إليها، شعرتُ أنها تهمس: “كُل.. أنا أعرف أنك أضعف مني الآن”
انتقلتُ إلى مدينة أخرى، أركض خلف الرزق كشبحٍ في متاهة.
في مساءٍ عاصف، سمعتُ خربشة على الباب.. صوت يشبه حفيف أجنحة.
فتحتُه.. فإذا قطة بيضاء كالثلج ترتعش كورقة خريف مبلولة.
حملتها إلى الداخل، غسلتُها بماء دافئ، كأنني أعيد لها دفء الشمس المسلوب. لففتها بمعطفي القديم، وراقبتُها وهي تنام
كرضيع وجد مهدَه أخيرًا.
انظر نحوها، يلوح ظل زيتونة في عينيها كضوءٍ يتسلل من ثقبٍ في الذاكرة، لم أؤمن بالمصادفات يوماً، ولن أفعل، لكنها
رسائل صامتة من عالمٍ آخر، عالم لا تدركه حواسنا..!
الآن، تجلس قبالتي، تراقبني، بينما أكتبُ عن طفلٍ وجد أن الحب حتى لوجاء متنكّراً بفراءٍ وذيل، هو الذي يمنع الوحشة
من سحقنا تحت عجلات العالم المفبرك اصطناعياً..!
خليل شواقفة: قراءة في نص الأديب فراس الحسين “ساعي بريد”
مقدمة وحالة استثنائية:
حينما نحاول كَتمَ أنفاسنا أمام مشهدٍ غير مألوف، يروق لنا ذلك، فنُسرعُ إلى تتبُّعه بلا انتباهٍ واعٍ، مُستعدِّينَ لتلقِّي أي
ملاحظةٍ أو رسالةٍ تأتينا من عالم الغيب. عندها ننتفضُ ونهرولُ لاستحضار تلك الطاقة المتبقية من مخزوننا الذهني،
ساعيِنَ إلى الولوجِ إلى عالمٍ يفتقرُ إلى الموضوعية، حيث يقفُ العقلُ عاجزًا عن التحليل الذي يجدرُ بنا فهمُه أو محاولةُ
إدراكه بالآليات المألوفة في خضمِّ حياتنا اليومية.
إن الأمرَ يخرقُ المقاييسَ المعرفيةَ المُعتادة؛ تلك التي نبنيها في حركة حياتنا الدنيوية. لكن الغرابةَ لا تتوقفُ هنا، فثمة
رسائلُ مبهمةٌ تتدفقُ من عوالمَ لا نعرفها إلا لحظةَ ولوجِها إلى الوجد. وعليه، فإن قصورنا عن احتواء هذه الرسائل لا
يعودُ إلى عجزِ العقلِ عن الإدراك، بل إلى غرابةِ المنظور الذي تأتينا به، مُحمَّلًا بمشاهداتٍ حِسِّيَّةٍ وتدفُّقاتٍ وجدانيةٍ لم نُعدَّ
أنفسنا لتلقِّيها.
هنا، يصبحُ تقبُّلُ هذه الرسائلِ واجبًا يفرضُه الإحساسُ لا العقلُ، مع أن الأخيرَ هو مَدارُ التكليفِ الشرعيِّ والفكري. لكننا
مع ذلك نحاولُ فكَّ الرموزِ، مستندينَ إلى مدى جاهزيتنا لتقبُّلِ تلك الرسائل، التي تُقاسُ بقيمةِ الإنسانِ الحقيقيةِ في وجداننا.
والحقُّ أن كاتبنا المبدعَ لم يتوانَ عن إرسال هذه الرسائل إلينا، كي نعيشَ معه في فكِّ ألغازِ النص، ونتفاعلَ معها
لاستدراك ما تبقَّى من إنسانيتنا، فنتقبَّلَها كوحيٍ من عالم الغيب، يحكي قصةَ الخيرِ المطلق في دروب الحياة، ويُحيي ذلك
النبضَ الكامنَ في قلوبنا الجريحة؛ نبضَ الإيمانِ بقيمةِ خَلقِ الله المطلقة.