في أحد أكثر المشاهد عبثية وتناقضاً، عادت ميرا جلال ثابت إلى الظهور، بعد اختفائها الغامض. لكنها لم تعد كما غابت. لم تكن صور عودتها سوى مرآة سوسيولوجية لوجه سوريا كلها، والباحث/القارئ للقضايا المجتمعية “شديدة الحرارة” سيتجاوز قليلاً الحقائق، لا لأنها غير مهمة، بل لأن دلالات الحالة ككل تتجاوز إن كانت ميرا خُطفت وسُبيت، أم تزوجت برضاها. فالصورة التي بألف كلمة، قالت الكثير، كما لو أنها مثال يُدرَّس.
ذهبت ميرا فتاة بوجه مكشوف، وشعر منسدل، شديد الكثافة، أسود الوضوح، حاضر المعنى، وعادت بجسد مغطى بالكامل، مذكِّرًا ــ وبإصرار ــ باللباس الأفغاني قاسي الوقع على الروح والذاكرة السورية. بملامح مطفأة، وراء نقاب تام، يمسك بمعصمها رجل، ومحاطة بذكور لا يبتسمون، بدت ميرا كما لو أنها خارجة من كهف نسيه الله لألف عام، آتية من عمق موغل في القبلية، لا من بيت زوجي لشاب أصرت على الهرب معه بدافع الحب.
عندما بُلّغ عن اختفاء ميرا، كانت مجرد طالبة في معهد تعليمي يقع في قلب مدينة لطالما تفاخرنا ــ لا بفولكلورية بل بأصالة وصدق ــ بتنوع سكانها ومشاربهم، بنبيذهم، بجوامعهم وكنائسهم: حمص، مدينتنا، طرية الأرض، لينة المتحد. ثم هكذا، وبحسب أهلها، خُطفت ميرا. أتت القصة كصفعة هائلة للحلم السوري. ميرا التي كان يُفترض أن تنعم بالأمان والحرية، تحوّلت إلى مرآة لخيبة جماعية، وإلى تجسيد حيّ للخذلان، وللتماحك والاصطراع أيضًا، خصوصاً في الأوساط التي حملت عبء الثورة لعقد ونصف، وعلّقت آمالها على ولادة وطن لا يخذل أبناءه، وبالأخص بناته.
من اسمها وحده، بدت أسطورة ميرا القديمة وكأنها تعود أكثر حداثةً وتجدداً. وهكذا هي الحكايات، تكبر بعيداً من جذورها.
في الميثولوجيا، كانت ميرا ــ أو سميرنا ــ أميرة فائقة الجمال، وقعت ضحية لعنة الآلهة، فاشتعلت فيها رغبة محرّمة تجاه والدها. وبمساعدة خادمتها، دخلت سريره ليلًا، فجامَعها من دون أن يعرف مَن تكون. ولما انكشفت الحقيقة، همّ بقتلها، فهربت إلى الغابة، تطاردها لعنتها وعارها، وتوسلت إلى الآلهة أن تنقذها. فاستُجيبت دعواتها، وتحولت إلى شجرة مرّ. في جسدها النباتي الجديد، توقفت الحياة البشرية، لكن الرحم ظل مفتوحًا. وبعد تسعة أشهر، انشقّ اللحاء، وولد منه طفل شديد الجمال هو أدونيس، الذي صار رمزاً لانبعاث الحياة من رحم الموت.
ورغم كآبة الأسطورة، إلا أن الحكاية تنتهي بولادة الجمال، حتى لو انبثق من الخجل والعار. تنتصر الأسطورة للحياة حتى لو نبتت من جرح، كما لو أن الكون أراد ترتيب توازنه من قلب التضاد. لتهطل حبات المرّ دموعاً للندم، وتحترق بخوراً لطرد الخطايا، ولغسل العار.
حاملةً عبء حكاياتنا، قديمها وحديثها، تبدو سوريا اليوم مقطوعة الأنفاس، تلهث من تعب الماضي، ومن ثقل التركة البذيئة التي لا تعلم كيف تُصرفها. تبدو سوريا اليوم مخنوقة من رماد الحرائق، وصمّاء من شدة الصراخ. البلاد لم تفتح رئاتها بَعد على أنفاس الخلاص، وما زالت تترنّح، مطعونة بألف غادر، مضروبة على رأسها بركام الماضي، حالمة، ساذجة، ومغرَّراً بها.
ما تعيشه بلادنا اليوم هو انهيار في المنطق الجمعي، ارتباك مضطرد، غير منفصل عن تهاوٍ لبنية السلطة ذاتها. فمنذ عقود، لم تُبنَ العلاقة بين الحاكم والمحكوم على تعاقد عقلاني، بل على رمزية أبوية، قدرية، أبدية. لم يكن الرئيس موظفاً في خدمة حكومته وشعبه، بل كل ما في البلد هو في خدمة ذاك الحاكم، الذي إن مسّه مكروه، أُعلن النفير، وبدأت حفلة الجنون الجماعي عن اللعنات التي ستحل بالبلاد والعباد إن خُدش للمنقذ هواء، أو مُسّت لأقداره نجمة، أو سقط له شهاب. وهكذا، كلما تراجعت المؤسسات، تزايدت الشخصنة، وتحول النظام السياسي إلى طقس نفسي وثقافي، لا إلى منظومة دستورية. فالحقيقة أن شيئًا جوهريًا لم يتغير في روحية تعاملنا مع السلطة ورأسها الحاكم. إذ، رغم اختلافها الظاهري عن نام الأسد، فالثقة التي وُضعت في الإدارة الجديدة، مُنحت بتزكية القلب، وبالحب… “بالحب بدنا نعمرها”. بُنيت على أمل عاطفي، على استبطان جمعي، وتبنٍّ مطلق لفكرة “الرجل المنقذ”، وهو مَنطق يشبه ما ورثه السوريون من الطاعة المغلَّفة بالحب للقائد الحامي.
إن إقبال شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً السنّة الذين كانوا بغالبيتهم عماد الثورة ومقدّمي قرابينها الأكثر تضررًا، على تصديق الرواية الرسمية عن هروب ميرا، لا ينمّ، في جوهره وبُعده العميق، عن عدم تعاطف، أو هُزءٍ أخلاقي، أو حتى شماتة بميرا. بل من إدراكهم اللاواعي أن تصديق اختطافها، و”سَبيها”، وإعادتها، وإرهابها وأهلها، يعني القبول بأن آليات العنف القديمة ما زالت تعمل تحت جِلد الدولة الجديدة. يعني الاعتراف بأن تلك الغالبية قاتلت لأكثر من عقد من أجل نظام جديد، فإذا به يُعيد إنتاج الرعب، والكبت، والعنف، والإخفاء، والإهانة، باسم الأمن والاستقرار، وباسم الوطن الجديد. لهذا بدا أن كل ما يُهدّد هذه الصورة ــ كقضية ميرا ــ يُقابل بالرفض والتشكيك العنيفين، لا لضعف في الحجة، بل لخوف عميق من انهيار المعنى أيضاً.
وكتتمة لحكايات خجلنا اليومية، ومن هذا الخوف نفسه، جاءت ردود الأفعال “المشككة” في إخلاء طلاب المدن الجامعية من أبناء السويداء. فرغم أن مئات الطلاب من الطائفة الدرزية غادروا مساكنهم الجامعية تحت وطأة التهديدات وغياب الأمان، لم يتوانَ بعض الأصوات عن اتهامهم بتنفيذ “أوامر القيادة الدرزية”. وبدلًا من أن تُشكّل المأساة لحظة تضامن جماعي، تحوّلت ــ ويا للفجيعة ــ إلى فرصة لإعادة إنتاج الخطاب الطائفي، بعدما فضّل أبناء الثورة استمرار “نقاء” الحلم على الاعتراف بالخذلان. كأن الحفاظ على شرعية الثورة الجديدة يتطلّب التستّر على كل ما يعاكس صورتها المأمولة، حتى لو عنى ذلك التضحية بالحقيقة، أو بفتاة مكسورة، أو بطلاب خائفين.
*المدن



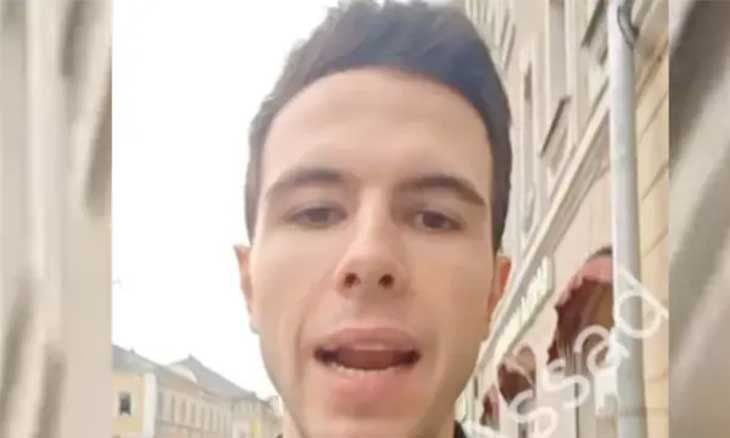

Leave a Reply