حوار: ميشيل سيروب
الروائي عزيز تبسي مسكون بأفراح وأوجاع مدينته الأثيرة، وهذه ليست الرواية الأولى التي يتناول فيها أواصر الصداقة والمحبة بين أحياء حلب وسكانها، وأيضاً صراعاتهم واختلافاتهم المذهبية ومصالحهم المشتركة في التجارة والورشات الحرفية. فجاءت روايته الجديدة عملا جديرا بالاهتمام إذ تُلقي الضوء على ماضي المدينة وسكانها منذ قرنين من الزمن، فهل تلامس الرواية حاضرنا الذي تتراكم فيه الخيبات والصراعات الهامشية؟
– كتبَ نجيب محفوظ عن القاهرة بشغف، كما كتب إبراهيم الكوني عن الصحراء بحب وشوق كبيرين، وأجدكَ اليوم تكتب عن حلب مرة أخرى، إلى أية درجة أنت مسكونٌ بحلب، وما سر العلاقة العاطفية التي تجمعك بهذه المدينة العريقة، هل هي شغفك الأوحد؟
* أهتم منذ زمن بالمدينة العربية وتحولاتها، بكونها حصيلة تراكم عرقي وثقافي واسع وعميق، الحضور الفاعل للمدينة بصفتها مدونة تاريخية مفتوحة على تأويلات متعددة وغنية، وحلب مدينة عريقة، من أقدم المدن المأهولة على الكوكب، يظهر هذا في تعدد أنماط العمارة والتحصينات العسكرية والمساجد والأسواق والخانات والحمامات، نقرأ في كل منها العصر الذي تنتمي إليه من فترة الحكم العثماني رجوعاً إلى المماليك والأيّوبيين.. الخ.
صروح شامخة أمامنا وتدعونا لاستنطاقها والحوار معها، هذا غير القلعة الرابضة كشاهد تاريخي لايزول. جلبت هذه المراحل الشعوب المختلفة العرب هم الأساس التكويني للسكان على مستويي اللغة والثقافة على الأقل، وتحضر الشعوب الأخرى الشركس والأكراد والأرمن والتركمان، انعكس هذا كله في التقاليد العمومية والأغاني وأنماط الطعام والمنسوجات.. كثيرة هي المدن في بلاد الشام التي تحمل هذا الإرث، وقد تحول أغلبها بفعل عوامل متعددة، أهمها الاجتياحات العسكرية المدمرة، إلى بلدات هامشية كبلدة “قنسرين” على سبيل المثال، وإلى متاحف في العراء كأفاميا وبصرى وتدمر.. شروط عديدة كانت وراء وصول مدينة حلب الى مكانتها، لتوسطها الطريق بين اسكندرونة على شاطئ البحر المتوسط وبالس-مسكنة على ضفاف نهر الفرات، على طريق التجارة البعيدة. حلب مدينة المجازفة، فهي أمام خيار وجودي دائم لكونها بلا مصدر مائي.
شكل هذا كله خلفية لاهتمامي، لكن اهتمامي الأساسي بالناس وكفاحهم اليومي من أجل الحفاظ على حياتهم الكريمة، ومواجهة التحديات والتكيف مع المستجدات والطوارئ، رغم مركزية مدينة حلب إلى أطرافها، إلا أنها مدينة طرفية بالنسبة لإسطنبول في مرحلة الحكم العثماني والقاهرة في مرحلة المملوكي. أحلام أهلها بالعدالة والمساواة والكرامة كان وراء انتفاضتهم 1819-1820 وهم من سيصابون بالصدمة يوم فرار حاميتهم العسكرية وباشاواتهم أمام تقدم جيش إبراهيم باشا 1831، وسيصابون بجرح عميق بعد تحول انتفاضتهم 1850 إلى اعتداء على المسيحيين وبيوتهم وكنائسهم. المدينة هي مركز إهتمامي، بحثت لسنوات في تاريخها، وشكل هذا أساساً لكتابتي عنها.. وقد يتحول إلى مدينة دمشق، وهي بدورها ذات جاذبية لا يمكن مقاومتها.
– عطفاً على السؤال الأول: كتَبَ رفاق سجنِكَ: آرام كرابيت وراتب شعبو وياسين الحاج صالح عن تجربة السجن، بينما أنت تجنبت الكتابة، لغاية اليوم، عن تلك المحنة الإنسانية، هل من مشاريع مستقبلية للكتابة عن يوميات سجن تدمر (حمص) وسجن المسلمية (حلب) وعدرا (دمشق)؟
* بغض النظر عن السجن، الذي سرق من حياتي ما يزيد عن خمسة عشر عاماً، تبقى الكتابة عنه محصورة بالتجربة الذاتية.. تسلل السجن، الى كل رواياتي، لكنني لم أقرر بعد تخصيص كتابة مستقلة عنه، وهي بالعموم ستكون صعبة بعد كتابات الأصدقاء والكتابات الأخرى، لأن السؤال الذي سأواجهه ليس الكتابة فحسب، بل مدى وعمق ما يمكن إضافته للكتابات الأخرى.
يحتاج السجن الى تأمل يأخذنا إلى ما بعد التجربة الذاتية، مساهمة في فهم هذا النمط القمعي. بت على قناعة بعد ما حصل للشعب السوري، أننا ولجنا عتبة قمعية مهولة، انحدرت إلى قاع الإبادة، والحقيقة أنني أخجل من الكتابة عن تجربتي وتجربة رفاقي أمام ما رأيناه وسمعناه وشهدنا عليه.
-حملتْ ابتسامتها رسالة موجزة عن جمالها ومشاعرها ومزاجها العميق “مريانا الجميلة في الرواية ضوء خافت سُرعان مايتبدد في زحمة الأحداث، لماذا تعمدتَ إنهاء قصة الحُب تلك بهذه العُجالة؟
=كتب دستويفسكي في إحدى تجلياته التأملية”الجمال سينقذ العالم”،الجمال بالكاد ينقذ نفسه،أمام شروط القباحة التي تحاصره.حملت مريانا المعاني العليا للحرية والكرامة،لم يفهمها حبيبها،أو فهمها لكنه عجز عن الإلتزام بها.مريانا ليست ضوءاً خافتاً،بل هي الضوء الذي أضاء الرواية والحياة من خلفها،ووجهها الآخر هي كاترين،أخت المعلم بشير وأمه أسماء…في الحياة كما الرواية هناك قناديل لايتوقف ضياؤها حتى ينتهي زيتها وتجف ذبالتها.
*قال المتنبي وهو ابن حلب أيضاً: كُلَّما رحبتْ بنا الروضُ ….قُلنا حلبٌ مقصدُنا وأنتِ السبيلُ.
هل كانت السلطنة العثمانية تأتمن جانب المسيحيين المقيمين في حلب؟ وهل كان المسيحيون آنذاك، يعيشون” مُرغمين” مع المُسلمين أم أن الصمت، كنوع من التواطىء، كان قاسماً مشتركاً بين الطرفين كما ورد في الرواية؟
=ما الذي يخيف السلطنة العثمانية من جماعة لا سلطوية وغير مسلحة، تعمل لتعيش وتدفع الجزية وعموم الضرائب والجبايات العشوائية.هناك أخطاء تاريخية،تحولت بفعل العطالة النقدية إلى حقائق،ساهم في ترسيخها الإستشراق الإمبريالي،واستكملتها الرجعية المحلية..منها على سبيل المثال أن المسيحيين عاشوا خارج أسوار مدينة حلب،بينما تؤكد الوثائق والسجلات إلى تواجد المسيحيين تاريخياً بعدة أحياء داخل الأسوار،بنسب سكانية عالية،كأحياء الجلوم الصغرى والعقبة وجب أسدالله والمصابن..المسيحيون لايتعايشون،وإنما يعيشون بسلام وتشاركية،ويعملون بجد ومثابرة للنهوض بأحوالهم،وقسم غير قليل منهم اتجه الى تعلم اللغة العربية واللغات الأجنبية..اضطهاد المسيحيين ممارسة سلطوية،لها أثرها على الثقافة الشعبية.
-هل كان على المسيحيين انتظار المصريين لتحريرهم من عسف العثمانيين؟
=لا قرار للمسيحيين ولا المسلمين في بلاد الشام بحملة إبراهيم باشا، حملته دوافعها الطموح لتوسيع سلطته وإمتيازات عائلته والطبقة الاجتماعية التي يمثلها، حمل الرجل ووالده مشروع تحديثي سلطوي، شمل توسيع مساحات الأراضي المزروعة وبناء الجيش والإدارات الحديثة والمصانع، وامتدت الى عناصر حقوقية كإزالة التمييز بين المسلمين والمسيحيين باللباس وغطاء الرأس والمشاركة بالوظائف الحكومية، وبخطاب دعى الى المساواة بالحقوق والواجبات بين الرعايا،مانفذه إبراهيم باشا،سيعكف على تنفيذه الولاة العثمانيون بعد رحيله،وفق إصلاحات السلطان عبد المجيد والسلاطين الذين أعقبوه.
*اليوم الوضع الإقليمي في حلب، وسائر سوريا، يتقاطع مع الأحداث الملحمية للرواية، هل لنا أن نقرأ الرواية على ضوء الصراع الدامي والثورة السورية ومآلاتها؟
=يمكن قراءة بعض فصول الرواية بالتوافق مع أحداث الإنتفاضة الشعبية 2011، ومابعدها. وأود أن أخبرك بان الرواية جاهزة للنشر من عام 2017.

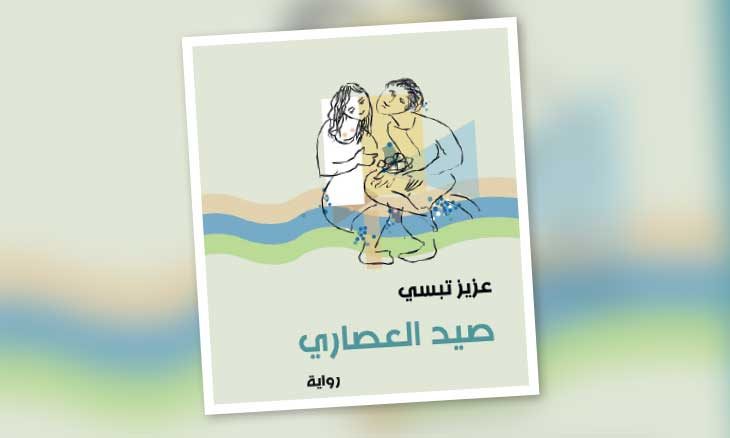


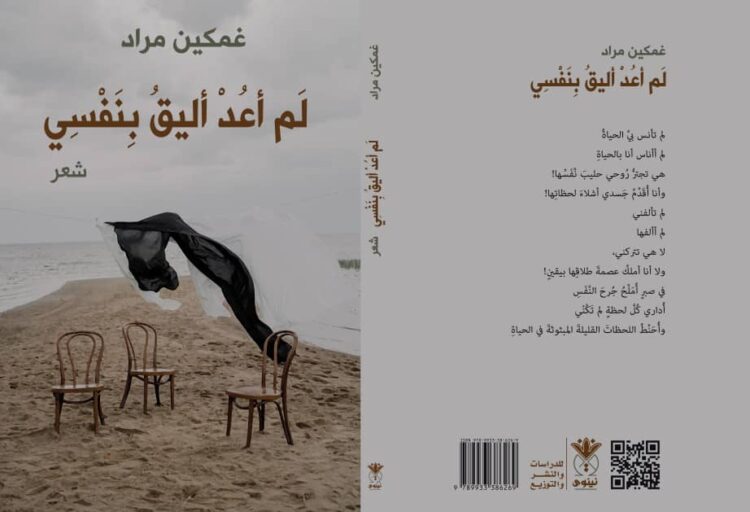
Leave a Reply