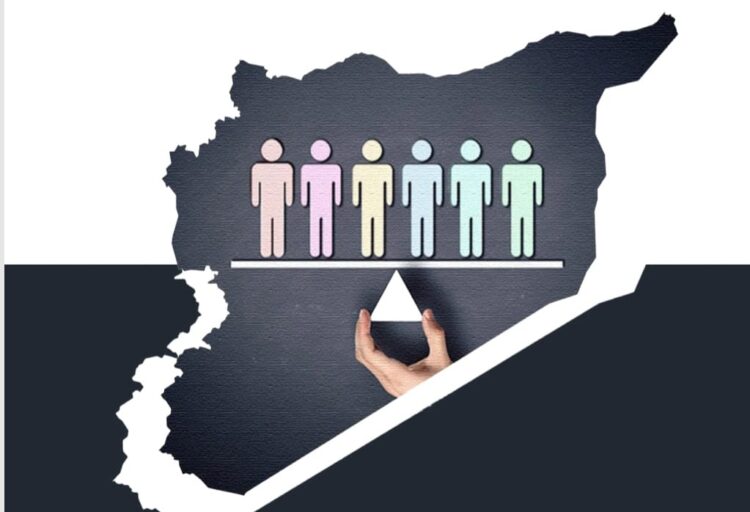إلى ما قبل السادس من آذار/مارس الماضي، كانت أهزوجتنا اليومية الأثيرة عبارة تقول إن الأكثر صعوبة بات وراءنا، وإن المجزرة الموعودة، التي ظل النظام الأسدي البائد يخوّف بها العلويين، ويهدد بها كل الأقليات، بل الكون برمته، قد توارت الآن.
كنا نسخر من تصديق الناس لأكذوبة النظام هذه، تماماً مثلما سخرنا، وغضبنا طوال أكثر من عقد ممن صدّقَ وروّجَ لهتاف مزعوم على أنه رُدّد في تظاهرات السوريين: «مسيحية ع بيروت، وعلوية عالتابوت» (ما زلنا نصرّ على أنه هتاف مزعوم)، فلم يكن هناك أوضح من رغبة السوريين العارمة في حمل الثوار، أو المتضامنين مع الثورة، المتحدّرين من منبت أقلوي على الأكتاف، وقد حدث بالفعل عندما رُفع عارف دليلة ومنتهى الأطرش وآخرون، وعلى أكفّ الراحة. ولم يكن بالإمكان تكذيب عيوننا ومعايشاتنا وتصديق أكاذيبهم.
استحالة الإنكار
لذلك كان التلكؤ في تصديق المجزرة مفهوماً، فلا أحد يريدها، خصوصاً الإدارة السورية الجديدة، التي ضربت المثل ببراغماتيتها في سبيل الحصول على اعتراف دولي، يفضي إلى الإفراج عن أموال ومساعدات تُوسِّع عيش السوريين. وما دام هنالك وعد بالعدالة الانتقالية فلماذا سينغص السوريون المؤمنون بدولتهم الجديدة على أنفسهم احتفالهم بارتكاب مجزرة!
كان التلكؤ مفهوماً أيضاً في ظل طوفان الأكاذيب والأخبار المزيفة. إلى أن جاءت الأخبار من أسماء نعرفها ونثق بمصداقيتها، التي راحت تتحدث عن قرى وأهل وأسماء، ومن بينها المعارضة والمعتقلة السابقة هنادي زحلوط، التي نعت إخوة ثلاثة لها أعدموا ميدانياً، كما جاء في منشور لها على فيسبوك. فهذا صوت موثوق، يحكي قصة شخصية غير منقولة.
وكما يحدث دائمًا في المآسي، ستأتي اللحظة التي يصبح فيها الإنكار مستحيلًا. هكذا تتالت الأخبار عن قتل طائفي استهدف عائلات في حيّ القصور في مدينة بانياس، وفي سلسلة بلدات وقرى واقعة شمالاً على طول الساحل، بما في ذلك المختارية، والشير، والشلفاطية، وبرابشبو، حيث تتركز الطائفة العلوية، حسب تحقيق لـ «رويترز» نُشر منذ يومين.
ومع الأخبار وصلت فيديوهات عديدة، من بينها واحد كان الأفظع، لأم سورية أمام ثلاث جثث (لابنين وحفيد لها) ملقاة أمام البيت، فيما يجادلها قاتِلوهم بحوارٍ مخزٍ: «هذول ولادك.. نحن عطيناكم الأمان، بس أنتم غدارين»، و»استلمي ولادك». حوار مهين، لا لأنه طائفي وحسب، بل لأنه لم يراع أقدس المشاعر وأكثرها نبلاً. هل هناك أكثر توحشاً من أن يُقتَل أبناءٌ أمام والدتهم، ويُتركون جثثاً مكشوفة في الطريق، ثم يُشرِع القَتَلة بـ «مكايدة» الأم! قد يسعفنا هنا شطرٌ من قصيدة لمحمود درويش، فيما يتحدث عن محمد الدرة، الولد الفلسطيني الذي قُتل على يد جنود إسرائيليين على مرأى العالم كله في مشهد للتاريخ، عندما وَصَفَ فهداً رآه على شاشة التلفزيون يحاصر ظبياً رضيعاً، قالَ: «حين دنا منه شم الحليبَ، فلم يفترسه، كأن الحليب يروّض وحش الفلاة». أما هؤلاء المسلحون الطائفيون، قَتَلَة أبنائها، فلم يردعهم حليبٌ، ولا حَوَمَان أمٍّ في الثمانين حول جثامين أبنائها، فلقد جاءت التفاصيل الأخرى، ما وراء الفيديو، أفظع، حيث حُرمت مع دفنهم لأيام، فيما أصرّوا على الإقامة لبعض الوقت في بيت يقع قبالة بيتها.
مع هذا الفيديو، لا ينفع أن تستحضر أسباب الدنيا كلها لتبرير القتل، والأسئلة كلّها مألوفة ومكررة لتسويغ القتل في الحرب: اُنظر من الذي بدأ، اُنظر من قَتَلَ أكثر.. اُنظر إلى 13 عاماً من القتل والمجازر والتهجير والتدمير والبراميل العشوائية المتفجرة، وكل هذا صحيح، لكن هذا الفيديو بالذات يستحق انتزاعه من أي سياق، فما جاء فيه كافٍ لقراءة الكارثة التي تحلّ بنا، في أي مستنقع بتنا، بعد أملٍ واحتفال وأعراس نصر مديدة!
أخلاق الحرب
لماذا قُتل شبان مدنيون على الفور حتى قبل أن يجيبوا عن سؤال إن كانوا علويين أم لا؟ وحتى قبل أن يُسألوا إن كانوا مع النظام أم ضده، إن كانوا عسكريين أو مدنيين.. فالقتلة يعرفون أنهم في قرية علوية تستحق الإبادة، وهم «غدارون» بالجملة، يستحقون القتل حتى من دون محاكمة، و»الدعس»، والتنكيل، وانتزاع حقهم بدفن كريم. ليس هؤلاء هم أنفسهم الثوار الحالمين بدولة عدالة ومساواة، فمن يريد العدل حقاً يعرف أن «العين بالعين»، خارج نطاق القضاء، ستجعل العالم كلّه أعمى.
صحيح أن فلول نظام الأسد وشبيحته اتخذوا من الساحل أوكاراً لجريمتهم، وصحيح أن مشروعهم سيتقاطع مع رغبات دولية للانقلاب على الإدارة السورية الجديدة (روسيا للتفاوض على قاعدتين عسكريتين في الساحل، إيران التي لا تريد أن تصدق أنها خسرت سوريا ولبنان وغداً اليمن، وربما أطراف أخرى متضررة)، لكن هذا لا يسوّغ التعامل مع 9-11 بالمئة من السوريين (النسبة المفترضة للعلويين من السوريين) على أنهم غدّارون يستحقون القتل بجريرة جرائم الفلول، ولنفترض أنهم عسكر في غالبتيهم فلا يمكننا إنكار وجود مدنيين، ونساء وأطفال، وكبار سن.. (وبالطبع لم يصل الأمر إلى حدّ إبادة طائفة برمتها، ولكن الدخول إلى حيّ ومحاولة قتل كل من فيه هو صورة مصغرة عن رغبة أشمل، قد يسهم في تسهيلها ثقافة تكفيرية عند بعض الفصائل).
وإذا أردنا ألّا نثقل على الفصائل المسلحة، التي هبّت يوم إعلان «النفير» في عموم البلاد، يوم انقلاب الفلول، بالحديث عن شرعة حقوق الإنسان، وحقوق الأسرى، وقوانين الحرب، فيمكننا التذكير على الأقل بوصايا الخليفة أبي بكر الصديق لجيشه: «لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تغلّوا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرّون بأقوامٍ قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له».
أو وصايا عمر بن الخطاب: «إياكم والمُثلة ولو بالكلب العقور».
إنها الرأفة حتى بكلب ونخلة! فما بالك بقتل نساء وأطفال وانتهاك حرمات البيوت وسرقات!
يجري الحديث، كنوع من التبرير لقوات الأمن العام الحكومية، عن انتهاكات فردية وفصائل مسلحة ليست تماماً تحت السيطرة، ولكن هناك فيديوهات عديدة للأمن العام بوجوههم الصريحة يظهرون فيها وهم يعتقلون أفراداً ملاحقين ومشتبها بهم ليست سوى انتهاك للكرامة أيضاً، ولو أننا هنا سنسعد أنهم لم يقتلوهم ويرموهم على قارعة الطريق، لكن لا تنكر تلك الرغبة بمحاكاة النظام البائد بانتهاكات مماثلة، فقد ظهرت فيديوهات طبق الأصل، فمقابل فيديو شهير لجندي نظام الأسد يدخل حي بابا عمرو الحمصي مع عبارة يقول فيها: «بابا عمرو سابقاً»، سنجد مقاتلاً مسلحاً يصور نفسه في فيديو يقول: «كان في قديم الزمان مدينة اسمها جبلة، اِلْتَعَن سلّافها، صارت صحراء، حرقوها حرق».
لقد أصبحنا في مواجهة مناخ عام مسموم يَسمح بارتكابات، وبعد أن تغنّينا لأربعة أشهر بطقس احتفالي مضاد تماماً، بتنا لا نجرؤ اليوم على مجرد الإشارة لأصغر انتهاك، يقرّ رئيس البلاد بحدوثها، ويعد بمحاسبة مرتكبيها، أما رفاق الطريق، الذين طالما نادوا بالحرية والعدل لنا ولشركائنا في البلاد، بل ودفعوا أثماناً من أجل ذلك، فما زالوا يعاندون.
*القدس العربي