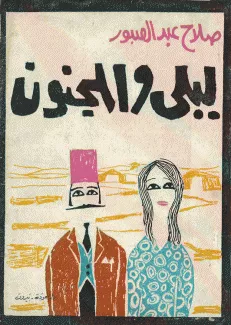ترجمة حسين جرود
في سنتي الجامعية الثانية، تقدمتُ بطلب الالتحاق ببرنامج الكتابة الإبداعية. إذا قُبلتُ، سأتخرَّج خلال عامين بتخصص في الكتابة، وإن لم أقبَل، فسأبحث عن تخصصٍ جديد. ترددتُ في تقديم الطلب لأشهر. حضرتُ جلسات تعريفية، والتقيتُ مدير البرنامج، وراجعتُ قصائدي مرارًا وتكرارًا حتى قال لي أحد الأساتذة في النهاية: “برايان، استرخِ. دع القصائد تتحدث”.
لم أكبر وأنا أقول: أريد أن أصبح كاتبًا، لكن الدلائل موجودة، كأمنية سرية أخفيتها عن الجميع، حتى عني. جولةٌ في مذكرات مراهقتي الفاترة ويومياتها الفاشلة تكشف عن ملاحظات مثل: “أريد كتابة الكتب، لكن لا يُمكنك كسب عيشك بهذه الطريقة”. يا لكَ من غربأوسطيّ: ببساطة، الفنون ليست عملية.
ثم في ظهيرة باردة من شهر أكتوبر، زارني والداي في الحرم الجامعي، وتعثرتُ باعترافٍ ما: أريد أن أصبح شاعرًا، قلتُ. أريد أن أتخصص في الشعر. ولحسن حظهما، فقد استقبلا الخبر بصدر رحب. سألتني أمي، التي كانت مسؤولة عن شؤون العائلة المالية، سؤالًا مألوفًا: كيف يكسب الشاعر رزقه بالضبط؟
تلقيتُ الخبر السار بعد ظهر يوم ثلاثاء. لا أعرف عدد المتقدمين الآخرين، لكنني شعرتُ وكأني من صفوة الخلق. التقيتُ بماري كينزي، الشاعرة التي تدير قسم الكتابة. كانت الكتب مُكدسة فوق مكتبها وعلى الأرض. خلف كرسي في الزاوية، كان الملصق الترويجي لقراءة قدمتها في بارنز أند نوبل لكتاب “سفينة الأشباح”، أحدث كتبها الصادرة عن دار كنوبف. كنوبف! لا أتذكر كلمة واحدة مما قالته ذلك اليوم، فقط هالة من الأمل العريض أحاطت بحديثنا.
كانت العادة في جامعتي أن تُمهّد لكل فصل دراسي بأسبوع قراءة، فترة تحضيرية دون حضور فصول دراسية. أرسلت الأستاذة كينزي قائمة قصائد ليقرأها الشعراء المتدربون. قائمة طويلة جدًا. بدأت مع فجر الشعر الإنجليزي: تشوسر، وايت، وسبنسر. ثمّ، قدّمت مارلو، وكوبر، ومارفيل. وتوالت الأسماء في الصفحات؛ لم أكن أعلم بوجود هذا الكم الكبير من الشعراء الجديرين. أحيانًا كانت أبياتهم لحنية، وأحيانًا غامضة، وفي أحيان أخرى كانت تُغرقني في النوم.
قبل بدء الدرس الأول، تلقيتُ رسالة بالبريد الإلكتروني: “في 27 سبتمبر، ستحضرون مختارات نورتون، وقراءاتكم، والمجلدات الإضافية إلى الفصل. سيغطي امتحان مدته 80 دقيقة مفاهيمَ عن علم العروض والأسلوب من حيث المفهوم، وكيفية تطبيقهما على القصائد. كونوا مستعدين للتمييز بين ممارسات شعراء القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيما يتعلق بكلٍّ من الأسلوب والشكل الشعري”.
في قاعة المحاضرات، في اليوم الأول، التقيتُ أحد عشر شاعرًا متدربًا قلقين جدًا. بناءً على حديث قصير وبعض الاعترافات الهامسة، قدّرتُ أننا جميعًا تقريبًا إما قرأنا بسرعة أو لم ننهِ أجزاءً كبيرةً من الكتاب. واعترف أحدهم: “لا أعرف حتى إن كنتُ أحب الشعر”.
لأسباب لن أذكرها، خضعنا للامتحان في المنزل بدلًا من إكماله في الصف. معًا، راجعنا المنهج. كنا نقرأ ونكتب السوناتات، والسستينات، والجورجيات، والأودات، والشعر المرسل، ثم، أي شكل شعري نختاره، كنا نؤلف قصيدة طويلة من 150 سطرًا أو أكثر. قالت الأستاذ كينزي: “هذا برنامج للشعراء الجادين. سأعاملكم على هذا الأساس”. سألت إحدى المتدربات بخنوع: هل نكتب قصائد شعر حر؟ قد تظن أنها سألت إن كان من الممكن تقديم القصائد باللاتينية.
قالت الأستاذة كينزي إن الفهم العميق لعلم العروض أمرٌ بالغ الأهمية للشعراء قبل كتابة الشعر الحر. نطقت الكلمتين الأخيرتين كما لو كانت تصف علقةً في المجاري. في أقصر وقت، عبّرت عن ازدرائها التام للتعبير غير المنظوم. لقد كانت، كما ترون، شاعرةً عظيمةً.
على مدار الأسابيع التالية، كتبنا محاكاة لقصائد أخرى، وتدربنا على علم العروض، وحاولنا (وفشلنا) في قراءات نقدية. حضر شعراء مشهورون جلسات أسئلة وأجوبة وورش عمل متقدمة؛ وألقى اثنان من الشعراء الأمريكيين الحائزين على جائزة شاعر البلاط الملكي (روبرت بينسكي ودونالد جاستيس) خطابات، ثم اختفيا فجأةً. في ورش العمل، قرأنا وعلقنا على قصائد بعضنا، وناقشنا ما نجح منها وما لم ينجح، وهل خالفت إحدى القصائد قواعد الشكل؟ وما هي القصائد الأخرى التي ذكّرتنا بها قصيدة طالب ما؟
ما الذي يجعل الشاعر شاعرًا؟ طبعًا، لا توجد إجابة بسيطة. يُمكن القول إن التصريح الذاتي كافٍ. كما يُمكن القول إنه لا بد من وجود معيار. الآن، بعد عقود، أضحك من إيماني العميق بأنه لكي أكون شاعرًا حقيقيًا، يجب عليّ أن أحظى بموافقة أكاديمي. كما لو أن الشاعر طبيبٌ أو محامٍ، ممارسٌ يُشترط عليه استيفاء معايير صارمة. بالتأكيد، لم يمنح أحدٌ جون كيتس أو بيرسي شيلي رخصةً لممارسة الشعر المرسل.
لا أعرف كيف تخيلت أن يكون شعوري بوصفي شاعرًا متدربًا. بالتأكيد، ظننتُ أن هناك المزيد من الارتجال، والقليل من السرد الشعري. عندما كان زملائي يشتكون في المدرسة بأنهم يريدون المزيد من الحرية، كنت أومئ برأسي موافقًا، ولكن في داخلي، كطالب مجتهد، فكرتُ، حسنًا، علينا أن نكسبها. لم أحب هذه العقيدة، لكنني وافقتُ على الفلسفة الكامنة وراء التدريب: لكي يصبح المرء شاعرًا، عليه أولًا أن يأخذ شيئًا غامضًا (أن يكون شاعرًا) ويجزئه إلى أفعال محددة، ملموسة، تكاد تكون يومية. الشاعر يقرأ القصائد. الشاعر يعرف الوزن، ويسبر الأبيات، ويشير بالاستعارات. والأهم من ذلك: أن الشاعر لديه روتين، ومجموعة أدوات، واستعداد للعمل، كلما حان وقت العمل. إنها حقائق مفيدة، بغض النظر عن تعريفك للشاعر.
بوصفي شاعرًا متدربًا، واجهت مشكلة واحدة فقط. افتقر تحليلي إلى الحيوية. كان وزني ضعيفًا. كانت استعاراتي متباينة. كنت أتلقى بعض الثناء من كينزي والشاعر الأجشّ ذي الشعر المُنسدل الذي كان يشرف على تأليف قصائدنا الطويلة. لكن إذا تجاهلنا الطموح والطاقة والرغبة، لم أكن شاعرًا عظيمًا. كنتُ في أحسن الأحوال شاعرًا مناسبًا.
لطمأنة والديّ بأنني سأتمكن يومًا ما من سداد قروض ستافورد التي غطّت دراستي الجامعية، تحملتُ أيضًا عبء الدراسة في تخصص ثانٍ، وهو علم النفس. قد تضحكون، لكن مقارنةً بالشعراء، يجني علماء النفس أرباحًا طائلة. تدريجيًا، بدأ هذا التخصص الآخر يبدو خطة احتياطية بنحو أقلّ، وغدا أشبه برحلة منظمة. سؤال: كيف يكسب الشعراء الأكْفاء لقمة عيشهم؟ الجواب: لا يفعلون.
طوال أسبوعين من الفصل الدراسي الشتوي، كتبت مجموعتنا قصائد يومية. كانت كل قصيدة استجابةً لدافع. كان دافع أحد الأيام إعادة سرد مشهد من رواية شهيرة. كنت آنذاك أقرأ رواية فرانكشتاين لصف آخر. في قصيدتي، أعدتُ تخيّل المقطع الذي يترك فيه فيكتور عروسه الجديدة إليزابيث ليلة زفافهما. يخبرها أنه يجب عليه مطاردة الوحش الذي خلقه قبل أن يؤذيها. وبينما هو غائب، يتسلل المخلوق ويقتلها. صوّرتُ المشهد من وجهة نظر إليزابيث في السوناتة.
إليكم القصيدة كما كتبتها في 28 يناير/كانون الثاني 1997:
(إليزابيث تنتظر)
ما أغرب الطريقة التي يتجول بها فيكتور الحبيب،
والبندقية المحشوة لا تزال معلقة في حزامه،
عيناه تشتعلان بنيران تذوب
ليلة مسكونة لدرجة أن الأشجار تُصدر عواءً.
مصراع النافذة يُصفِّق، إنه مطر، مجرد مطر لنرى..
5
أرسلني إلى غرفة النوم لأعتزل العالم.
أعلم أنه سيُجذب قريبًا إلى الخيط
الذي يربطنا بمصيرنا المقدس.
أتمنى ألا يكون البعد الذي جلبته السنين،
ولا الحزن الذي يراودنا دائمًا..
10
ولا الحزن قد قسَّى عاطفته
-هل هذا ضجيج؟ لا، إنها دموعي المتساقطة فقط-
فيكتور! لا تبتعد عني بعد الآن،
لماذا تتجنب واجبات الأب؟
*
أجل. إنها سوناتا عادية، إيقاعها متذبذب (أحيانًا خمس تفعيلات في السطر، وأحيانًا أربع)، بتردد متفاوت، واستخدام غريب لكلمة “ستارك”، ورتم بتراركي، ميكانيكي، فيها عيوب، كمعظم قصائدي. لكن روحيًا، كانت بالنسبة لي نقلة نوعية. أوحت بشخصية، وجسدت صوتًا، وأرست مشهدًا. كان فيها وميض من حياتها الخاصة، وإن كان من طريق شعلة مستعارة من ماري شيلي.
لا أتذكر ما قالته الأستاذة كينزي عن سوناتتي. أعتقد أنها أشارت إلى مواضع خلل في الوزن. وانتقدت بشدة استخدام أسلوب عتيق في البيت الخامس. اعتبرتُ كل ذلك نقدًا مشروعًا، وبدأتُ العمل على القصيدة اليومية التالية. لكن لأيام بعد ذلك، ظللتُ أفكر في هذه القصيدة، في مدى استمتاعي بكتابتها، رغم كل عيوبها.
بعد فترة وجيزة، في وقت متأخر من ليلة شتوية أخرى، عدتُ أطارد ذلك الشعور. كتبتُ قصة قصيرة بعنوان “العودة إلى الأساتذة”، وهي حكاية عن أشخاص بالغين عاديين لديهم أشغالهم بدؤوا، لسببٍ غامض، بشراء كتب الشعر بأعداد كبيرة، مما دفع الشعراء إلى مصاف نجوم البوب، مُحدثين تحولًا مجتمعيًا لا يمكن لأحد تفسيره. لم تكن رائعة، لكنها كانت ذات إيقاع جيد، يُشعرك بالرقص على أنغامها، و… (اسمع، لقد استمتعتُ بكتابتها).
قبل أن أدرس على يد ماري كينزي، كنت أعتقد أن الكتابة أشبه بانتظار أحوال الطقس. أشعر بقدوم أمر عظيم، لكن لم يكن بإمكاني الجزم بموعده، ولا يوجد ما يمكنني فعله تقريبًا لتغييره أكان جيدًا أم سيئًا. مع اقتراب نهاية السنة الأولى من تدريبي، أصبحت كاتبًا أفضل، نعم؛ لكنني ما زلت أشعر أن أمامي الكثير لأتعلمه. كنت بحاجة إلى مزيد من التوجيه، ومزيد من الوقت.
طلبتُ المساعدة، فتناولتُ القهوة مع أستاذ آخر في قسم الكتابة، رجلٌ ودودٌ يرتدي ربطة عنقٍ على شكل فراشة في المحاضرة، ويخاطب الطلاب رسميًا مستخدمًا ألقابهم. كانت محاضرته بعنوان “أساسيات النثر”، وفي الصفحة الأولى من مقالٍ كتبتُه له عن متعة القيادة، كتب: “الدرجة: ممتاز. استمر يا سيدي، ولا تلتفت إلى الخلف أبدًا”. هل ظنّ، ربما، نوعًا ما، أنني لستُ شاعرًا؟ هل ظنّ أنني يجب أن أقضي وقتًا أطول في كتابة المقالات والروايات؟
أنهيتُ واجباتي كمتدرب، وسلّمتُ قصيدتي الطويلة، وحضرتُ حفل نهاية العام مع زملائي الشعراء. (“انظري يا أمي!”.. هكذا قلتُها) لكنني لن أُطلق على نفسي لقب شاعر مرة أخرى. كان لديّ لقب جديد في ذهني: كاتب قصة قصيرة.
في غضون أسابيع، وبمساعدة من أستاذ النثر، وبمباركة البروفيسور كينزي، التحقتُ بفترة تدريب ثانية، وحصلتُ على قائمة قراءة جديدة، مليئة بروائيين وكتّاب قصص قصيرة. بفرحٍ وحرص، تجولتُ في المكتبات المحلية المستعملة باحثًا عن كتب لـ كازو إيشيغورو، وأليس مونرو، وتوماس بينشون. أسماء لم أسمع بها من قبل. عوالم جديدة كنتُ أتوق لاكتشافها.
ربما هذا هو الحل، فكَّرت. ربما وجدتُ المكان المناسب لأُكرّس نفسي فيه. قلتُ لشخصٍ ما في حفل نهاية العام للشعراء المتدربين: “الطريق واضح”. شعرتُ أن هذه حقيقة صعبة المنال. طبعًا، لم يكن الأمر كذلك. كل من جاهد طويلاً ليصبح كاتبًا يعرف أن هذا جنون. لا توجد مسارات، بل أماكن تُثبت فيها قدميك.
*تكوين