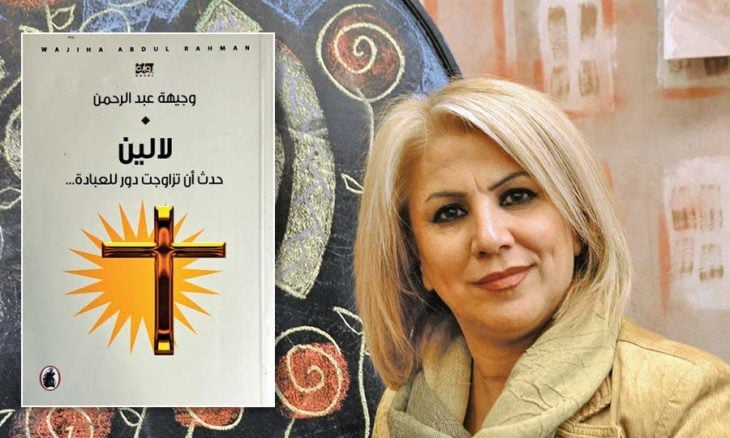زويا بوستان
هل تعلم ما هو أقسى من أن تُقتلع من بيتك؟
أن تجرّ ذلك البيت معك إلى آخر الدنيا، وتحاول، بما تبقّى فيك من عقل، أن تبنيه من الذاكرة وحدها.
كأننا، نحن السوريين، لم نُهجَّر من بيوتنا، بل حملناها معنا.
كأننا، حين تركنا المفاتيح على عتبات البلاد، خبّأنا خلف الباب شيئًا من أرواحنا، ثم خرجنا نبحث عنه،
نبحث عنه هنا، في أوروبا، بين أسواق الأشياء المستعملة ومحلات الكراكيب، نفتّش في صناديق الغرباء، بين الطناجر القديمة، والفناجين الخزفية، والصواني المنسية.
نفتّش كما يفتّش أحدهم عن طلسم، ليتذكّر كيف كان حيًّا.
في ستراسبورغ، حيث كل شيء لامع ومنظَّم ومنضبط على عقارب الساعة، حيث كل شيء في مكانه إلا الإنسان،
عدنا نبني بيتًا لا يشبه الجدران التي تحيط به، ولا يعني شيئًا لجيراننا، لكنه يعني لنا كل شيء.
بيت يشبه قريتنا، حارتنا، مطبخ والدتنا، ونومنا على الأريكة أمام التلفاز.
الشرفات هنا مزهّرة، لكنها خالية لا يجلس عليها أحد، وكأنها مجرد زينة.
أما شرفتنا الصغيرة في حيّ الدويلعة، فكانت تتسع للعائلة كلها، فعلًا.
كنا نجلس سويًّا، نتحلّق، نتحايل على الضيق ونضحك، وكنت دائمًا أخاف أن تهبط بنا الشرفة ونصبح جميعًا شهداء كأس المتة مع أم بسّام، والدة زوجي، على الشرفة العتيقة.
هناك كنّا نعيش. وهنا، نعيش على التذكّر.
في المطبخ: طنجرة عتيقة التقطتها من سوق في الريف الفرنسي، شوكة وملعقة لا تشبهان ما يُباع اليوم، وسكبة رز لا تغيب عن الغداء.
فناجين القهوة التي جمعتها واحدة واحدة، السلال، صواني القش، سَبت الخيزران، صينية خشبية، ومرطبانات فيها مخلل لفت صنعتها كما كانت تصنعها أمي.
وفي الزاوية، كيس يحوي أكياسًا أخرى. نعرف تمامًا أنها متوفرة ورخيصة ولكن هيهات أن نقتلع من جيناتنا تلك الخصيصة، ولأن وجودها أيضاً يطمئن، يكرّس الفوضى المألوفة، فوضى البيوت الحقيقية.
في الزاوية الأخرى: أرجيلة نحاسية، دلة قهوة عربية، طاحونة بنّ عربي صغيرة التقطتها من محل أنتيكا، كل شيء في مكانه كأنه آت للتو من على طربيزة أبي..
في الحمام، ورد جوري مجفّف في جرة فخارية.
رائحته تلاشت منذ زمن، لكنه مرتاح، لأنه يعرف أن صاحبة هذا البيت الجديدة، ما زالت تؤمن بأن ما صمت لا يعني أنه مات.
على طاولة التلفاز، دربكة صغيرة، وعلب خشبية مزخرفة بالفسيفساء، إلى جانب جهاز الإنترنت،
ربما أضعهما معًا على أمل أن يتفاهم هذان العالمان يومًا ما وتجتمع الرؤوس في الحلال،
وأن تخرج من الشاشة بدلاً من زمّور الذي يدعونا لمغادرة فرنسا، صورة ريم الخيام ترقص خلف عصمت رشيد على أنغام: ليه تشكي من الدنيا يا ورد؟
والمفاجأة؟ أحب هذه الأغنية.
في الركن القريب من النافذة، جلست نبتة ياسمين بلا أوراق، لا تزهر ولا تموت، بل تنتظر.
وضعتها قرب مكتبة فرنسية امتلأت بكتب لم تُفتح، اشتريناها بفرحة المغفلين وأنصاف اليوروهات فقط لنقنع أنفسنا بأننا نندمج.
لكنّ نبتة الياسمين، بصحبتها وطول عشرتها لأرثور رامبو وبول إيلوار، باتت تفهم الفرنسية أكثر مني، وأشعر أنها فهمت المنفى قبل أن أفهمه.
وفي آخر الغرفة، فرش ملوّن من جِلد مشلوف كيفما اتفق.
الضيوف لم يفهموا سبب وجوده، لكن وليكن فهو يعرف تمامًا لمَ هو هنا، وما هي وظيفته.
أنا لم أبنِ بيتًا، أنا استدعيت الأرواح وحرستها من الضواري كالغجر.
أصغيت للصمت، ودعوتهم واحدًا واحدًا من الماضي:
مطبخ أمي، ركوّة القهوة من طاولة أبي، زريعة الجدات، الياسمينة التي نسيت اسمها، والدربكة التي ضاعت نغمتها.
أعدتهم من المنفى الأكبر إلى المنفى الأصغر إلى هذا البيت.
لا كزينة، بل كتعويذة. كحنين. كحيلة أخدع بها الغربة وأقول لها:
أنا هنا، لكن قلبي، قلبي لم يذهب بعيدًا.
وكلما مشت الشمس على طاولتي الصغيرة،
وكلما تصاعدت رائحة البن من مطحنة قديمة التقطتها من يد عجوز فرنسي،
وكلما رأيت زريعة تتحدى الشتاء على نافذة لا تصلها الشمس،
أعرف أنني لم أترك شيئًا ورائي
أنا فقط حملته معي، حبّة حبّة، قطعة قطعة، من دمشق إلى هنا
نقلت دمشق إلى قلب بيتي، كما ينقل العاشق صورة حبيب في جيبه، لا ليرثيه بل ليحياه.
وعندما أفتح عينيّ صباحًا في ستراسبورغ، لا أرى غربة.
بل أرى بيتًا، فيه دمشق جالسة في الزاوية، تمسك فنجانها، وتقول لي بصوت أمي:
قومي يا زوزو قومي يا حبيبتي لنتناولها معًا على المسطبة