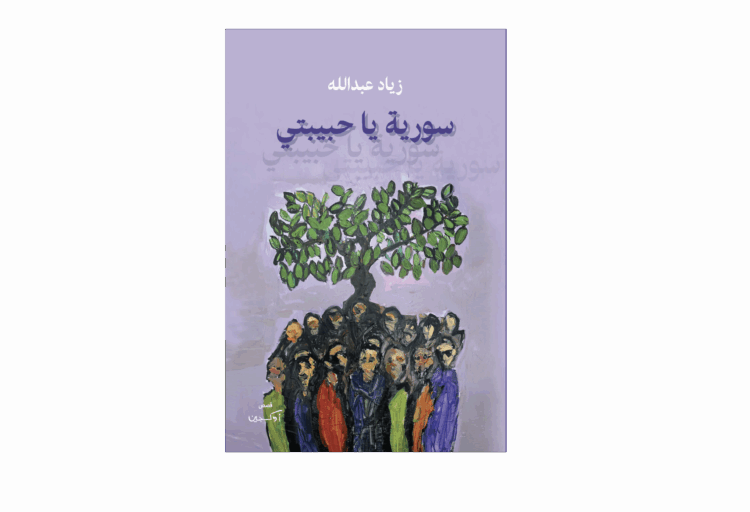رحلة القراءة محفوفة بالعناوين المؤجلة مواجهتُها، ولا يجدي نفعاً التسرعُ في فك مغاليقها. لأنَّ ذلك يتطلبُ مراناً، ونفساً طويلاً وتطبيعاً مع المواضيع التي تدرسها تلك الكُتب. لا شكَّ إنَّ تذوق المعرفة يرافقه التشويق باستمرار، لكن الدروب إلى اكتشاف مصادر المعرفة لا تخلو من الملل. ومن المحتمل أن تكون هناك مؤلفات لن تحظى بالمقروئية على نطاق واسع، وما يزيدُ العزوف عنها، هو التعقيد الذي يكتنفها، لذلك قد لا يسعُ المرء إلا إبداء الإعجاب عندما يصادفُ من يجوبُ مملكة كانط أو هيغل الفلسفية، شارحاً أفكار القطبين أو باحثاً عن المفاهيم التي غابت عن الآخرين في فتوحاتهما الفلسفية. بالطبع كما أنَّ تصاعد جمهور القراء ليس محكاً لجودة الكتاب كذلك فإنَّ محدودية التلقي لا يفهمُ منها قلة التأثير، أو الانسحاب إلى الظل. على سبيل التمثيل لا الحصر فإنَّ كتاب «نقد العقل الخالص» لكانط لا يتصدرُ قائمة القراء ولا حتى المختصين في الفلسفة، وقد تعثرَ عدد غير القليل من المغامرين بقراءته من الصفحات الأولى، غير أنَّ ذلك لم يلغِ ارتداداته المزلزلة على الصعيد الفلسفي . وإذا كانت هناك عقولُ تعاني من عسر الهضم لبعض المؤلفات فإنَّه من الخطأ الإشهار بهذه الحالة حجةً عليها.
مفاتيح الكتاب
وما يجنبُ العقل من الاصطدام هو التدرج في القراءة، إذ ثمة كتب يجبُ البحث عن مفاتيحها قبل النزول إلى حلبة متونها. يشيرُ المفكر السوري هاشم صالح إلى أنَّ ابن سينا قد حاول مراراً وتكراراً قراءة كتب الميتافيزيقيا لأرسطو، وباءت مساعيه بالفشل، إلى أنَّ وقع صدفة على شرح الفارابي للمعلم الأول في حينها فانقشع الغموض. ينصحُ وول ديورانت القراء بعدم الذهاب مباشرة إلى كانط، بل الأجدرُ بمن يهمه فهم أعمال الفيلسوف الألماني، متفادياً التخبط في ألغازه أن يقرأ ما نشر عنه. هل يعني ذلك التحرك في مجال الكُتب التي لا يشقُّ عليك قراءتها ولا تكلفُ كداً ذهنياً؟ من المؤكد أن هذا المنحى لا يحققُ انطلاقاتٍ نوعية ولا يكسبُ القارئ مستوىً أفضل ولا لياقة أقوى. تماماً كما أنَّ الفريقَ الذي لا يلعبُ مع خصمٍ أفضل يتدنى مستواه مع الوقت، كذلك الأمر بالنسبة إلى القراءة باتجاه واحد لا تمنحُ الفكر فرصة اختبار طاقته بنصوص جديدة.

ومن المبالغةِ القولُ إنَّ مصاحبة الكتب والأعمال الأدبية والفكرية هي مغامرة شيقة في الحقيقة، لو كان الأمر على هذا المنوالِ لما استغرقَ ترويض عدد من الكتب وقتاً طويلاً، وما داهمَ المللُ المزاجَ بالاشتباك مع التراكيب التقنية أو ملاحقة الشخصيات المتناثرة في براح النص الروائي. ربما المللُ لا يأتي من الكتب، بل يكون مصدره طبيعة القارئ الملولة، حسب رأي الكاتب العراقي علي حسين، أو عدم الاختمار في مسيرة القراءة. يفردُ صاحبُ « دعونا نتفلسف» كتابه الجديد «لماذا نقرأ الكتب المملة؟» لاستعادة تجربته مع العناوين التي يحومُ حولها دخان الغموض، وصارت معروفة بالصعوبة في الصياغة والخط الذي تنتظمُ عليه مادتها، إذ يشيرُ علي حسين في المقدمة إلى أنَّ التحدي الأبرز للقراءة هو المنصات الافتراضية، وما يبسطُ على جدارها من المنشورات السائغة للمُتابعين. يبدو أنَّ عدد القراء قد تضاعف بفضل الوسائط الرقمية، لكن ذلك قد لا يعتدُ به لأنَّ ما يقرأ في هذه البيئات لا ينهضُ بالفكر وليس كاشفاً للممرات الجديدة.
قبل أن يسردَ علي حسين قصته مع الكتب الدسمة، يؤكدُ أنَّه منذ أن تصفحَ أول كتاب في حياته وإلى اللحظة، التي ينضدُ فيها كلمات إصداره الأخير وهو يعيشُ مسكوناً بحب الكتب. إذ يعاقرُ ما جادت به عقول أساطين الأدب والفكر، مستعيداً في هذا الصدد بداياته عندما كانت أسماء تولستوي وسارتر وعبدالرحمن منيف تخطفُ بصره، مُتهيباً من سحب مؤلفاتهم المرصوصة في الرفّ. ومن المتوقع أن تتواردُ آراءُ في مديحِ القراءة في أي كتاب قوامه التجربة الشخصية في عالم يتسعُ لمزيد من المُغامرات والحفر في أرضية غير معهودة فبرأي مارسيل بروست تقومُ ذاكرة القارئ الوجدانية على المؤلفات التي منحت لوناً لأوقاته وهي بمثابة التقاويم التي يمكن الاحتفاظ بها لأيامٍ قد مضت. تضاهي القراءة لدى حنة أرندت عملية إنشاء عالم يستهوينا العيشُ فيه. والقوى الخارقة یستحیل الوصول إلیها إلا من خلال القراءة، علی حد تعبیر الفلكی الشهیر غالیلو.
يعترفُ الكاتبُ في فصول مؤلفه بأنَّ هناك عناوين قد صدمته ولم يتمكن من فك ألغازها، وتأتي في المقدمة «يوليسيس» و»البحث عن الزمن المفقود»، لافتاً إلى محاولاته العابثة لقراءة «أصول الرياضيات» لبرتراند راسل. إذ يتأكدُ من الصفحات الأولى بأنَّه مغتربُ في جغرافية كتابٍ يقالُ إنَّ عشرة أشخاصٍ نجحوا في اختراق سياجه المنيع. والأمر يتكررُ في قراءة كتاب «الوجود والزمان» لهيدغر، ويختبرُ علي حسين حظه بمواجهة كتاب «النسبية» لأينشتاين ولا تؤتي المحاولة أُكلها إلى أنْ يكتشفَ أجزاءً من خريطة نظرية النسبية عن طريق ما نشره الكاتب المصري مصطفى محمود، وما تبع ذلك من التمهيد إلى معقل الفيزياء عن طريق مؤلفات عبد الرحمن مرحبا. ومع المضي في القراءات يعرفُ حسينُ أكثر عن أينشتاين وخلفيته الفكرية، فقد كان مهتما بفلاسفة القرن التاسع عشر بمشاربهم المتباينة واتجاهاتهم المتعددة. وتأثر بالفيلسوف الإنكليزي «ف. ب برادلي» خصوصاً بعصارة أفكاره في كتاب « المظهر والواقع». واللافتُ أن الشاعر ت. س إليوت» يشاركُ أينشتاين في الشغف بمواطنه، ويكرسُ لهذا الفيلسوف أطروحة دكتوراه، مُناقشاً نظريته عن الزمن. ولا ينتهي الأمر باختصاصه الأكاديمي، بل تعكسُ نظرية برادلي في ثيمات قصيدة «الأرض اليباب» والبحثُ عن مفهوم الزمن يقودُ إليوت إلى رحاب محاضرات أينشتاين حيثُ يدور الحوار بين الاثنين بشأن الطبيعة النسبية للزمان والتبدلات التي تشهدها البنية المكانية ومفاعيل كل ذلك في مصائر البشر. وما يشدُ الانتباه في هذا الإطار أنَّ جيمس جويس كان شغوفاً بكتاب «النسبية الخاصة»، وكان يضعه على مرمى نظره، ومن الجلي بأنَّ المشترك بين الثلاثة جويس وأينشتاين وأليوت هو تناول البعد الزمني.
ومما يقدمه علي حسين عن العالم الفيزيائي أينشتاين يؤكدُ أنَّ الاختصاص لا يمنع من الاغتراف من مصادر معرفية أخرى وهو كان يقرأُ الروايات التي تصوغُ براهين حياتية، إذ وجدَ في ذلك فرصة للتفكير المُمتع في جوانب باطنية من شخصية الإنسان. قبل أنْ تنتهي جولة الكاتب مع أينشتاين يلمحُ إلى توقير الأخير لكانط وقراءته لكتاب «نقد العقل المحض» عندما كان في الرابعة عشرة من عمره ويعتقدُ صاحب نظرية النسبية بأنَّ العلوم الطبيعية مَدينةُ في تطورها لما قدمه كانط في فلسفته. إلى هنا يبدأُ علي حسين بسرد قصته مع مدشن عصر التنوير ورحلته المتعثرة مع كتابه العلامة «نقد العقل الخالص»، ولا يعودُ إلى عالم كانط إلا من خلال زكريا إبراهيم، كما يسمعُ من الروائي فؤاد التكرلي، الذي كان من زوار المكتبة التي كان يعملُ فيها علي حسين الشاب، أنَّ بعض الكتب تحتلُ مكانةً متميزة ليس لأنَّ الجميع قرأها وفهمها، أو لأنها كتبُ ممتعةُ، بل لأنها مارست تأثيراً على الفكر البشري. بالطبع لا يمكنُ أن تصل مروحة الكلام إلى كانط دون التذكير بأسئلته الثلاثة، التي تلخص جميع اهتمامات العقل التأملية والعملية. ما الذي يمكنني معرفته؟ ما الذي يجبُ عليَّ القيام به؟ ما الذي قد آمله؟
يتابع علي حسين جولاته مع كتب من وزن ثقيل ويكون «أصل الأنواع» لتشارلز داروين حاضراً في حلبة القراءة، علماً أنَّ هذا الكتاب لمئة عام وأكثر حفنةُ من المتابعين تمكنوا من هضمه وفهم تضاريسه المتشعبة.
لمحات سيرية
مشاركة الأفكار التي تحفلُ بها الكُتب الوازنة مع الآخر صنعةُ يلمُ المرءُ بأسرارها بعد أن يسخو بشطر كبيرٍ من عمره للقراءة، لا شكَّ أنَّ سيرة أي إنسان تحملُ بصمات مهنته واهتماماته الشخصية، فما يرويه صاحب «الكتب الملعونة» عن تجربته مع مصاحبة أعمال الفلاسفة والأدباء. هو الوجه الأبرز لحياته التي لا تنفصل محطاتها عن التنقيب في المكتبة، لذا ما إنْ يُفتح قوس روايته على أي كتاب حتى تتداعى إلى ذهنه صور عدد من الأشخاص الذين كان لملاحظاتهم دور في نضجه الفكري، والإدراك بأنَّ هناك كتباً يصعبُ عليه النهلُ من مخزونها الثرى مباشرة، بل يستدعي الأمرُ التدجُج بخلفية ثقافية قبل البحث عن موطئ القدم على الأطلس الفكري، والحال هذه يعترف حسين بأنَّه قد استفاد من ترشيحات محمد سلمان لإيجاد مدخل إلى تربة الفكر الاقتصادي. كما يضيء له العلامة علي جواد الطاهر بتعليقاته على طه حسين، سقراط، أفلاطون، أرسطو، هوميروس مناطق جديدة في الفكر والأدب، وينفعه جبر إبراهيم جبرا بدرس ثقافي بليغ بأنَّ بعض الكتب المملة هي نتاج لعزلة صاحبها ومعاناته في سبيل اكتشاف نفحة عبقرية، يتحولُ العمل من خلالها لأيقونةً إبداعية. أكثر من ذلك يكتسبُ المقيمُ في المكتبةِ مهارة الترويض للأعمال الملحمية إذ يعاود قراءة رواية «البحث عن الزمن المفقود» التي يعتبرها نابوكوف فعلا إيمانياً بآلية مختلفة، ولا يستعجلُ في إكمالها، إنما يتابعُ بالبطء وقائع عالم بروست، ضف إلى كل ما ذكر آنفاً أنَّ علي حسين يستهويه الحفرُ في حياة الكُتاب، الذين صحبهم على امتداد مسيرة تكوينه المعرفي، مباغتاً القارئ بمعلومات غير مألوفة عن بدايات أقطاب الفكر، ويخبرك بأنَّ جاك دريدا أراد أن يكون لاعبَ كرة قدم محترفاً، غير أنَّه سرَعان ما تخلى عن هذا الحلم لأنَّه لم يتفوق في ذلك كما يكفي. وينقل عن ماركيز بأنَّ التفكير في رواية «مئة عام من العزلة» قد استغرق أربع عشرة سنةً قبل أن يشرع بالكتابة معتكفاً عليها ثمانية عشر شهراً، ونواة كتاب «الوجود والعدم» لسارتر كانت تلك الملاحظات التي قد سجلها في دفتر صغير أثناء أيام الحرب. والطريف عندما سئل سارتر وهو قيد أغلال الأسر، عمَّا ينقصه؟ أجاب فورا هيدغر، هكذا لا يقف علي حسين عند حافة الأفكار المجردة بل يرحل بالقارئ إلى لحظة انشقاقات بعض المفكرين عن المظلة الأيديولوجية والسجالات الحامية بين الأصدقاء ومن المناسب الإشارة إلى ما ورد في الكتاب من ردّ جوزيف برودون على كارل ماركس، حيثُ يحتجُ على الأخير مطالباً بالكفِ عن التبشير بعدما تم إعلان الحرب على العقائد. قبل أن يقفلَ قوس الكلام من المهم التذكير بما تناوله علي حسين ضمن حلقات مؤلفه عن حياة آلان باديو ورأيه الصريح بأنَّ الفلسفة التي لن تكون ميتافيزيقا للسعادة ليست جديرة بمكابدة العناء في أروقتها.
مجمل ما يمكنُ قوله عن الكتاب أنَّه يكسر الحاجز النفسي بين القارئ والأعمال والمشاريع التي ذاع صيتُ أجوائها المملة.
*القدس العربي