خالد نعمة
يبدأ الراوي بفرد أوراقه من شقته البرلينية في إحدى الأمسيات الكانونية، بينما هو يدخن غليونه جلوساً أمام لوحة لامرأة في وضعية مثيرة ملتقطة في تسعينيات القرن الماضي، حسبما يظهر من طراز الحاسوب المبين فيها، فالتدخين يساعده على التفكير.
البطلة الأولى في القصة هي المصورة (كريستا)، التي سبق أن أهدته اللوحة، والتي سبق لها أن ذهبت برحلة محفوفة بالمخاطر إلى كولومبيا لاستكشاف مناطق بعيدة عن الحضارة وعوالم مجهولة، فتعاني فيها عقابيل عضة حشرة حريش الأمازون، ولتعود بذخيرة من صور بقيت غير منشورة بسبب تغير اهتمامات ملتقطتها، وتحولها إلى المسرح.
ومن حيث لا ندري يدخلنا السارد بسرعة إلى صفحة من رواية (الحارس في حقل الشوفان) لـ(سالنجر)، ثم يخرجنا منها بالسرعة ذاتها، تاركاً لنا فضولاً كي نضعها ضمن مشروعات القراءة المستقبلية.
ثم يخرج بنا إلى ضفاف نهر (هافل)، ليمتعنا بمرأى السفن والبط بينما هو يقضم الكرواسان على مقعد. ودون سابق إنذار يحدثنا عن (شبانداو) منطقة سكناه، التي صارت جزءاً من العاصمة رغم إرادة أهلها بالتصويت لصالح بقائها بلدة منفصلة، وعن هدوئها وناسها وجدران بيوتها غير الكاتمة للأصوات، بحث يستطيع سماع صوت جريان المياه في حمام جارته التي لا يعرف اسمها، وإن كان يعرف أن أباها هو من يرعى قطها في غيابها. وفي مجرى سرده يذكر لنا الاختلافات بين واجهات الأبنية، كما في منطقة (شارلوتنبرغ)، كأثر ثانوي للحرب العالمية الثانية، التي تسببت بتدمير نحو ستمئة ألف شقة في برلين وحدها.
ومن خلال رجل يحتسي البيرة على قارعة الطريق، نتعرف على (بيكس) الماركة التجارية لأحد أنواعها، ومن ملصق على عمود إنارة يخبرنا السارد بأن التقاط براز الكلاب من الشوارع بأكياس بلاستيكية سوداء للتخلص منه هو واجب أصحابها.
في جولته الشبانداوية يحدثنا الراوي عن كنيسة القديس نيكولاي، وعن ملجأ ساحة فولدريش، وعن ارتياده هذه الكنيسة أسبوعياً أيام الخميس للاستماع إلى موسيقا الأورغن.
وفجأة يستقل راوينا قطار الأنفاق ليذهب إلى بيت كريستا، التي لم تكن في منزلها، فتستقبله أمها (هيلدا)، التي تعاني عقابيل جلطة دماغية سابقة تؤثر على تحكمها بنفسها، لذلك يتصرف الراوي في حضورها وكأنه في بيته هو. ومن خلال تتابع السرد نعرف أن الابنة في موعد مع أحد الموسيقيين من أجل مسرحية (كلهم أبنائي) لـ(آرثر ميللر) المكتوبة في حقبة المكارثية ومناهضة الشيوعية، المسرحية التي تنتقد الحلم الأمريكي، وكان (إيليا كازان) أول من أخرجها، في حين تستعد هي لتعيد إخراجها، ثم يستدرج الراوي الأم كي تتحدث عن معايشتها للحرب، فنعلم منه ومنها أنها قد ولدت في عام صعود النازيين إلى السلطة، وأنها لم تشعر بآثار الحرب إلا بعد أن وصل لظاها إلى مدينتها في العام 1944، وعن أحوال الناس في تلك الفترة وأجواء الرعب التي عاشوها في ظل القصف، وعن الموت والدمار والجرحى والطوابير للحصول على الطعام، وعن الخشية من اقتراب الجنود الروس ذوي السمعة السيئة، سمعتهم التي سبقت مجيئهم وتصرفاتهم المخيفة، وعن شائعات سلبهم لأموال الناس واغتصابهم للنسوة اللاجئات إلى الأحراش، وعن تبخر أعضاء الحزب النازي وقوات الشرطة عشية هزيمة النازية.
بعد استعادته لتجليات حرب كارثية على المدينة وتناوله للطعام مع هيلدا يخرج الكاتب من منزلها ليقودنا في جولة عبر مناطق مختلفة من برلين وصولاً إلى تقاطع شارعي (أونتر دن ليندن) و(فريدريش شتراسه)، ليجد من خلال الصور واللوحات الإعلانية هناك فرصة كي يحدثنا عن (زيلله) أحد أوائل المصورين الألمان، المصور الذي وثق بصوره شوارع برلين الغنية والفقيرة ولباس الناس أوائل القرن العشرين.
في جولته هذه نكتشف وجوداً لـمقهى باسم (رضا)، ومحاضرة لكاتب أردني عن الحب المثلي أغلب حضورها من المثليين العرب، ومكتبة مختصة بأدب المثليين اسمها (برينتز أيزنهرتز) اقتنى منها الراوي كتاباً عن تربية الأطفال، ليقدمه هدية لـ(كاتيا) و(أنتونيا) الامرأتين المثليتين، اللتين تحب إحداهما الأخرى حباً جنونياً، واللتين رغبتا بامتلاك طفل يخصهما، لذلك أقدمتا على أمر غير مسبوق، إذ أقنعتا (توماس) شقيق أنتونيا بالنوم مع كاتيا، كي تحمل منه، فلا يكون ابنهما ابناً بالتبني، وكان ما كان من ممارسة جنسية ثلاثية الأركان، الممارسة التي سار الراوي عميقاً في وصفها بالتفاصيل غير المملة.
ثم يعود بنا الكاتب إلى مقهى رضا، ويحدثنا عن صور المشاهير التي تزين حيطان المطاعم والمقاهي والبارات التي عرفها، ويجري مكالمة مع كريستا التي سبق له أن حضر إحدى بروفات مسرحيتها. وبعد ذلك يأخذنا باتجاه (بانكوف) وتحديداً إلى الشارع المهم (شونهاوزر أليه) في منطقة (برينتسلاوربرغ)، التي كانت بؤرة للثقافة المختلفة في برلين الشرقية، والتي هجرها سكانها الأصليون بعد انهيار جدار برلين، السكان الذين سبق أن عانوا الطغيان، ورخصت أبنيتها كثيراً بعد أن شغرت من ساكنيها، فاشترتها الشركات، لتعيد تأجيرها للشباب الغربي التواق إلى اليوتوبيا، ومن ثم للشبان الثائرين الذين هجروها، إنما بأجور أعلى.
ومن خلال أحاديثه عن زيارته لكاتيا وأنتونيا، يعلم القارئ أنهما قد رزقتا بابنة اسمها (آلاين)، وعمرها زمن القص عدة أشهر، وكيف تتقاسمان العناية بها، ويصير بإمكاننا أن نعرف شيئاً عن فيلم (دوغ فيل) من إخراج الدنماركي (لارس فون تريير) وبطولة (نيكول كيدمان)، حيث يتحول العمل المجاني لقاء الأمان إلى استحواذ وعلاقة أسياد وعبيد، ثم يأتي انتقام لا بد منه ينتهي بقتل البطلة لحبيبها بطلقة في رأسه.
كان التعارف الأول بين الراوي وهاتين الفتاتين في بيت كريستا، وتطور بعد حضورهما لقراءة له في ناد أدبي عن أجواء الحرب في حلب، وبعد إعلانه عن رغبته بكتابة رواية تجمع بين طياتها معاناة أهل مدينتي برلين وحلب في ظروف الحروب. ومن الحوارية الدائرة، نفهم أن ابنة السارد ما تزال بخير في حلب، وأن كاتيا طبعت بضع صفحات من يوميات جد أنتونيا، التي أثارت اهتمام الكاتب، ففيها تفاصيل دقيقة عن أولى طلقات المدفعية الروسية على قرية (كاروف) في منطقة بانكوف، وعن قبر الزوجة الذي صار حصناً لأوراقه المهمة، وعن سير المعارك، وتتالي سقوط المناطق، وعن الحفر في جدران المنازل للانتقال من مكان إلى آخر والهروب الآمن، وعن القصف الشديد من الطيران والجثث المرمية في الشوارع والناس الذين يفترشون الأرصفة، وعن صعوبات تدبر أمر الطعام، وعن دفن القتلى في الحدائق العامة وجنائن البيوت، وعن تبخر إيمانه بقوة بلاده، وعن حصوله على دراجة صالحة من اثنتين محطمتين، وعن كيف غرق ما تبقى من رجال ألمان في شرب الـ(شنابس) بينما تسلت نساؤهم مع الجنود الروس، إذ ليس باليد حيلة، وعن بيوت مستباحة ومحطمة، وعن عائلة هجرت يجري البحث عن أفرادها دون أن يتكلل بحثه عنها بالنجاح.
الانتقال من حدث إلى آخر في الرواية يجري بوتيرة تجعل أنفاس القارئ تتقطع في سعيه إلى الإمساك بتلابيبها، فها نحن أولاء أمام ذكر خاطف لرواية (فابيان) للكاتب الألماني (إيريش كستنر) عن تدهور الحياة السياسية والاجتماعية والأخلاقية في (جمهورية فايمار)، لكن ذلك ليس إلا البداية، كي نعرف من خلال جلسة صفاء بين الراوي وكريستا في المطعم المكسيكي (تيكس ماكس)، أن غريماً للراوي اسمه (غونتر) ينافسه على قلب كريستاه، فهو حبيبها السابق الموسيقي البوهيمي المتمرد، الذي انفصلت عنه، ولم تستطع أن تنساه، مع أن لديه ابنة رسامة من ممثلة معروفة، وهو يريد من كريستا أن تعود إليه بعد أن وافق على أن يتزوجها لتنجب منه، فيكون أباً لطفلها، لأنها لا تريد لطفل تنجبه أن يعيش تجربة ابن الأم العزباء.
بوحها المؤلم كان لا بد له أن ينتهي بجائزة ترضية له، جائزة نالها كعاشق عابر في حياتها لا نصيب له بأكثر من الترضية في مخدع للعشق بعد خروجهما من المطعم وعبورهما نهر (شبريه) وتسكعهما معاً دون شعور بضخامة برلين لانشغاله بأحاديثها عن حزبي (البديل) و(الاشتراكي الديمقراطي) مع مرور بجانب متجر (إيكيا).
خسارة معركة الحب أعادتنا مع الراوي إلى أوراقه وصوره التي التقطها في حلب القديمة، بينما هو يتنقل من غربها حيث يسكن إلى أحيائها الشرقية حيث تسيطر الفصائل المسلحة لمعاينة الدمار الذي لحق بالمدينة، مع كل ما يرافق ذلك من مخاطر القناصين وإهانات على الحواجز وابتزاز. ونتعرف من خلال ذلك على منطقة ميسلون ومدرستها الابتدائية التي درس فيها الراوي، وطريقا أقيول الفوقاني والتحتاني، ومقبرة جبل العظام، كما نتعرف على الأستاذ ممدوح القصير القامة الذي أحبه جميع التلامذة، وساحة باب الحديد وشارع بنقوسا، وحارة الباشا، وعلى بكري الكردي وصبري مدلل من صحنية جد الراوي الذي نظم جلسات شهرية للموسيقيين والمطربين الحلبيين.
ومن خلال هذه الأوراق نعلم أن والد الراوي تاجر حبوب تركز عمله في جادة جب القبة المعاكسة اتجاهاً لـ(جادة الخندق)، وأن إحدى صوره كأحد الموثقين لجرائم الحروب ملتقطة بوضعية انبطاح لحظة سقوط قذيفة على مبنى في الساحة المكتظة بعشرات المقاتلين، الذين يرتدون ثياباً مدنية ويعصبون رؤوسهم بالكوفيات، وهي الساحة ذاتها التي كانت تتحول إلى مدينة ملاهي في الأعياد الإسلامية، ونعلم من حكايته أن كشكاً للجرائد كان قريباً من البرج نهاية أعوام الخمسينيات، وأن والد الراوي كان من متابعي مجلة الأسبوع العربي والصحف اليسارية، وأن قطعة أرض صغيرة هناك شغلها بائع باع كأس الشاي بخمسة قروش والقهوة بعشرة.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد صار الراوي على صغر سنه بالمصادفة البحتة بائعاً لجرائد الكشك بعد أن أوقف صاحبه وقريب أبيه (إبراهيم) ودخل السجن. ومن خلال مهنته هذه استطعنا معرفة أن جريدة برق الشمال كانت تصدر في حلب، وأنه كان يستلمها عند مدخل المطبعة في قبو إحدى بنايات شارع القوتلي، وأن وكيل توزيع الصحف كان من آلـ(الكيالي)، وأنه كان على عاتق بائع الجرائد الصغير أن يعيل أسرة الموقوف أيضاً من ريع المبيعات.
تداعي الأفكار يجري في الرواية بوتيرة عالية، وينتقل بنا زمنياً من خمسينيات قرن إلى العقد الثاني من قرن تال، فإذ بجيش النظام يستعيد السيطرة على منطقة كانت بيد المسلحين، فيطال التدمير مناطق إضافية عند مقبرة الجبيلة وقريباً من باب النصر، التي كانت إلى حد ما سالمة قبل بضعة أشهر، ولا تنجو منه سينما السعد، التي لها عند الراوي قصص وحكايات عن أفلام وأبطال وأجواء سينمائية ذهبت ولن تعود. وفي هذه الجولة الجديدة يكتشف القارئ أن خالة الراوي (عزيزة) هي أول امرأة في المدينة حملت شهادة طب الأسنان بعد أن تخرجت في جامعة اسطنبول. وفي هذا السرد أيضاً نعيش مأساة تدمير مئذنة الجامع الأموي وسوق حي الجلوم الأثري وحرق أمهات الكتب والمخطوطات القديمة في المكتبة الوقفية وأجزاء كبيرة من أسواق الحبال والسقطية والخيش والعطارين والذهب والسجاد والخانات التي كانت المركز التجاري الأهم للاقتصاد السوري، ونعرف ماذا كان يلفت الانتباه في سوق النسوان، وماذا حصل من تخريب للمطبخ العجمي، الذي كان قصراً لأحد الأمراء الزنكيين، التخريب الذي طال أيضاً الدكاكين المختصة ببيع العطور والألبسة وقلعة حلب التي شهدت تصوير فيلم للمخرج الإيطالي (بازوليني) تحت جدران سورها.
هذه الجولة المكوكية بين برلين وحلب تتكرر كثيراً بين دفتي الرواية، وهي تظهر تشابهات في المآسي، التي عانتها المدينتان في ظل حربين لا ناقة للناس المدنيين فيها ولا جمل. ومع ذلك، كان عليهم أن يتحملوا تبعاتها وكوارثها ومشاهد الموت والخراب والتشرد والألم بسببها.
اختزال الرواية بقراءة مبتسرة فيه إجحاف بحق نص أدبي على غاية من الروعة، وفيه إجحاف أكبر بحق أديب سكب كل معاناته ومشاهداته على الورق فأبدع وأجاد، وهي لا تغني إطلاقاً عن قراءة الرواية مثنى وثلاث ورباع، ففي كل مرة يكتشف القارئ جديداً ممتعاً ومحزناً في الآن ذاته فيها، وفي كل قراءة يسوح في عوالم أخرى مجهولة، لكنها تستحق أن نعرفها بكل تأكيد.
والخلاصة
الرواية تتناول حال شخص يعاني الاغتراب، ويعيش نمط حياة رتيب في غربته مع مساحة للتأمل والتفكير، وتربطه علاقة وثيقة بالأشياء والذكريات، ويعيش مع بعض أبطال الرواية الآخرين أزمة هوية وبحث عن الذات، كما أنه يطرح التأثيرات النفسية للأحداث التاريخية على شخصيات روايته، ويصور تفاصيل الحياة اليومية الدقيقة لأبطالها، ويظهر تقاطعاً وتشابهاً للأحداث بين بلدين في ذروة كارثتين مرا بهما، ويبين أيضاً تحديات الاندماج في مجتمع جديد على ضوء التفاعلات اليومية والذكريات العميقة وتداخل ذكريات الماضي مع وقائع الحاضر ووجود فجوة بين الأجيال تعكس تباين التجارب الحياتية.
وهناك شيء على غاية الأهمية في هذه الأوراق البرلينية، ألا وهو البحث عن معنى الوجود من خلال التدقيق في حياة الآخرين وتجاربهم وتاريخهم الشخصي من خلال الحكايات الصغيرة في محادثات معهم.
وهناك جانب فيها ينبغي عدم إغفاله، ألا وهو الأثر النفسي للحروب على الأشخاص، وقضايا الرعب الشخصي من وحشيتها وهمجية المشاركين فيها، والذي يتبدى في سلوكهم اليومي أثناءها وفي طريقة تأقلمهم مع أجواء ما بعد انتهائها.
الجانب الآخر المهم في الرواية هو مسألة التنوع الثقافي والجندرة ووجود مساحة ومنبر للتعبير عن المختلف، الذي لا ينتمي إلى الأغلبية السائدة والمسيطرة، ومفهوم الأسرة الجديد الآخذ في التبلور، الذي لا يتطابق مع النمط التقليدي المعروف للأسرة تاريخياً.
كما أنه يوجد أمر آخر مهم في الرواية ينبغي الإشارة إليه، وهو أن الماضي لا يختفي بتغيير الأمكنة، بل يبقى في نفوس اللاجئين الفارين منها والناجين من كوارثها وأهوالها.
والرواية بهذا الفهم ليست مجرد قصة شخصية، بل هي شهادة على تاريخ طويل ومعقد لمجتمعين متباينين وعلى تحولات الهوية في عالمنا المعاصر.
وفي كلمة أخيرة أختم بها، فبرلين في هذه الرواية ليست مجرد مكان مستخدم للقص، بل هي رمز أساسي وحقيقي للتحولات، التي يعيشها الأفراد والمجتمعات في هذا العالم العاصف والمتغير بشدة وسرعة لا وصف مهما توسع وطال يحيط بما يجري فيه.
*****

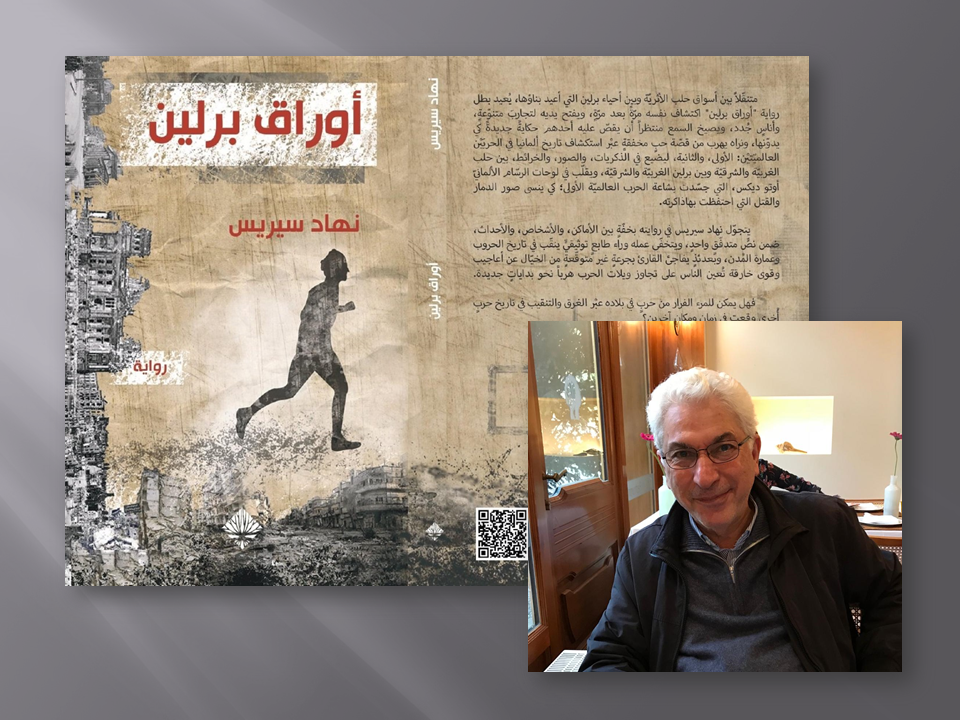



Leave a Reply