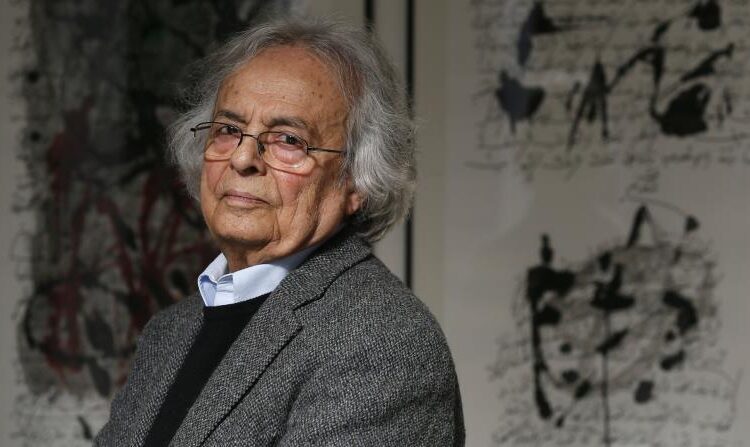بعيدًا عن ضجيج المناسبة، وضمن أهميتها الوجودية، أناقش من جديد وبرغبة غير “احتفالية” فكرة الخلافات حول تاريخ انطلاقة الثورة السورية لعام 2011، فالدخول في معركة الاصطفافات بين تحديد يوم انطلاقتها صار أقرب منها إلى حالة صراع تكاد تقفز كلماته من خلف الشاشات الإلكترونية، وتتحوّل إلى سلاح حرب يزيد من عوامل تمزقنا، ويدخلنا في نفق الانعزال المناطقي. فبعد سنة واحدة من اندلاعها، اشتعلت الخلافات فيها، وحولها، وبين مناصريها. وما يؤلم أنها اكتست بُعدًا حديًا يمكن رده إلى فكرة “مدنية الثورة أو ريفيتها”، وكأن الريف صار بعيدًا عن وعي الحريات، وكأن المدينة صارت غير حاضنة لكل أريافها ومحافظاتها السورية.
فالخلاف على تحديد تاريخ انطلاقة الثورة ليس بسبب الانتماء لضرورتها، أو أهدافها، أو مآلاتها الحتمية، بل هو خلاف على توصيف البدايات فيها، بين التمهيد والانطلاق، أو بين إرهاصات الثورة وبدايتها الفعلية، وعندما أجاهر علنًا بأنني “حورانية الثورة”، أي مع توثيق لحظة انفجار بركانها الذي لم يخمد منذ ساعتها في (18 آذار/ مارس)، فهذا لا يعني الدخول في صراع مع دمشقيي التأريخ للثورة، فدمشق مدينتي التي لا أعرف بديلًا عنها في قلبي، ولا الهدف من إعلان هذا الاعتقاد التركيز على مناطقية الانتماء، كما حاول بعض المتابعين لمنشوراتي إلصاق التهمة بي، لكن لأن منطق حكمي نبع من الحالة الجامعة لتوصيف الاحتجاجات بأنها ثورة على النظام السوري، بدأت من لحظة انطلاقها في درعا، ولم تخمد، وهي حالة توسعت حتى شملت كل سورية تحت هتاف واحد: “يا درعا حنّا معاك للموت” وربما يعود اليوم الهتاف من أجل شد أزرها في مقاومتها البطولية كسابقة تاريخية سورية لعدوان إسرائيل عليها.
أي أن شرعية حوران بالاحتفاظ بتاريخ الانطلاقة الأولى موثقة بختم كل المدن، وهذا لا ينفي أن من أراد توقيتها (15 آذار/ مارس) كان على حق، نسبة إلى شجاعة تلك الوقفات والتظاهرة الاحتجاجية في دمشق لإطلاق المعتقلين من السجون، في وقت كان فيه النظام الأسدي الأمني يطبق على أفواه الناس، نعم كان على حق من أراد أن ينسب تاريخ الثورة إلى مظاهرات دمشق، لكنه حق غير منصف لحقيقة وبطولة ودماء شهداء درعا، على الأقل كما يرى ذلك أهل درعا والمنخرطون بها في ذلك الوقت.
وهنا أريد العودة إلى الخلط الحاصل بين اعتزاز الناس بانتماءاتهم المحلية، وبين ممارسة التنمر المناطقي البغيض، سواء كانت انتماءاتهم المحلية للمدن الكبرى، أو للقرى الصغيرة، أو المتناهية في الصغر، فالأولى لا تدخل في باب التفاخر على الآخرين، والتقليل منهم، لذلك فحالة التأزيم التي يفتعلها بعض الناس بين المكونات، أو الشرائح المجتمعية السورية، وترسيم الحدود بين المحافظات على أساسها، على رغم أن كلًا منها فيه ما فيه من خليط تلك المكونات ما يمكنها أن تؤدي إلى حالة صراع مناطقي تتحول إذا امتزجت مع انتماءات عرقية، أو مذهبية، إلى صراع طائفي قد يصعب مع الوقت وقفه ومعالجة نتائجه.
فالهوية المحلية هي جزء من تنوعنا الثقافي المبني على أساسه المشتركات الوطنية، ما لم تنزلق فعليًا لتكون مصدر تفوق يبرر التنمر المناطقي، يمكنها أن تمارس دورًا فاعلًا في تعزيز العيش المشترك، على نقيض ما شهدناه من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من مدعيات التحضر السطحي في مواجهة الثقافة الريفية الثرية بعطائها وقيمها، مستخدمة الهوية المحلية كوسيلة تقسيم حضاري يستدعي إقصاء الآخرين، أو الانتقاص منهم، ما جعل الخلط واردًا في هذه الحالة بين الانتماء المحلي بصفته المؤشر على التنوع الثري، وبين التنمر المجتمعي الذي يمكن أن يكون أحد أشكال التمييز الطائفي حتى بين المنتمين إلى ذات الطائفة من شرائح ومناطق مختلفة.
محافظاتنا السورية غنية بتنوع المرجعيات الثقافية لأهاليها، وهذا يدعم الوحدة المجتمعية التي تعود لثقافة محلية سورية واحدة رغم تنوعها الإثني والديني، والرهان على تشظيها من خلال إثارة النعرات القبلية، أو الطائفية، والتقليل من شأن أحدها مقابل التعظيم لأخرى، هو عمل دوني ممارسته لا تأتي من عبث، ونتائجه تحل على المجتمع المقصود النيل منه، ولكنها تتوسع لتنال من كل المحيطين به، وخاصة في المجتمعات المتنوعة التي تمتد بين المحافظات وصولًا إلى دول الجوار وما بعدها.
ضفة ثالثة