نشهد اليوم انهياراً في المبادئ والمسالك في العملية الديمقراطية، كونياً. فكثير من الدول التي كانت تشكل الديمقراطية عموداً أساسياً من أعمدة الحكم فيها، تسجل اليوم انحداراً ملموساً في فهم الديمقراطية كما في ممارستها. الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، هي في طور التحول من نظام الديمقراطية -على علاته- إلى نظام التسلطية. وإن كانت الملاحظة كذلك، فهذا لا يعني انعدام إمكانية العودة إلى الوراء. ويصف عالم السياسة الأميركي ستيفن ليفيتسكي النظام القائم في واشنطن منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بالتسلطية التنافسية. إذ يقوم النظام الجديد بالحفاظ على مؤسسات الدولة الديمقراطية. بالمقابل، المضمون الديمقراطي المجرد يتراجع الإحساس به والاحتكاك به، بشدة. هناك أيضاً تنافسية ديمقراطية يهيمن على مجرياتها القائمون على الحكم، ويجعلون كل نتائجها تصب في صالحهم.
عند فشل أو إفشال العملية الديمقراطية، لا تتحول الدول والأنظمة السياسية من الديمقراطية إلى التسلطية بشكل فج ومباشر. فعلى الرغم من المحافظة مبدئياً على دستور مقبول، وعلى الرغم من استبعاد اللجوء إلى استعراضات قوة مسلحة في الشوارع، وعلى الرغم من عدم العمل على منع أحزاب المعارضة أو حظر مشاركتها في العمل العام، وعلى الرغم من قيام هذه الحكومة التسلطية بتنظيم انتخابات متنوعة تشارك فيها المعارضة، بما أرادته من أحزاب ومن تيارات سياسية بعيدة كل البعد عن عقيدة الحاكم المتسلط الجديد، إلا أنها تبقى على ثقة تامة بسيطرتها الكاملة والمستدامة على جميع المفاصل الأساسية في العمل السياسي. وكذلك تعزز من هيمنتها على الشأن العام والسياسات العامة في مختلف مفاصل الدولة.
وبالعودة إلى التجربة الترامبية في أميركا اليوم، والتي تعجب بعض العرب، فإنه من الضروري ملاحظة قيام الرئيس دونالد ترامب وحكومته بتعيين أشخاص غير متخصصين في الحقول التي يشغلون مناصبها، بل يكفي أن يكونوا مقربين عائلياً أو مالياً من أسرة ترامب، في مواقع حساسة ومفصلية، كما في القضاء وفي الاستخبارات. هم إذن يطبقون مبدأ الولاء المطلق، حيث لا يتوفر الحد الأدنى من الكفاءة، كما في القرون الوسطى. وفي الوقت ذاته يسعى مقربون وموالون إلى بذل الجهد والمال في التضييق على عمل وسائل الإعلام. وهم يلجؤون إلى وسائل عدة -قانونية أو غير قانونية- محاولين حصر ملكية وسائل الإعلام المؤثرة بين أيدي المطيعين لشاغل البيت الأبيض. وفي الإطار نفسه، فهم يبحثون عن إخضاع الجامعات والمعاهد العلمية من خلال التأثير المالي والضغط السياسي. وأخيراً، يحاولون أن يهيمنوا على الفاعلين في المجتمع المدني. فتصبح مواجهة السياسة الترامبية، بكافة أبعادها ومساوئها المحلية والعالمية، مسألة صعبة جداً من حيث كلفتها المالية العالية وتأثيراتها الإعلامية المدمرة.
فإذا أجريت مقارنة سريعة مع أنظمة تلبسها تهمة التسلطية أو أحادية القرار أو يمينية التطرف، إن كان نظام فيكتور أوربان في المجر، أو نظام ناريندرا مودي في الهند، فسوف يتفوق عليهم دونالد ترامب بكل تأكيد. إذ يكفي أنه يستهزئ بسلطة القضاء ويرفض قراراتها، إضافة إلى قيامه بشكل متكرر بالتهكم على القضاة وعملهم. وفي إطار أي نظام ديمقراطي تقليدي، فإنه من الطبيعي أن يتسنى للمواطنين التعبير بحرية عن آرائهم، مهما كانت مناقضة لآراء وقرارات السلطة القائمة. ومن الأحرى بقادة المجتمع الفكريين والثقافيين والفنيين والعلميين أن يشعروا بهذه الحرية. هذا الشعور غائب عموماً عن ممارسات النخبة الأميركية غير المتطابقة عقائدياً مع الفكر -أو اللا فكر- الترامبي المهيمن. اليوم تشعر هذه النخب بالخوف والقلق على مواقعها. فصار من السهل نسبياً استبعاد رؤساء الجامعات ومدراء المؤسسات وحتى العاملين في القضاء المحلي والفيدرالي، وذلك بمجرد أن يعبروا عن آراء لا تتوافق مع تلك التي يتبناها ترامب وجماعته. اليوم، كثير من عمداء الكليات وكذلك رؤساء تحرير الصحف وحتى الطلبة، يجدر بهم أن يحسبوا حساباً للنتائج الوخيمة المترتبة على مواقفهم المعلنة وأثمانها العالية.
من جهة أخرى، يبدو من الصعب على إدارة ترامب -ولو رغبت- القيام بتعديل الدستور الأميركي. في حين اشتهرت الأنظمة التسلطية بسهولة القدرة على تعديل دساتيرها، بل على إيقاف العمل بها من دون أية عوائق. وتتأتى هذه الصعوبة من حاجة القائمين على تعديل الدستور للحصول على أغلبية ثلثي الغرفتين في الكونغرس. وكذلك على 3/4 الولايات يجب أن تصدق على هذه التعديلات. وتبقى إمكانية وجود فرصة لكي يفقد ترامب سيطرته الكاملة على مجلس المندوبين، من خلاله انتخابات منتصف الولاية المقبلة في سنة 2026. وفي الوقت نفسه يجب الاعتراف بأن التأييد الذي حصل عليه في الانتخابات الأخيرة لدى الجمهوريين لم يسبق له مثيل. فدائماً كانت مجموعة منهم في الكونغرس تحتفظ بهامش -ولو محدود- من الحرية في اتخاذ القرارات، بعيداً عن إملاءات الرئاسة والرئيس. إلا أن هذا الأمر صار نادر الحدوث.
رغم ذلك، فإن الحاصل ليس مصيراً نهائياً يحمل في طياته موت الديمقراطية في عالمنا الحديث. لكن يدفع العاملين في العلوم السياسية، المنطلقين من إيمان واضح بالديمقراطية كأفضل وسيلة للحكم، على إعادة التفكير بأشكالها القائمة ومحاولة استنباط حلول ديمقراطية لأزمة الديمقراطية، التي تهيمن عليها الشعبوية بمعناها الأكثر سلبية.
المدن



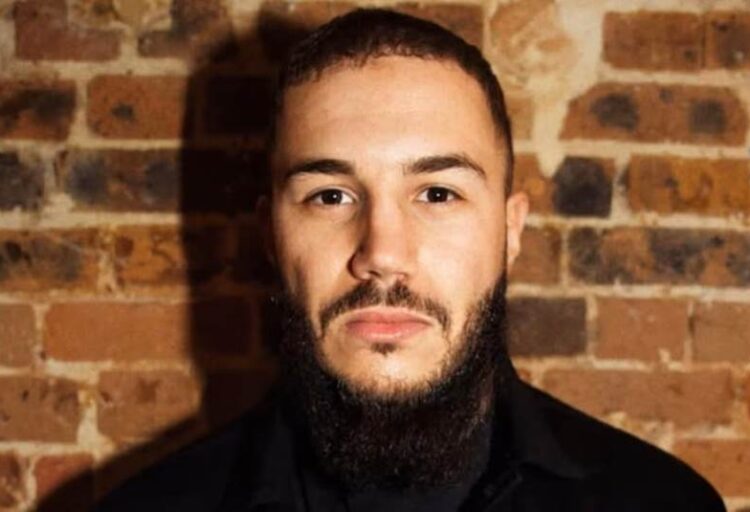
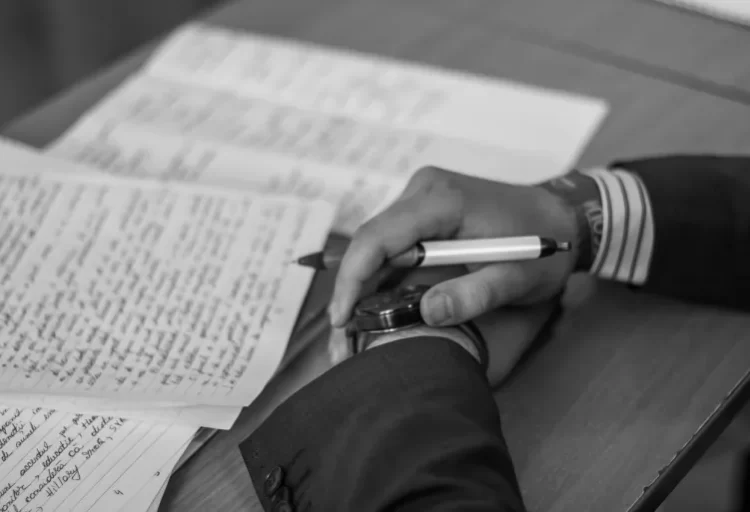
Leave a Reply