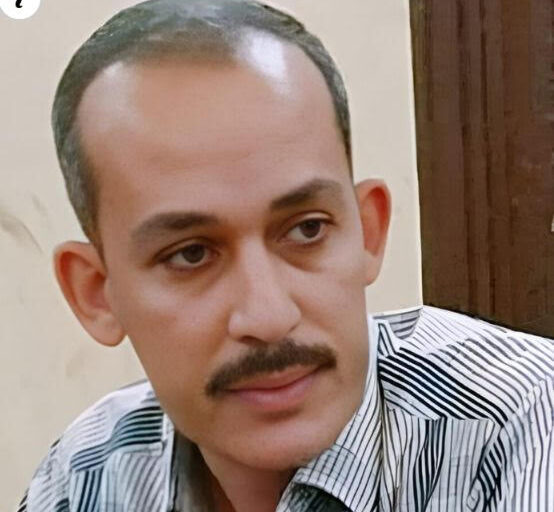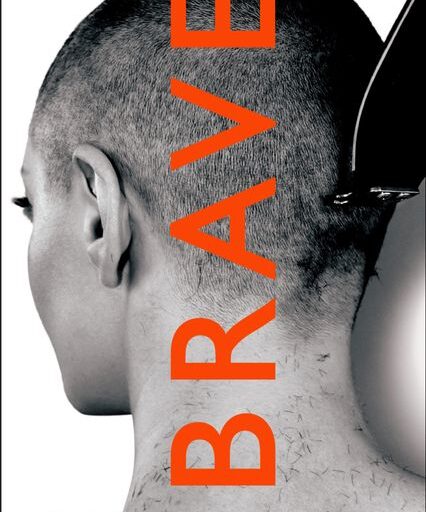أهو حلم أم كابوس؟ وفي الحالتين يتعين علينا الصحو أولا لندرك على أية أرض نقف، نفرك عيوننا قليلا، ونتذكر آخر مستجدات الليلة الماضية، نتلقط الأخبار الجديدة، ونتصل بأصدقاء ومعارف في مدن باتت حرة من النظام، يخبروننا إن كل شيء طبيعي بحدود معقولة، وحذرة، لا انتهاكات تذكر، ولا حوادث انتقام تجري، تتسرب طمأنينة باردة الى فسحة الترقب، ويرتفع منسوب الأمل في الخلاص من أعتى أنظمة الإجرام في التاريخ.
وعلى طاولة الترقب والانتظار، لم يتخيّل أحد أن الأبد الأسدي المُشادُّ على جثث السوريين، وكراماتهم، سيتلاشى سريعا كالزبد، وأن الديكتاتور الجبان سيفر مذعورا، تاركا يتاماه في حالة من الذهول والانكار، بعد أن دافعوا عنه بأرواحهم، وأرواح أولادهم، تحت شعار “الأسد أو نحرق البلد”.
كان من المحال قبل فترة وجيزة، أن نتخيل أن دمشق ستصحو بسرعة حلم عابر على نبأ سقوط النظام كما حدث؛ فجأة، لا مقار أمنية فيها، ولا جيش، وحتى عناصر الشرطة لا وجود لهم، كانت البزّاتُ العسكرية ملقاة على الطرقات، وفي حاويات القمامة، وشوهدت سيارات بيك أب حاملة للرشاشات مركونة على جانب الطريق، وكما ثكنات الجيش والأمن كانت المباني العامة ومؤسسات ودوائر الدولة خاوية على عروشها بلا بوابين، وكميات من الوثائق الرسمية والشخصية، الهامة منها والعادية، مبعثرة ومرمية في الطرقات.
وكان من المحال أن نتخيل أيضا أن صباحا كهذا سيدفع قاسيون لتنفس الصعداء، ويخفف من زيّه الرمادي الكئيب، ويخلع خوذة النظام المفروضة عليه، ويرسم شبح ابتسامة على محياه، هي ابتسامة غامضة لجبل يعرف أكثر مما يقول، شهد تواريخ تجري بحلوها ومرها، وشهد مصائر وأقدار تصاغ، وولادات عهود وأنظمة كتبت سيرتها بالسلاح والدم فور مجيئها، وحكمت شعوبها بالحديد والنار والرعب المديد. كما شهد مصائر أنظمة اخرى مرت على دمشق، وابتسمت للناس فور مجيئها فاستبشروا، وهلّلوا لها فرحا بزوال الطغاة السابقين، ليكتشفوا بعد حين أن ذئبا يختبئ خلف قناع الحمل الوديع، وأن طغاة تبدلوا بآخرين، إنْ هي إلا وجوه تبدلت!
تكرر هذا على مر التواريخ تحت سمع وبصر قاسيون الجبل الأصم الذي يحرس دمشق من جهة الغرب، ويحتضنها كأب حنون، إن تعبت تستند إليه، يواسيها، وإن فرحت سارعت إليه، ليفرح معها ويراقصها في مخيلته، ولكن همسا تداولته كائنات الطبيعة بلغاتها، أن قاسيون لم يكن مرة غاضبا وحزينا كما في العهد الاسدي البائد.
وفي صبيحة الثامن من ديسمبر 2024، التزم سكان دمشق بيوتهم بعد ليلة طويلة لم يَنمْ فيها الكثيرون، حزموا حقائبهم الصغيرة، بحثوا عن سيارات تأخذهم بعيدا عنها، الى مساقط رؤوسهم، أو مناطق اعتقدوها أكثر أمنا، صليات رصاص لا تتوقف، أصوات انفجارات متقطعة، أهو ابتهاج أم اشتباكات؟ لا أحد يدري على وجه اليقين، لكن قلة من المواطنين ممن قدر لهم أن يتجولوا فيها خلال الأيام الأولى، شهدوا الكثير من الرصاص الفارغ في شوارع المدينة.
ورويدا خلال أيام قليلة، بمزيج من الفضول، وإلحاح قضاء حوائجهم اليومية، بدأ سكان دمشق بالتعرف على المقاتلين الجدد، بسياراتهم الموحلة، وشعورهم الطويلة، ولحاهم المميزة، يحملون أسلحتهم الرشاشة، ويقفون على مفارق محددة، لا يتدخلون، ولا يسألون المارة عن شيء، غالبيتهم يافعون جدا، بعضهم لما ينبت الشعر على وجهه بعد. لا يبدو أن صدمتهم وذهولهم من الواقع الجديد أقل من غيرهم، إنهم لا يصدقون، أو حتى لا يدركون أن مفاتيح دمشق قد باتت في أيديهم، مفاتيح تلك المدينة التي توصف لعراقتها وقدمها، بانها شقيقة الزمان، وأنها والتاريخ توأمان.
فقراء كانوا، كما يدل مظهرهم، يوشك البؤس في عيونهم أن يتحدث، لهجات أفقرهم توحي بانهم قادمين من الجنوب السوري، ولا لثام على وجوههم، أما الأقل فقرا فهم القادمون من الشمال، ففي سيارتهم الموحلة شيء من الفخامة، والهيبة، يقول الوحل على سياراتهم أنهم كانوا في المعارك أو قادمين منها أو ذاهبين إليها، ويترك اللثام على وجوه البعض منهم ارتيابا “كن حذرا فانا غامض بالنسبة لك ومجهول، وثمة مسافة بيني وبينك بطول المسافة التي تصلها رصاصتي”.
إنهم يشبهوننا، هكذا عبر الغالبية من السوريين الذين تواصلوا معهم وشاركوهم اللحظة المجيدة التي أزالت عقودا من الطغيان والاستبداد واستباحة الكرامة السورية.
إنهم لا يشبهوننا، قالت أصوات أخرى لموالين، ومعارضين للنظام السابق، على حد سواء، لكن اللافت أن بعضا منها لم يكن محمولا على قاطرة الاختلاف في السياسة أو الدين، كان محمولا في المقام الأول على ازدراء طبقي للريفيين والنفور من “أشكالهم وروائحهم”، ويمتدّ هذا الرأي ليشمل طيفا واسعا من عائلات دمشقية معروفة، يتهامسون أن لا مكان لهؤلاء في صدارة الصورة الحقيقية لدمشق، ويتابعون، هل يمكن لهؤلاء الريفيين الأجلاف ان يمسكوا بعنان دمشق الحرون؟ وهل ستكون سوريا التي ينشدون إلا على صورتهم؟ وهل سيكررون سيرة أسلافهم من النظام البائد!
وبعد انتهاء الصدمة والذهول من سرعة سقوط النظام، تلك الصدمة التي أصابت الجميع معا؛ الفرحين والمتشائمين، من المؤيدين الجدد، والمؤيدين السابقين، ومن الرماديين والمعارضين الذين أدمنوا توصيفهم، ومن هواة الاستعراض وراكبي الامواج القادمة، غصت ساحة الامويين بالحشود من هؤلاء، ومن غيرهم، لم يكن الحشد متجانسا فعليا، لكنه كان سورياً بالمعنى الجديد لما يحمله الوصف، كانت اللحظة اختبارا للحرية، كان الجميع يتحدثون معا، يتبادلون التهاني يتسايرون يتجادلون، وقلة منهم يصغون، إنه الجوع المزمن للكلام العلني والتعبير عن الذات، جوع طويل وظمأ للحرية! أليست هذه هي الحرية التي نشدناها طويلا؟ اذن سأقول ما اشتهي حتى لو لم يسمعني أحد!
البندقية في ساحة الامويين، لم تكن بعيدة عن المتحاورين، لكن ظلها كان خفيف الوقع، يكاد لا يرى، لم تكن تُخيف المتحاورين، وربما جرت الحوارات الأهم مع حملتها، كانوا ودودين، بالطبع، لم يكونوا مقاتلين عاديين، كانوا نخبويين، حرصت هيئة تحرير الشام أو “الهيئة” كما شاع تسميتها، على استقدامهم، واستعانت بكادر تنظيمي يعمل بعضه في منظمات انسانية في إدلب، لتقديم انطباع حسن عن صورتها، كان انطباعا مريحا في الغالب، حتى لمعارضيه، فالحوارات تؤنسن الجميع، والحضور الكرنفالي الطارئ لحشد كبير من وسائل الاعلام يتسابق للامساك بكمية الضوء والظل في هذه الصورة التاريخية، يرصد تفاصيلها، ويتسقط كل حركة وهمسة تقال في إطارها.
ومن بين دلالاتها المتعددة، رسخت مشهدية ساحة الامويين حقيقة انكسار الأبد الأسدي، وانكسار جبروته وطغيانه، وخلع أبواب سجونه وتحرير المعتقلين، ومعاينة الزنازين الموصدة، لأول مرة منذ عقود، لتَكشُفَ عن مآسي وأهوال لم يتخيلها عقل بشري، على الأرجح، لأنه كان هو الآخر سجينا لهذ الأبد الوحشي.
ربما لا يتفق السوريون حاليا على السلطة الراهنة، ولا على تقييمها، وربما لن يتفقوا مع أية سلطة أخرى بغض النظر عن حجم الاختلاف المفترض، لكنهم باتوا أقرب إلى فهم معنى الدولة الوطنية، وأكثر حرصا وإلحاحا على ضرورة بنائها، وأكثر ادراكا لحضورهم وتمثيلهم في صورتها الكلية، تلك الصورة التي لا بد لها ان تنبثق من عقد اجتماعي جديد يجمع الجغرافيا، ويخفف عبء التاريخ، ويوحد الأقدار والمصائر لأفرادها ومكوناتها، ويرسم خريطة المستقبل لأبنائها السوريين.