أن تصير سورية وطنًا، يعني أن يصير السوريون شعبًا. وأن يصير السوريون شعبًا يعني من حيث الماهية أن يتواجدوا مَعًا في إطار الكينونة، وأن يتعيَّنوا مَعًا بوصفهم مَصيرًا واحدًا؛ فـ”الشعب كينونة في العالم”_بتعبيرات مارتن هيدغر.
الوطن قرار لأن الشعبَ قرار، والوطن إرادة لأن الشعبَ إرادة، والوطن جميلٌ لأن الشعبَ مسؤوليةٌ أمام “المصير” العميق للذات بعيدًا عن أي مزعم عرقي أو مذهبي أو ديني؛ فما يميز الشعب هو “طابع القرار” التاريخاني إزاء مصيرنا_والتعبير أيضًا لهيدغر.
ولأن نيَّات السوريين جميعهم تجتمع في أن تكون سورية وطنًا لهم، ولأن سورية ما زالت “وطنًا بالنيّات”؛ فإن الحاجة إلى سورية/الوطن، هي الحاجة نفسها إلى مفهوم شعبها، ومن ثم هي الحاجة إلى تكوينه (أي أن يصير الشعب السوري كينونةً في العالم). وما أن نصير كينونة حتى نصبح قرارًا وإرادةً عامة، وعندها فقط تصبح قراراتنا مُلكنا، وتفقد الدول قدرتها على الفرض أو الإملاء في أي جزءٍ من سورية، ومن ثم تلجأ إلى التفاوض والحوار النِّدي. وبوجود هذه الندية فقط، يصح أن ننطلق من الأخلاق_كما تعودنا غالبًا أن نفعل منذ بداية الثورة_ لنضع قضيتنا، ونطرح قيم وتوجهات الثورة السورية أمام العالم.
وهكذا نصل إلى السؤال الآتي: كيف نصير كينونةً في العالم؟. أو يمكن أن نطرح السؤال نفسه بشكلٍ آخر: كيف نصير شعبًا؟ وشكل ثالث أيضًا: كيف تصير سورية وطنًا؟.
لا نجزم أن لدينا إجابة عن هذا السؤال، ولكن ندعي أن طرحه لا يقل أهميةً عن الإجابة عنه. ومن أجل التفكير في معنى أن يطرح السوريون هذا التساؤل، ننطلق من المقاربة الآتية: لنصير كينونةً في العالم، لا بد من أن نَعبُر من مرحلة سابقة هي “صيرورة كينونة” في سورية، أو لنقل أننا يجب أن نعيش في رحمٍ ما، ثم نخرج منه كينونةً موجودة؛ ففي الرحم التَشكُّل والتمايز، وخارج الرحم_ولكن من خلاله_تكون علامات الوجود الأخرى كلها. يعني ذلك أن الكينونة السورية تبدأ بالولادة، والولادة إعلان اكتمال الكينونة السورية في رحمٍ ما، أو هي إعلان تأهيلها لتصير كينونةً خارجه، ثم تنمو رويدًا رويدا. فما هو الرحم الذي يحتضن كينونتنا ويؤهلها للحياة؟.
الرحم كناية عن مكانٍ لـ”صيرورة الكينونة”، ولكنه ليس أي مكان بل هو مكانٌ_كَون (ولا نقول مكان كوني). أي أنه مكانٌ بمواصفاتِ عَالَم؛ فنهاية الرحم هي نهاية الكون من منظور الجنين، لذلك لا يعود الرحم “حيزًا” من منظوره، بل فضاءً كاملًا كافٍ لأفعال الصيرورة كلها، من دون الحاجة إلى الخارج أو حتى الالتفات لوجوده؛ ففي شريعة الأرحام تتطابق أفعال الصيرورة مع أفعال الوجود. ولا تؤثر الأصوات التي تأتي من الخارج، في عملية التمايز_بما فيها صوت الأب. نريد أن نقول أن دور الخارج في مرحلة الصيرورة يجب أن يكون صفرًا، وأن يكون الفضاء السوري كونًا كاملًا كافيًا وكبيرًا غيرَ منتهٍ بالنسبة للشعب (الجنين).
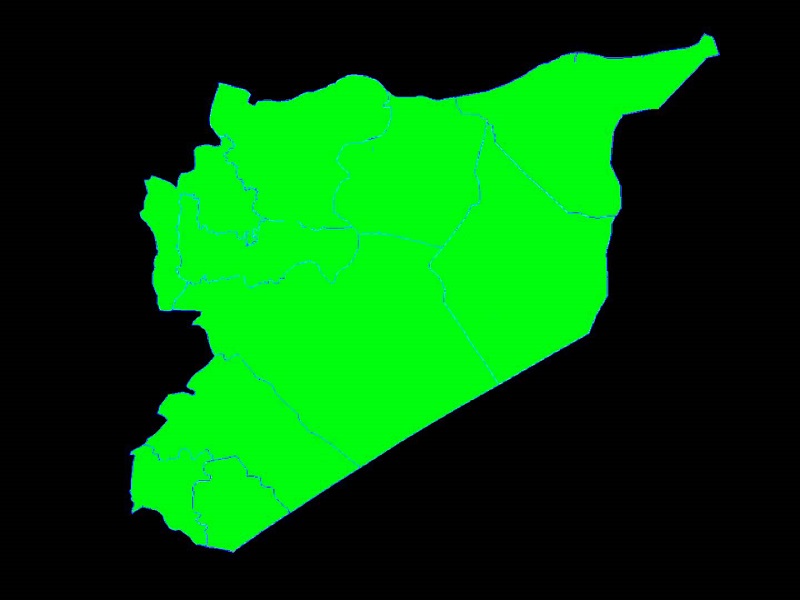
وليس الرحم كناية عن مكانٍ_كَونٍ فقط، بل هو أيضًا كنايةٌ عن وظيفة: وظيفة التشكل والتمايز. ولا تتم هذه الوظيفة على مستوى “صيرورة كينونة الوطن”، من دون الحوار العمومي الذي يحتضن تشكل وتمايز الكينونة الوطنية، كما يحتضن رحم الأم تشكل وتمايز الجنين. وبهذا الشرح للمُكنى به، والمُكنى عنه، في كلٍ من الكِنايتين يمكن أن نقول من الأولى: أن الرحم كناية عن “فضاء”، ومن الثانية: أنه كناية عن “العمومي السوري”. ونستخلص أن “الفضاء العمومي السوري” هو الرحم الذي يحتضن صيرورة الكينونة السورية. ولأن الأمة هي التعبير الثقافي عن مفهوم الشعب، وهذا الأخير هو المعادل السياسي لها، ولأن الثقافي سابقٌ على السياسي في سورية، لذلك سنغامر بالقول بأن الفضاء العمومي السوري هو رحم الأمة السورية، وهذه الأخيرة هي أمُ الشعب، وهي لا تأخذ صفة الأمومة إلا إذا أصبح الشعب كينونة (أي فقط إذا صار السوريون شعبًا وصارت سورية وطنًا).
العمومية مرادفة للعلانية، ونقيضٌ للباطنية، لذلك هي مَنضَجَةُ الوطنية (آلةٌ لإنضاج الوطنية). وتخلق العمومية لنفسها فراغًا غير منتهٍ للحوار تلبيةً لحاجتها إلى الحوار العمومي. وليس العمومي خروجًا من الخاص إلى العام، عبر تكوين رأي عام مثلًا، ولكن مفهوم العمومي يتعدى كل ذلك إلى مجموعة النقاشات العامة المفتوحة الحرة والعلنية، والتي تعترف بالجميع. وعلنية هذه النقاشات والحوارات هي بالتحديد ما تكسبها صفة العمومية، ومن ثم هي ما يحدد الفرق بين الحوارات العمومية(Public) والحوارات العامة (General).
لدينا ميل إلى طرح المقاربة الآتية:
“الفضاء العمومي هو رحم الأمة الذي فيه يتشكل مفهوم الشعب ومن ثم الدولة الوطنية، وهو الفضاء الذي تعمل المشاركة الديمقراطية ضمنه، وفق صيغتها التواصلية، على إنتاج رأس المال الاجتماعي الوطني، الذي يعني تراكمه تعزيز بعدها القيمي والأخلاقي ورسوخ جذورها وثقافتها. ويصبح رأس المال الاجتماعي الوطني هو الوصفة التي لها التأثير العجيب في استهلال وتمكين قدرة الديمقراطية المدهشة في تحويل نفسها من نظرية إلى واقع”.
تكوين ومراكمة رأس المال الاجتماعي هو حصيلةٌ لتقوية شبكات الثقة التي يبنيها البشر فيما بينهم، من ثم يمكن استثماره لخدمة الهدف والغاية الوجودية التي تحددها الجماعة لنفسها. ولرأس المال الاجتماعي قوة مدهشة في البناء. وتتضاعف هذه القوة الخيرة الجميلة أكثر إذا كان وطنيًا: أي إذا كان نتيجةً للثقة التي تتكون من خلال حوارٍ صادق في فضاء عمومي يتنافر مع الباطنية ويتطابق مع العلانية والنيات الطيبة واحترام الآخر بوصفه غايةً بذاته. ويمكن أن نقول أن “رأس المال الاجتماعي الوطني السوري” هو غذاء الأُمة الذي يجعلها وَلَّادَةً للشعب الذي يتشكل فيها، وهو أيضًا المادة الأساسية التي تُشكِّل “سائل الشعب الأمينوسي” (Amniotic fluid) في رحم الأمة_وهو سائل يحمي الجنين من الصدمات ومن نفسه. ومن المُهم التأكيد على أن صفة الأمومة (كينونة الأُمَّة بوصفها أُم) ليست صالحة من دون تحقق “كينونة الشعب” (أي من دون ولادة الشعب): أمومة الأمة تشترط أن يولد السياسي من رحم الثقافي، فالشعب تعبير سياسي عن الأمة، وهو يشكل الشرط الموضوعي لقيام الدولة الوطنية التي تكون تعبيرًا قانونيًا عن مفهوم الأمة.
الأمة السورية مفهوم قائم على الثقافة السورية المبنية على التعدد اللغوي والفلكلوري والإثني والديني والعرقي، وما أن تصير أُمًا (والدةً للشعب من رحمها) حتى تتحول من مفهومٍ (أو تصور بمعنى: Concept) إلى مفهومية (Comprehensibility): بالمعنى الذي يفيد قابلية الفهم الذي يتصف به المَفهوم. ومن دون هذه المفهومية سنكون كأننا لم نكن.
تلخيص سريع للطرح كالآتي: لتصير سورية وطنًا، يجب أن يصير السوريون شعبًا، والشعب السوري يولد من رحم الأمة السورية (ذات المضمون الثقافي السوري التعددي)، هذا الرحم هو فضاء عمومي سوري، من دونه تكون الأمة عاقرًا مهما كانت غنية ثقافيًا وتاريخيًا. يحتضن هذا الفضاء الحوارات الوطنية كلها بموجب عموميته التي تفيد العلانية وتُجَّرم الباطنية، وينتج هذا الرحم لنفسه ولجنينه وسطًا هو “رأس المال الاجتماعي السوري”، الذي يشكل الوسط المُغذي لتشكل الشعب وتمايزه (سائل “الشعب السوري” الأمينوسي).
ويبقى السؤال المهم والمفتوح للتفكير المشترك: كيف نصنع الفضاء العمومي السوري؟. أو كيف نخلق لهذه الأمة رَحمًا؟.
*خاص بموقع الرابطة














