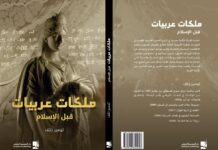يُبحر كتاب “أديان العالم”، من تأليف د. هوستن سميث، بقارئه في رحلة روحانية متعمقة نحو أديان العالم الكبرى، ليكشف عن روح كل دين، وعن جوهر الحكمة وراء فلسفته وطقوسه وتعاليمه، في لغة تخالف التقليد العلمي السائد القائم في الأساس على عرض كل دين في قالب أكاديمي صرف، بكتبه المقدسة ومعلميه ومعتنقيه ومذاهبه وتعاليمه الرئيسية ومدى انتشاره…. إلخ، والذي يكون في العادة معززًا بالبيانات والجداول والإحصائيات.
لا تأتي هذه اللغة المختلفة من هوى، أو من فراغ، إنما هي عصارة ممارسات إيمانية حيّة وعميقة لتعاليم تلك الأديان، انهمك فيها المؤلف نحو خمسين عامًا، وأخلص لها إخلاص المؤمن الحقّ. بهذا النهج المتفرّد، لا يعرض المؤلف شيئًا من آرائه، أو انطباعاته الشخصية كباحث في هذا المجال، على الرغم من اعتناقه لكل هذه الأديان، وممارسة شعائرها طويلًا فوق أراضي معتنقيها، بل جاء عرضه حياديًا بشكل كليّ. أيضًا، لا يعمد المؤلف إلى التجريح، أو التهكم، مهما حمل أي دين من معتقدات، أو ممارسات غير مألوفة قد تدعو لذلك، بل يظهر متصديًّا في بعض الأحيان ضد ما يحوم حول كل دين من أقاويل وشبهات، فيعمد إلى تصحيحها منطقيًا وفلسفيًا. وعليه، يتحلّى الكتاب بالصدق والمصداقية معًا، فالمؤلف تلقّى علوم كل دين من مصدره المباشر، وألّف مؤلَّفه بعد أن اعتنقه ومارسه!
يخصّ الكتاب في ختامه صفحتين لتسطير شيء من سيرة مؤلفه الذاتية. إنه الناسك الروحي البروفيسور د. هوستن سميث (1919 ـ 2016). وُلد ونشأ في الصين لأبوين أميركيين مسيحيين يعتنقان البروتستانتية ويعملان في التبشير، البيئة التي تفتّحت عليها مدارك العالِم الصغير نحو تنوع الأديان وفلسفاتها، وهو الأمر الذي دعاه إلى الالتحاق ببرامج الفلسفة في الجامعات الأميركية بعد عودته إلى وطنه وهو في الخامسة عشرة من عمره، ليتوّج مسيرته الفكرية بالحصول على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة شيكاغو عام 1945، ومن ثم الانخراط في سلك التدريس في عدد من جامعات بلاده العريقة. استمر في اعتناق المسيحية رغم إعجابه الشديد بالحكمة الشرقية، وقد تتلمذ على أيدي رهبان الهندوسية، ومارس الزن من خلال معلمي البوذية، وقد صرّح في إحدى المقابلات بأنه يُديم الصلاة خمس مرات يوميًا باللغة العربية منذ ست وعشرين عامًا. عمل على إنتاج سلسلة من الوثائقيات المتلفزة خلال ستينيات القرن الماضي، وله عدد من المؤلَفات في المجال نفسه، أشهرها الكتاب الذي بين أيدينا، والذي لا يزال يُصنّف عالميًا بالمرجع العلمي الأول في الأديان، وقد وصلت مبيعاته إلى المليون والنصف المليون نسخة كما تشير هذه الطبعة!
تعتمد هذه المراجعة على الطبعة الثالثة للكتاب الصادرة عام 2007 عن (دار الجسور الثقافية)، في ترجمة مباشرة للكتاب عن لغته الأصلية (The World’s Religions – By: Huston Smith) والتي عني بها المترجم د. سعد رستم، وهو أكاديمي وباحث سوري حاصل على درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية، بعد أن تحوّل في مرحلته الجامعية عن دراسة الطب البشري إلى هذا الفرع من العلوم. يعيش حاليًا في تركيا، وله إسهام كبير في ترجمة الدراسات العلمية الإسلامية، العقائدية والمذهبية.
يعرض فهرس الكتاب عشرة مواضيع رئيسية، بالإضافة إلى مقدمتي المؤلف والمترجم، تبدو أهمها على الإطلاق: (الهندوسية، البوذية، الكونفوشية، الطاوية، اليهودية، المسيحية، الإسلام، الأديان البدائية)، ويتفرّع عن كل منها عدد لا بأس به من المسائل لا تقل شأنًا في الأهمية. من ناحية أخرى، تتوافق أوجه الشبه بين مشروع المؤلف وبين أحد علماء التشريح الذي اعتاد أن ينبّه طلاب كلية الطب في أول محاضرة لهم قائلًا في بصيرة: “في هذه المادة سوف نتعامل مع اللحم والعظام والخلايا والأعصاب، وستأتيكم أوقات تبدو لكم فيها كل هذه الأشياء باردة لا حقيقة لها. ولكن لا تنسوا! إنها حيّة تتحرك”. ومن عبق تلك الروحانيات، أبثّ نفحات، وبشيء من الاقتباس بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر):
في إسقاطات لمعنى تمثال ذي أذرع متعددة تعكس رمزيًا براعة الإله الواسعة عند الديانة الهندوسية، يرى د. سميث أن فعّالية القصص والأساطير أقوى في أثرها على الإنسان من قوة القوانين والأحكام الرسمية، إذ تنطوي على قيم تنقل بقدرتها اهتمامه من العالم المادي المحيط إلى التفكر في الله وتمجيده والتضرع إليه والنظر في إبداعه… ومحبته آخرًا. من ناحية أخرى، لا يتردد المستشرق ماكس موللر في الإشارة إلى (الهند)، كإجابة عن سؤال وُجه إليه حول (الأرض) التي شهدت أعمق التأملات العقلية، وأتت بجملة من الحلول في مسائل الحياة تعني بالإنسان، وتثير كذلك اهتمام كل من درس فلسفتي كانت وأفلاطون… ولا يتردد من الإشارة إلى (الهند) مرة أخرى للإجابة عن سؤال آخر حول (الأدب) الذي صحّح مفاهيم تشرّبها الإنسان من الفكر اليوناني والروماني، وعمل من ثم على تغذية روحانيته، في سبيل حياة أكثر شمولية وعالمية وإنسانية، ليس في الحياة الآنية فقط، بل في الحياة الأبدية كذلك.
وفي الإشارة إلى الأدب، يحفل الأدب الهندي بالاستعارات والتشبيهات والصور البيانية التي توجّه أنظار الإنسان نحو “الوجود المطلق اللانهائي” في الكون الفسيح، والكامن عميقًا بين ثنايا وجدانه. تقول إحداها: “إننا مثل شبل أسد فقد أمه بعد ولادته، فعاش صدفة بين مجموعة من الخرفان، فصار يرعى ويأكل العشب معهم ويثغو مثلهم، ظانًا نفسه خروفًا كأقرانه! إننا مثل العاشق النائم الذي يحلم في منامه أنه يجوب الدنيا بحثًا عن حبيبته من دون أن يجدها، غافلًا عن كونها مستلقية على الفراش إلى جانبه”. وهو لا يزال في هذه الأجواء، ينتقد د. سميث ربط التماثيل الهندوسية بمعاني الوثنية، أو الشرك، أو تعدد الآلهة، بل يعتقد بأنها مسارات تتنقل خلالها الحواس البشرية نحو “الأحد”، أو “تطير من الأحد نحو الأحد”. ويضرب في هذا مثلًا بكاهن القرية الذي يعتقد بأن حدود إمكانياته البشرية تسببت له بثلاث خطايا يرجو غفرانها، فيفتتح صلواته بدعاء: “يا رب! اغفر ثلاث خطايا ناجمة عن حدودي البشرية… أنك في كل مكان لكني أعبدك هنا… إنك من غير شكل ولا جسم، ولكني أعبدك في هذه الأشكال… أنك لا تحتاج إلى الثناء والمديح، ولكني أقدم لك هذه الصلوات والتحيات… رب! اغفر ثلاث خطايا ناجمة عن حدودي البشرية”.
وعن قوة الاعتناق، ينافس الهندوسي (سوامي) نظيريه البوذيين (دائي) و(لائي)! ففي حين سيواصل الأخيران المقرفصان تأملهما اليوم ساعة استيقاظهما في الثالثة فجرًا حتى الحادية عشرة ليلًا بغية سبر أغوار بوذا داخلهما، سيواصل الأول تأمله الذي بدأه منذ خمس سنوات مقرفصًا صامتًا في قعر داره الواقع فوق قمة جبل الهملايا، مستثنيًا ثلاثة أيام في العام يتحدث فيها. وفي هالة النور نفسها، وعن أولئك الذين ترقوا روحيًا في مراتب من الإدراك والوعي والتجلي، تأتي سيرتهم لتعكس نموذجًا أسمى في النوع الإنساني… فهم حكماء، متحررون، أقوياء الشخصية، فائقو السعادة، ما من شيء في الحياة كفيل بأن يعكّر صفوهم العقلي، أو يُقلق طُمأنينتهم، أو يقودهم إلى الصراع، أو يأسرهم، أو يُرعبهم، أو يُحزنهم… إنهم مبتهجون على الدوام، يجودون على من اختلط بهم بأنوار من قوة وطُهر وانبساط. لذا، ومن طرف آخر، يتصدى أحد اللاأدريين ليناكف أحد الهنود المتنورين بأنه كان سيجعل للصحة عدوى بدل المرض… لو كان ربًا! فيفحمه الأخير بأن الشكّاك لا يمكنه استيعاب أن الفضيلة هي فعلًا معدية للرذيلة، والسعادة معدية للتعاسة… كما العدوى بين الصحة والمرض.
تتجلى معاني الوحدانية الإلهية في ترانيم الطاوية، فـ: “هناك كائن رائع وكامل… وُجد قبل السماء والأرض… كم هو هادئ… وكم هو روحي… يبقى وحيدًا لا يتغير… يوجد قريبًا وبعيدًا… هنا وهناك… ومع ذلك فهو لا يعاني من هذا التواجد… يلف كل شيء بحبه كثوب يغطي كل شيء… ومع ذلك فلا يدّعي شرفًا، أو مقامًا، ولا يطلب أن يكون سيدًا… أنا لا أعرف اسمه، ولذلك اسميه (طاو) الطريق… وأبتهج بقوته”. وفي لغة صوفية تحلّق بعيدًا عن رحب ميدان رياضة اليوغا، وتتقاطع مع العشق الرومي، تنساب الوصية عذبة بأن: “كل ما يجب علينا فعله في هذه اليوغا أن نحب الله حبًا جمًا، لا مجرد أن نقول بلساننا إننا نحب الله، بل نحبه حقًا، ونحبه وحده، ولا نحب شيئًا غيره إلا لأجله، ونحبه لذاته لا لغرض آخر، أو هدف أبعد، حتى ولا انطلاقًا من الرغبة بالخلاص والتحرر، بل نحبه للحب فقط. نجاحنا في ذلك يمنحنا بهجة وسعادة، لأنه ما من تجربة يمكن أن تقارن بتجربة من يعيش حبًا تامًا صادقًا. علاوة على ذلك، كلما قوي تعلقنا بالله واشتد حبنا له، كلما ضعفت سيطرة العالم علينا. نعم قد يحب القديس العالم، بل هو يحبه فعلًا أكثر من محبة المدمن له، لكن حبه للعالم يختلف تمامًا عن حب الآخرين له. إنه يحبه لأنه يرى فيه انعكاسًا لمجد الله الذي يعبده”.
تتجلى معاني الصيام الإسلامي في الانضباط الذاتي وكبح الشهوات، وفي تذكير الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى الله. كما يولّد لديه الشعور بالشفقة والإحساس بالآخرين، إذ لا يشعر بالجوع إلا من جاع فقط، ومن راضَ نفسه على الصيام تسعة وعشرين يومًا يكون أكثر تسامحًا وتفاعلًا مع من يقصده من الجائعين. وفي استنباط لافت للنظر، يشير د. سميث إلى كلمة (القراءة)، كمعنى مشتق لكلمة (القرآن)، وبأنه الكتاب الأكثر تلاوة وحفظًا وتأثيرًا على مستوى العالم. فلا عجب أن يكون (معجزًا) كما سمّاه نبيه وأتباعه من بعده. وفي الحديث عن اللغة العربية، يقول د. سميث مقتبسًا عن أحد المفكّرين: “لا يوجد شعب في العالم تحركه الكلمات، سواء المقولة شفهيًا، أو المكتوبة، كالعرب! من النادر أن يكون لأي لغة في العالم تلك القدرة على التأثير على عقول مستخدميها كالتأثير الذي لا يُقاوم للغة العربية”. ثم يُعقب بدوره قائلًا: “يمكن للجماهير في القاهرة، أو دمشق، أو بغداد، أن تُلهب مشاعرها وتُثار إلى أعلى درجات الإثارة العاطفية ببيانات، إذا ما تمت ترجمتها تبدو عادية”.
وفي الختام، عجبًا كيف تختلف الأديان برمتها، لكنها تصبّ انتهاءً في عبادة الله وحده التي تحقق السكينة الروحية كمطمح أزلي! إن هذا الكتاب يشحذ الفضول نحو مزيد من البحث حول كل دين، لا سيما أن الطرح يكتنفه قدر من الصعوبة قد يعود إلى النظرة التحليلية الفلسفية التي يتأسس عليها الكتاب في تناوله للأديان، أو الصعوبة المتعلقة بجوهر كل دين، أو للترجمة في بعض الجوانب. ومن جانب شخصي، لا يغفل المؤلف عن إسداء جزيل الشكر والعرفان لزوجه التي لم تدّخر جهدًا في تنقيح ومراجعة كتاب زوجها بكل سعادة، الذي لم يكن متوقعًا له تحقيق أعلى نسبة في المبيعات قبل طرحه… في لفتة شاعرية منه، بل وروحانية.
إنه كتاب غير ترويجي، ولا تبشيري، ولا مقارن، ولا نقدي، بل روحاني في الدرجة الأولى، يقدّم للقارئ خلاصة ما اكتسبه مؤلفه من معرفة وجدانية وتجارب روحانية عاش بها ولها ومعها، يجود فيه على القارئ بأنوار من فكر، وأبعاد من إدراك، ووعي وحكمة وبصيرة، وأفق أكثر رحابة، نحو تصوّر جديد للحياة وجوهر وجود الإنسان فيها، بما يحيطه من مصاعب وآلام وتحديات، وطرق مواجهتها من زوايا دينية أكثر اتساعًا من ذي قبل… لتصبّ جميعها في نهاية المطاف في فضاء الحقيقة المطلقة: (الله أحد).
*ضفة ثالثة