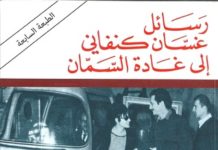.1.
على الطريق الطويل الذي قطعته السيارة بين مطار شارل ديغول ومنزل الأصدقاء الذين احتضنوا غربتنا
الطازجة، وبينما كانت زوجتي تؤكد أن لهذه القارة رائحة خاصة التقطتْها منذ لحظة خروجها من الطيارة،
رحت أتأمل ملامح أوروبا لأول مرة: البيوت ذات السطوح الحمراء المنحدرة التي طالما رأيتها في الأفلام
وطالما اعتدت على رسمها دون أن أدري كيف، الغابات الصغيرة التي تتوسط السهول الزراعية، المراعي
الواسعة المسورة حيث ترعى أبقار وخراف سمينة لا تشبه أبقارنا وخرافنا، الشجر الكثيف والعالي الذي
يحف بالطريق السريع من الجانبين، التخطيطات البيضاء المنتظمة على الطريق السريع الذي تنحني فوقه
وعلى كامل طوله مصابيح الإنارة الليلية، شمس الصيف التي تغيب قبل منتصف الليل بقليل، أنواع
السيارات التي تحيل الطريق السريع إلى نهر استعاض عن مائه بالسيارات (سمعت طوال تلك الليلة التي لم
أنم فيها، صوت نهر يهدر قريباً من البيت، في الصباح استفسرت عن اسم النهر الذي يمر في تلك المدينة،
وعلمت أنه لا يوجد أي نهر قريب، وأن هذا الصوت هو صوت الطريق السريع المجاور. للطريق السريع
صوت هدير النهر أيضاً)، المراوح العالية الضخمة التي تدور ببطء لتوليد الكهرباء، هواتف الطوارئ على
الطريق، المساحات الصغيرة نصف الدائرية المتواترة على يمين الطريق بما يسمح بركن السيارة عند
الضرورة ..الخ.
غير أن ما أسر نظري هو التمثال الضخم المنصوب إلى جانب الطريق أمام بناء أحد المعامل. هيكل ضخم
لرجل عار بكامل تفاصيل جسد الرجل سوى أنه يستعيض عن العينين بعين واحدة تقع في المنطقة الفاصلة
بين الجبين وجذر الأنف. لم تكن ضخامة التمثال ما لفتني، ولا حتى تلك العين “السيكلوبية”، بل التفاصيل
العادية فيه، التفاصيل غير المثالية. وجه مغضن بتجاعيد ظاهرة على الجبين، أنف لا يراعي أي مقياس
للجمال سوى الألفة، صدر متهدل كصدر غالبية الرجال الكهول، بطن مرتخ، خاصرتان نافرتان وهابطتان
قليلاً، قدمان كبيرتان بإبهامين ضخمين كما هو الحال لدى رجل “عادي”. إنه اعتراف أو تقدير للعادية. قالت
الكاتبة الفرنسية فرانسواز جيرو مرة: “أحب الرجال بأقدامهم الكبيرة”.
تكرر مرورنا بجوار هذا النصب فيما بعد، في الليل يبدو أكثر جمالاً بفعل الإضاءة التي تنعكس عليه من
الأسفل. اصطلحنا على تسميته “أبو عين”، وقد جعلته الصدفة في منتصف المسافة التي تفصل بيتنا لاحقاً
عن ذلك البيت الأول، فصار مركزاً لإحداثيات الطريق: “صرت قريباً من (أبو عين)” أو “تجاوزت (أبو
عين) من عشر دقائق” ..الخ.
في أواخر العام 2015، ستروا عري ذلك التمثال بلباس عمالي على شكل أفرول، كما قطعوا عنه الإضاءة
الليلية. لا أدري إن كان ذلك بتأثير الخوف الذي سببته سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في
تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ربما افترضوا أن العري يمكن أن يتسبب في استهداف التمثال وأصحابه. في
صيف 2016، استبدلوا لباس العمال بلباس لاعبي الفريق الوطني لكرة القدم بمناسبة انطلاق بطولة كأس
الأمم الأوروبية. بدا لي أن تلك البطولة كانت فرصة لستر دافع الخوف بغطاء “وطني”. احتاج الأمر لعامين
من “الستر” والتعتيم، قبل أن يتحرر “أبو عين” مجدداً ويستأنف عرض عريه وتفاصيله على عابري
الطريق السريع ليلاً ونهاراً.
.2.
على خلاف المستكشفين الذين ينطلقون عادة من المركز إلى المحيط، من بؤرة ضوء (حضارة) إلى بقاع
الأرض المظلمة، يغامرون، مسلحين بقوة تفوقهم، كي يكتشفوا وينقلوا ما تراه عين “الحضارة” في مجاهيل
الأرض من كنوز أو غرائب، كنت على خلاف هؤلاء “أستكشف” من موقع مهزوم. مهزوم كفرد من
مجتمع يراكم فشله في إدراك الحضارة، ومهزوم كفرد من معارضة سعت إلى تغيير الحال وفشلت أيضاً
وتدفع الثمن بأشكال شتى. حركتي معاكسة لحركة المستكشفين المعروفة، فهي انتقال من المحيط إلى
المركز، من بقعة مظلمة (حضارياً) إلى بؤرة ضوء، ولا شك أن شعوري لا يشبه شعورهم أيضاً. إذا كانت
رحلاتهم الاستكشافية طوعية فإن رحلتي هذه ليست كذلك. وإذا كان سلاحهم في الاستكشاف هو قوة التفوق
الحضاري، فإن سلاحي هو الضعف. نعم يمكن أن يكون الضعف سلاحاً، فهو ما يحرض في داخلي كل
طاقة للملاحظة ومعرفة الفروق. بيني وبين المستكشفين فارق هو الفارق بين رسول حضارة وطريد تخلف.
في الفترة الأولى هنا، تذكرت كلاماً طفولياً لرفيق سجن درس الهندسة في الاتحاد السوفييتي (السابق طبعاً)،
قال إنه تخيل أن يجد، حال وصوله إلى هناك، النظرية الماركسية تتدلى كالثمار من الشجر أو تنبت
كالحشيش في الحدائق، أن يصادف شذرات هذه النظرية في الشوارع وأن يراها مزهرة وخضراء في كل
مكان مثل أشجار الكرز الياباني. وجدت نفسي، مثله، أنظر إلى كل شيء في أوروبا كأنني أستنطقه عن
السر الذي يفتح باب التقدم، ها أنا وجهاً لوجه مع المجتمع الذي قرأنا عنه كثيراً وعرفنا ثقافته عن بعد،
وحلمنا باللحاق به، المجتمع الذي تصنفه الكتب في العالم الأول، بينما تصنف مجتمعنا في العالم الثالث أو
الرابع أو أكثر. تخيلت أنني يمكن أن أعثر على السر في الشارع أو في الساحات والحدائق أو في الوجائب
الخضراء بين الأبنية أو على واجهات المحلات. في كل شيء كنت أبحث عن الفرق الذي قد يفيد اكتشافه
في علاج مرضنا المزمن الذي لا يزول، في علاج الاستبداد السياسي والتخلف الاقتصادي والتمييز والعنف
وضعف اعتبار الكرامة البشرية ..الخ.
مع الوقت تراجع انشغالي الطفولي ذاك، وعدت إلى قواعدي الأولى: لا علاج إلا بالديموقراطية، هي العلاج
الوحيد والطريق إلى التقدم. حرصت على حضور أول إجراء ديموقراطي في فرنسا منذ وصولي، كانت
انتخابات الأقاليم الفرنسية في ربيع 2015. دفعتني رغبة عميقة إلى أن أتابع وأراقب المجريات، رغبت في
أن أتحسس بيدي هذا الشيء الذي ينقصنا والذي نشقى ونسجن ونموت بسبب غيابه، ونعتقد أن فيه علاجنا.
صالة واسعة فيها الكثير من الأمكنة المعزولة بستائر تضمن سرية الاختيار، وطاولات عديدة يجلس إليها
متطوعون من أهالي المنطقة، ترتيب واضح وهدوء يشبه جو الامتحان، وعلى وجوه الجميع علامات
الاعتياد. يمر الوقت ويبقى عدد الذين جاؤوا للاقتراع قليلاً، غالبيتهم من كبار السن.
كان بجانبي عجوز شيوعية فرنسية سبق لي أن تعرفت إليها من قبل، ولبيت دعوتها لحضور اجتماع منظمة
حزبها في المنطقة. عقد الاجتماع في صالة تابعة للبلدية بطاولات وكراس للاجتماع، مع مستلزمات إعداد
القهوة. غالبية المجتمعين عجائز وفقراء، الأصغر سناً بينهم تجاوز الخمسين. لا يزالون يرون في كوبا
وكاسترو ما كاناه منذ نصف قرن، ولا يزال انشغالهم يتركز على السلم العالمي و”الإنسانية”، التي اختاروها
اسماً لمجلة الحزب الاسبوعية. قلت في نفسي ربما كان هذا قاسم مشترك للشيوعيين: يكبرون ولا تكبر
أفكارهم.
سألت “الرفيقة” عن هذه الحال، لماذا لا يقبل الناس على الانتخابات، أم أن هناك من يقاطع مثلاً؟ قالت إن
الناس هنا ملت الانتخابات، يرون إنها لا تغير شيئاً. وأضافت، أنتم تموتون في سوريا من أجل هذا، والناس
هنا تفقد اهتمامها فيه. ثم استدركت قائلة إن غالبية المصوتين يأتون في المساء عادة. غير أن مشاركة الناس
في المساء لم تكن أكبر بكثير. أغلقت الصناديق، وأعلن رئيس البلدية النتائج التي تقدم بها اليمين واليمين
المتطرف. سألتها عن فوز اليمين وحلول المرشح الشيوعي في ذيل القائمة، قالت بنبرة فيها غضب ويقين،
ذلك لأنهم يسيطرون على الإعلام، (هنا أيضاً يلتمس الشيوعيون العذر لإخفاقهم خارج ذاتهم)، ودعتني
العجوز وخرجت ببطء وهي تتكئ على عكازها.
عائداً إلى البيت من جولة الاستكشاف المسائية، قلت في نفسي، يا له من عيد حين أجد السوريين وقد ملّوا
من الانتخابات التي لا تزوير فيها ولا سلبطة ولا عنف من أي نوع.
*خاص بموقع رابطة الكتاب السوريين
مجلة أوراق