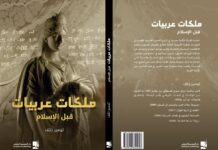تكتب الشاعرة السورية ندى منزلجي الشعر ليس بانفصال عن مجريات الذات في علاقتها بالمكان. ومن يقرأ ديوانها الأخير “بقع داكنة على ظاهر الكف”، الصادر عن دار النهضة العربية في بيروت، يجد بعض تفاصيل حياتها اللندنية، وقد تحولت إلى قصائد تضج بالحكايات التي تعيشها حباً وحزناً وفرحاً. تفاصيل تعرجت وتشعبت في كل الدروب. ويمكن للقارئ أن يتابع الحكايات من أكثر من زاوية ويشكل صورة لهذه المرأة التي تكتب كي تتنفس وتتجه بالقصيدة نحو الآخر، تخاطبه، تنقل إليه صوراً كثيرة، تراها الشاعرة بعينيها المفتوحتين بقوة، على ما هو شعري في الحياة العادية التي تعيشها أو تحيط بها، وفي أحيان أخرى تتأملها في نفسها، حينما تتراجع خطوات، لتستعيد أوقاتاً كانت تمسك بها في مكان آخر، لكنها هربت منها في الأمكنة الأخرى التي ارتحلت إليها.
في كثير من المقاطع تضع الكاميرا في الاتجاه المعاكس، ليلتقي الماضي بالحاضر في العالم الجديد المتروك لدهشة الشاعرة “لتنمو فيه عشبة برائحة مسكّرة، ليست النعناع الذي اشبعناه حنيناً، ولا حبق أمسيات البيوت الرزين”، بل “جسر العبور إلى ضفة الحب”.
“الأشجار الشاهقة التي تسلقناها بهمة
تبين لنا أنها من الأسمنت”.
حين قدمت ندى إلى لندن في بداية التسعينيات من القرن الماضي، كانت قد بدأت محاولات شعرية، يبدو منها نفس خاص لا يشبه أحداً من شاعرات أو شعراء جيلها أو الجيل الذي سبقها من بيئتها السورية، التي لم تتأثر بها حتى الآن، وتبدو من خلال نصوصها أنها نمت لوحدها، واستمرت تكتب على هذا المنوال، وحققت بالتالي منجزاً شعرياً من دواوين عديدة، يعبّر عن شاعرة ذات علاقة خاصة بالشعر، وربما هذا هو سر استمرارها في الكتابة، واصرارها على النشر والمشاركة في الأمسيات، وهو غير حال أغلبية جيلها من الشاعرات والشعراء. لم تتعب من الشعر، أو تضجر من القصيدة التي صارت غريبة في عالم اليوم، بل نراها تقدمها كما لو أنها تفتح أمام الناس حديقة ورد.
“ما زلنا كجذوع أشجار الصنوبر
لو خُدشنا
يسيل صمغ عواطفنا الكثيف”.
ديوانها الجديد وفيّ للنفَس القديم ذاته، لكنه أقرب مما تركته الحياة على التفاصيل، وما صنعته الأحداث من مآس وهزائم واحباط وفشل وسأم، يطل من بين أكثر من قصيدة:
“السأم
كلبي أنا
كلبي
الأجرب العقور
يلازمني
يتمسح بساقي
تصيبني قروحه
ولا أهشه عني”.
اللغة خام تتركها الشاعرة كما هي مفعمة بالطزاجة والعفوية، لا تشتغل عليها بالنحت الذي تستخدمه مع الصور، التي تبدو في كثير من الأحيان غريبة مسكونة بالدهشة.
“أيتها الوحدة
لا تتركيني
بين الآخرين
وحدي”.
نبرة الأنا عالية في الديوان، وهي تعلو وتهبط وتخفت، حسبما هو الحال بين الحزن والألم والفرح والصمت أمام القسوة والخسارة “أنا راعية الأخطاء، أنا الضد”، وهذه الأنا النافرة تذوب ولا يبقى منها سوى جمرة، دسها أحدهم في صدرها حتى أمست تفكر كثيراً عندما تحب، اكثر مما ينبغي، لكن ذلك صاحب اللعبة استراح عن حريقها، وبقيت “كعادة المصابين برهاب التلاشي”.
يخرج قارئ الديوان بانطباعات متعددة. الأول هو أن الشاعرة تأخذ الشعر على محمل الجد، ورغم كل ما حصل ما زالت تطارده، تفتش عنه، تعيشه وتهرب منه، تمارس معه طقس الاختفاء والتجلي، وإذا أمسكت به لا تتركه يفلت منها، بل تقبض عليه بشدة كي يصبح بمثابة ابن تدلله كي يخرج من بين يديها مكتملاً. والانطباع الثاني هو أنها مشغولة بالصورة الشعرية إلى حد كبير، ولذلك يبدو عملها هذا مثالاً على اشتغال الشاعرة على العناية بعمارة القصيدة، وتظهر صرامة البناء أن الشاعرة أتعبت نفسها بهندسة العمل. والانطباع الثالث هو ان الشاعرة لا تشبه غيرها من الشعراء، فلا تتقاطع في الصور والأجواء مع أحد، يبدو أن لديها مزاجاً خاصاً ولوناً مختلفاً، وهذا ما يجعل قراءة القصيدة عندها تمريناً على الكشف. والانطباع الرابع هو أنها تكتب بهدوء ومن دون عجلة، وتظهر المسافات واختلاف الأجواء بين قصيدة وأخرى، وهذا ما يفسر طول المسافة بين صدور كل مجموعة شعرية وأخرى، والذي يصل إلى حدود 13 عاماً بين الأولى “قديد فل للعشاء” 2002، والثانية “سرقات شاعر مغمور” 2015، سبعة أعوام مع الأخيرة التي صدرت حديثاً.
*المدن