أنور بدر، رئيس التحرير
مجلة أوراق العدد 13
ربما لا تخلو مدينة أو بلدة في سوريا من عائلة أو أكثر تُكنّى ب “الكرد أو كردية أو كردي أو كراد”، إضافة لعائلات كثيرة تَكتشفُ بقليل من التدقيق أن أصولها كردية، مع أن بعضها كعائلات، بل الكثير منها، لا يعرفون شيئا عن اللغة الكردية، ومن هؤلاء عائلة سَكنتْ بلدتنا تُكنى “درويش” وكنّا نعرف أنهم أكراداً، دون أن يَهتم أحدٌ منّا بتقصي أصول هذه العائلة.
رَبُّ العائلة وأستاذي يُدعى “عبد القادر درويش”، درس أيام فرنسا في المدرسة الابتدائية، دون أن يحصل على شهادة “السرتفيكا” التي كانت تمنح بعد اجتياز امتحانات الصف الخامس، مع ذلك أسس في خمسينات القرن الماضي مدرسة صيفية لتعليم الأولاد خلال العطلة الصيفية، حين لم نَكنْ نعرف في طفولتنا ما يُعرف الأن بالمدارس الصيفة أو دورات التقوية، وبالتالي كان لهذا الشخص قصب السبق في هذا المجال، قبل أن تحتكره منظمة “اتحاد شبيبة الثورة” لدعم سيطرة “حزب البعث” الذي احتكر السلطة منذ انقلاب 1963.
تَميّز هذا الشخص الذي لم يَسمعه أحد يتكلم اللغة الكردية، بأنه شاعر ويكتب الشعر العربي الكلاسيكي بامتياز، وقد طُبع له ديوان يتيم بعد وفاته طباعة رديئة، وأذكر له قصيدة رائعة حول مريم المجدلية، والكثير من القصائد في “القومية العربية” انسجاماً مع هواه الناصري في السياسة إذ آمن بعد عدوان 1956، أنّ عبد الناصر سينقذ المنطقة!
وبالعودة إلى مدرسته الصيفية، كان أستاذي يَجمع في كل صيف الكثير من أولاد البلدة، في غرفة واسعة من داره الطينية الصغيرة، أو تحت شجرة “زنزلخت” كبيرة خلف البيت، دون أن يكون لديه صفوف للتدريس، حيث يجلس الجميع من الأول ابتدائي وحتى شهادة الثانوية، على طريق شيخ الكتّاب الذي يعلم الأولاد حفظ أجزاء من القرآن، لكنّ أستاذنا بعكس شيخ الكتّاب كان يدير هذه المجموعة الكبيرة بطريقة ذكية وودودة بنفس الوقت، فيَعهد للمتفوقين من طلاب الصفوف العليا بالإشراف على طلاب الصفوف الدنيا، وكان مدرّسا ناجحا يُدرّسنا أغلب مواد المنهاج الدراسي.
وأعتقد جازما أن له الفضل علينا جميعاً في التعليم وفي تنوير العقل، إذ كان بالعموم شخص علماني غير متدين ويشرب العرق في ذلك الزمن البعيد، ويقرض الشعر بسلاسة، وكان مرجعاً في النّحوِ العربي وفي قواعد الإعراب على مستوى البلدة ككل، بما فيهم مدرّسي اللغة العربية من خريجي جامعة دمشق في ذلك الزمن، كما كان يُدرّس اللغة الفرنسية بذات الحرفة واللياقة التي يُدرّس بها العربية، مرورا بالتاريخ والجغرافيا وكذلك الأمر في الرياضيات والمواد العلمية، حتى أنّه علمنا في المرحلة الابتدائية كيف نضرب عدداً من خمسة أرقام أو أكثر بكثير بعددٍ لا تقلُّ أرقامه عن ذلك، ونحصل على النتيجة بشكل حسابي وسريع دون القيام بالعمليات التقليدية المعقدة لجدول الضرب!
هذا أول أستاذ كردي أعترف بفضله الكبير عليّ، وقد ودّعته وذَهبتْ إلى كلية العلوم في جامعة دمشق، وسَكنت أول عام في المدينة الجامعية ثم في موقف جسر النحاس من حيّ ركن الدين أو الأكراد كما هو معروف، دون أن أدرك عمق المشكلة الكردية في سوريا، إلا أنّ اعتقالي لمْ يتأخر كثيراً لنشاطٍ سياسي معارض في زمن لا تسمح فيها سلطة الديكتاتورية بأي معارضة، وفي مهجع أمن الدولة من سجن القلعة وسط دمشق، تَعرّفتُ لأول مرة على أطياف القوى السياسة، وبينهم تحديدا قيادة “البارتي” أو “الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا” الذي تأسس عام 1957، كامتداد للبارتي العراقي بقيادة مصطفى البرزاني، وأول شيء تعلمته أن كلمة “بارتي” تعني حزب، وفي تلك الفترة لم يكن يوجد إلا حزب واحد للأكراد.
لن أتحدث عن اعتقال قيادة حزب البارتي الديمقراطي زمن الوحدة 1960، كوني لم أعاصره، إلا أنني عاصرت الفترة الأخيرة من الاعتقالات الثانية التي بدأت عام 1973، باعتقال السكرتير الأول للحزب الحاج دهام ميرو مع لفيف من رفاقه “محمد نذير مصطفى، كنعان عطيد، خالد مشايخ، عبد الله ملا علي، ومحمد فخري”، مما استدعى انتخابات جديدة للمكتب السياسي، جاءت بشخص دينامي ومثقف هو عبد الحميد سينو كسكرتير أول للبارتي، حتى اعتقاله عام 1975، وكان هذا الشخص أستاذاً لي في السياسة والحياة، شخص مبدئي ومثقف، درس في فرنسا وألمانيا، متخصص في الاقتصاد والإحصاء، ويجيد الحديث والاستماع، وكان كثير التواضع دمث الأخلاق والمعشر شفاف الطويّة ضئيل الحجم، رغم سعة مداركه وعظيم ثقافته، وكل ذلك مع ابتسامة دائمة تزين محيّاه وتزين حياتنا الكئيبة في سجن القلعة، وسأذكر أنه لشدة تواضعه، لمْ يقدّم نفسه لنا طيلة السجن كسكرتير أول للحزب، احتراما لسن وهيبة الحج دهام كشخصية تقليدية سبقته في شغل هذا المنصب، وأفرج عنهم جميعا عام 1980، ولم يُقدر لي الالتقاء به ثانية حيث عاجلته المنية بعد أقل من أربع سنوات بسبب مرض عضال، فيما كنت أذهب أنا في سلسلة اعتقالاتي الأخيرة، وكم أحزنني ولا يزال يحزنني حقيقة وفاة هذا المعلم الثاني، مع الإشارة إلى أنني لم أشأ الحديث عن الأحزاب السياسية الكردية، فهذا شأن آخر.
*****
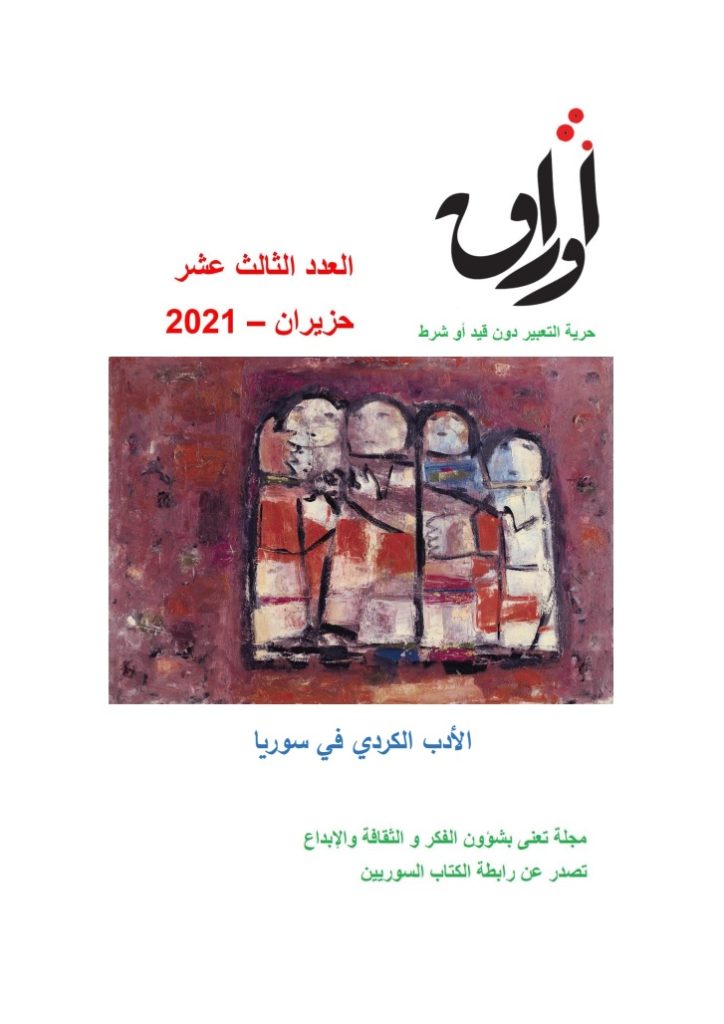
حين قررّنا في هيئة تحرير “أوراق” أنّ يكون ملف العدد عن “الأدب الكردي في الثقافة السورية”، لم أكن أدرك حقيقة أنّني سأذهب إلى تلك التفاصيل، لكنني الآن ونحن نجهز لإصدار هذا العدد، خلال أيام، وقبل الحديث عن الأدب الكردي في الثقافة السورية، أدرك تماما أهمية البحث في تلك التفاصيل الصغيرة خارج المنظومة الثقافية التي بناها نظام الاستبداد، إذ علينا أنّ نعرف شيئاً عن مجتمعنا السوري وثقافتنا السورية، التي تُعتبر من أغنى المجتمعات المعاصرة بإرثها الثقافي والحضاري والاجتماعي والديني أيضاً، والذي سعى نظام الاستبداد البعثي إلى تجاهله كثيراً، ثم عمد قاصدا إلى تدمّيره في العقد الأخير لثورة الحرية والكرامة، وقد ساهمت في استكمال مهمته في هذا التدمير تلك القوى الجهادية التي قاتلت باسم الله ضدّ سوريّتنا وشعبنا وحقوقنا في الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية.
والحديث عن غنى سوريا الثقافي والحضاري لا نقصد به الانشاء والخطابة، بقدر ما نسعى لتعرّف هذه التفاصيل في واقعنا، ففي مدينة أوغاريت الفينيقية على الساحل السوري اُكتُشِفت أول أبجدية قديمة تعود لعام 1500 ق.م، أي كانت معاصرة للحضارتين الأكادية والسومرية، حيث شكلت انتقالاً من الأبجديات التصويرية القديمة كالهيروغليفية والمسمارية لتؤسس لتطوّر الكتابة وكل اللغات القديمة والمعاصرة، بل أكثر من ذلك، يشكل المجتمع السوري المتحف الحي الأهم للغات القديمة التي لاتزال تتحدث بها بعض المجموعات السكانية، فبلدة معلولا قرب دمشق هي المكان الوحيد في العالم الذي ما يزال سكانها يتحدثون الآرامية أو لغة السيد المسيح، كما يوجد في سوريا قرابة عشر لغات قديمة محكيّة حتى الأن وهي “الآرامية بشقيها الآشورية والآرامية الحديثة الشمالية، الكلدانية، السريانية، الأديغية (ويطلق عليها في البلاد العربية اسم اللغة الشركسية)، الطورية أو الطورانية وهي تختلط كثيرا مع اللغة التركية، الأذرية الجنوبية (تسمى التركمانية أحياناً)، الأرمنية، الكردية بلهجاتها الأربع، ثمّ العربية”، إضافة لمجموعة من اللغات الأقل حجما في التداول أمثال: الدومريّة والقبرديّة واللومابرين.
وأعتقد أن هذا الجانب من الموضوع يحتاج لمباحث اختصاصية وأكاديمية ليس مجالها هنا، لكننا نتكئ عليها لتأكيد أن غنى هذه الّلغات المحكيّة في سوريا يَعكسُ غنى الشعوب والحضارات التي تعاقبت وتمازجت في هذا المختبر البشري الفريد، والتي لايزال الكثير من اسرارها مدفون تحت الأرض، وهناك إحصائية تقول أن في محافظة الحسكة فقط يوجد أكثر من 6000 تل اثري، لم يتم الكشف عن مدفونها، وربما يصل الرقم في سوريا إلى أكثر من ذلك بكثير، وقد سعى النظام خلال عقود سلطته الاستبدادية إلى تجاهل هذه القيمة الحضارية والمعرفية والإنسانية، التي تبلغ قيمتها بأضعاف قيمة ما هو مكتشف من نفط المنطقة، وهذه هي قيمةُ ولغزُ سوريا الدفين.
هذه القيمة تؤكد عظمة الانسان السوري بكل تجلّياته أو هويّاته التي يَتسمّى بها، ولغاته التي ينطقُ بها، ومعتقداته التي يؤمن بها، والتي تنوف عن 28 أثنية قومية أو عرقية ومجموعة دينية أو مذهبية، أي إن عظمة الانسان السوري تكمن في هذا العمق بعيداً عن العصبيات والحسابات العددية التي تُظهر غباء الصراعات الشوفينية التي تُدار حتى الآن على تفسير ما يسرب من أنه تاريخ قديم، فيما تاريخنا القديم بل تاريخ أغلب مجتمعات وثقافات المنطقة والعالم القديم ما زال مدفونٌ تحت أقدام الغزاة.
*****
هذا الدرس الأخير تعلمته من أصدقائي الكرد وغير الكرد جميعا، في أدبهم الجميل، وفي ثقافتهم الراقية، وفي فنونهم الرائعة، وفي انسانيتهم التي تفيض على الجغرافيا والتاريخ معاً، وتعلمت معهم ومنهم دور الثقافات وأهمية الحضارات في بناء الأوطان، فكل الشكر لهؤلاء السوريين المطالبين بالحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وإن كان المقام لا يتسع هنا للتوقف مع أسمائهم جميعا بشكل شخصيّ.
نتقدم في هيئة تحرير أوراق بالشكر الجزيل لكل أصدقائنا الذين ساهموا معنا في الكتابة وفي إنجاز هذا العدد، سواء في ملف العدد أو في ملفات الابداع شعراً وقصةً ونصوصاً ومسرحاً ونقداً وترجمةً وحوارات ودراسات ومقالات، مع تنويه خاص للّوحات والأعمال الفنية التي زينت هذا العدد وبشكل خاص لوحات الراحل فاتح المدرس، كعربون وفاء لحضوره المستمر في حياتنا وثقافتنا، كما نشكر كل الأصدقاء والكتاب والمثقفين الذين حالت ظروفهم دون المشاركة في هذا العدد، على أن نلتقي بكم دائما على صفحات أوراق وأعدادها القادمة.














