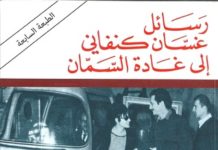1
أمّي الحبيبة..
كنت – ومنذ أشهر – أستعدّ لهذا الموقف، روّضت نفسي وجسدي على تقبّل أيّ نوع من التعذيب، درّبت جسدي على الاحتمال بمضاعفة ساعات الرياضة، وهذا ما ساعدني على احتمال الألم في الأيام الأولى للتحقيق. لكن من قال يا أمّي إنّ الألم هو ألم الجسد الذي يمكن لكلّ منا أن يحتمله في سبيل أن ينال وطنه الحريّة! أذكر عندما كتبتِ عن “نجيب السخيطة” والآلام التي تحمّلها في سجن القشلة في حلب، وحين مرّر الفرنسيون عربة “الدريس” فوق جسده على البيدر كما يفعلون بالحنطة، كلّ هذا لا يقاس بما يحدث لي الآن.. ألم الروح أكبر وأشدّ وطأة يا أمّي. كيف لي أن أحتمل تلك الألفاظ النابية التي يقولونها عنك!. اكتشفت داخل معتقلات الديكتاتور أنّ نظريتي “بأنّ الجسد السليم يستطيع أن يدفع بالروح لالتماس جمال الكون” مشروطة بالحريّة. لا يمكن لجسد معتقل أن يلتمس جمال الكون، لا يمكن لجسد سليم أن يكون حاضناً لروح جميلة. لم أعد مؤمناً أنّهم لن يستطيعوا الوصول إلى روحي _كما أكّد لي توفيق_ ولن يمسوها بسوء! بل استطاعوا أن يتركوا في أعماق روحي بقعة عتمة وسط النور الذي حاولت أن أحافظ عليه طيلة فترة اعتقالي.
يخرج شخص آخر من جسدي، يجلس في الركن.. هناك حيث العتمة القاتلة، لا ملامح محددة له، لكنّي أسمع صوته الهادئ، يلوث روحي بتلك البقعة السوداء يضرّج جدرانها ويخطّ عليها عباراتهم البذيئة، تهديدهم، أسلوبهم القذر في ابتزازي.. هل أتخلى عن جسدي؟ قولي لي.. هل أتخلّى عنه في سبيل سلام روحي؟.
كنت واثقاً أنّك تملكين حدساً يجعلك تعرفين أنّي حي أرزق.. وهذه الثقة تؤلمني، لأنّي أدرك أنّك تشعرين بي وتتألمين وأنت هناك على الضفة الأخرى من النّهار.. تعرفين ما يجري لي بالضبط، تلومينني على لحظات الضعف والهشاشة وفقدان الإيمان! لا أجرؤ على إخبارك بما يجري كي تكفي عن لومي، أو تجدي لي عذراً فيما أفعله بنفسي. أدرك أنّ هناك أطرافٌ أخرى في الحياة، وأنّ حياتي لا تعنيني وحدي، وأنّه ليس من حقّي أن أتصرّف بهذه الطريقة.. أدرك يا أمّ نور، سامحيني على لحظة الضعف هذه.. اعتبريها تماماً فشة خلق، وسأعود كما تحبين!.
2
يا أمّي..
ليس فلسفة للموت، لكنّ صديقي الذي أصبح أنا وهو يحتضر بين يديّ وجلده المحترق بنار حقدهم لم يعد قابلاً لّلمس، وصارت يداي تحملان بصماته رماداً.. قال لي: “النار التهمت جسدي الضعيف، لكنّهم لم يستطيعوا أن يمسوا روحي.. روحي امتزجت بهذه النار، وستمتد ملتهمة أجسادهم يوماً”. ما أنا على ثقة منه أنّ النّار لم تغوه ليتبعها إلى عالم الأشباح، مودّعاً الحياة بكلّ ألقها.. فلم يكن الموت خياره حتّى الساعة التي ألقوا فيها بجسده إلينا بلامبالاة حاقدة..
عرفته خلال الأشهر الماضية مؤمناً بمقدرته على تحدي الموت ورغبته في الحياة.. لم يذكر أمامي مرّة واحدة أنّه يعشق الفناء، ويجد فيه الخلاص! لكنّ الملفت للنظر أنّه في اليوم السابق لموته المأساوي كان يحدّثني عن عيد الشمس عند قبائل “الناتشيز” _في معرض وصفه للثورة_ (بأنّهم كانوا يحافظون على شعلة النار بصبر وبطء عجيبين.. وفي ليلة احتفالهم يتركون النّار المشتعلة منذ عام تنطفئ قبل الفجر، ثمّ يقوم الكاهن بحك قطعتين من الخشب الجاف ببعضهما متمتماً بكلمات سحرية بصوت منخفض ترتفع وتيرته تدريجياً مع ازدياد وتيرة حركة الاحتكاك والفجر يقترب، حينئذ يقوم منادٍ متجول بتوصيل النّار إلى أكوام البوص، فتنتشر النار بحركة حلزونية، تضيء لحاء أشجار البلوط فوق الهيكل، وتعطي بذوراً نارية تشتعل في بيوت القرية جميعها، فتنيرها لعام قادم!.) وعقّب قائلاً بأنّنا نحتاج لتجديد النّار كي لا تهرم وتنطفئ يوماً من تلقاء ذاتها! وسألني بغتة “كيف تستطيع أن تشعل النّار وسط هذه العتمة؟”. قلت هامساً: ومن قال لك إنّها منطفئة! أتعتقد أنّه يجب أن نرى بأعيننا كلّ شيء؟ هناك أمور ندركها بأرواحنا”.
رأيتُ ابتسامته تنير جانب وجهه وقال بصوت جهوري لفت أنظار المعتقلين: “نعم، لسنا بحاجة للحديث عن الطاقة التي تتركها النار في الجسد بانتظار هبّة ريح.. فشهوة القتل الكامنة في أرواحنا ستدفع الجسد إلى الانتقام، فكلّما ازداد الحطب ازدادت النّار اشتعالاً”.
أخافتني لمعة عينيه.. انقبض قلبي للحظات وأنا أتأمل تلك الطاقة الخفية التي يمتلكها البشر والتي تتبدّى بأشكال مختلفة بحسب المكان والزمان والظرف المحيط. تخيّلت أنّ “توفيق” في تلك اللحظة يملك قدرة شمشوم على تحطيم المعبد وإن كانت يداه مقيدتان!
يا أمّي بمَ سأقاوم العتمة بعد رحيله؟ هل سيكون للشمس عيدها وأبواب الزنازين مغلقة على أجسادنا التي تأكلها العفونة والحشرات والجوع؟.

4
يا أمّ نور.. أعرف أنّك تسألين..
لماذا الموت؟
مرّة أخرى ودائماً فهو المحرّض الأوّل على التشبث بالحياة. في العتمة تغدو الحواس أكثر رهافة وأشدّ ضياءً، وتتحوّل الأصابع إلى مجسات أخطبوطية تفرز روائح الكون، وألوانه، وأسطحه الخشنة والناعمة. هل خطر ببالكِ مرّة أنّ لّلون ملمس تدركه أصابعنا مع اعتياد العتمة؟ قميص صديقي الناري له ملمسٌ لاذع، كلّما حاولت أن ألفت انتباهه إلى أمر يحدث حولنا بملامسة ذراعه، كان اللون يتسرّب تحت جلدي، ويصفع حواسي، ويستنفر ما تبقى من خلايا هامدة في جسدي بفعل الاعتياد والسكون وقلة الحركة.. إنّه الدّم.. الدّم الذي يجري هناك في الشوارع، الأزقة، البساتين، الجبال. إنّه الدّم المستباح يجعل كلّ ما حولنا قابلاً للاشتعال في لحظة.. ثمّ يهمد ويتلاشى وسط العدم.
هكذا كان توفيق شعلة من نار، تأججت، والتهبت، وتألقت، ثمّ انطفأت دفعة واحدة. حين غاب أصبحت الألوان أقلّ حدّة، انطفأ وهجها.. صارت السطوح أقلّ خشونة، أصابعي تشعر بملمس ناعم، ليس حريرياً، بل لزجاً وأملس كجلد أفعى.. إنّه اللون الرمادي للجدران.. إنّه لون الوقت الذي لم يعد قابلاً للحركة!. لم يكن بطيئاً بالنسبة إلى جسدي، فقد تمدّد فيه بسرعة غريبة، جعلتني أشعر بالكسل والفتور، ثمّ تيبست عضلاتي، واتّخذ جسدي شكلاً جنينياً لم أعد قادراً على الخروج منه. إنّه الماء… لكنّه ليس دافئاً وحانياً.. بل لزجاً ومقرف الرائحة.. هكذا استعضت عن القماش والجدران وحركة يدي، بعالم افتراضي لمخيلة متعبة لم تعد تحتفظ من العالم الخارجي سوى برجع صدى مشروخ لأصوات مبهمة، كانت في زمن ما واضحة تماماً، وفي متناول سمعي!…
ما زالت في متناول سمعي.. فقط غادرت مجال الرؤية، وبتُّ كأعمى يتلمّس ألوان الكون بأصابعه، فيأخذ اللون شكلاً لزجاً، دافئاً، حاراً، بارداً، خشناً، وحريرياً.. حسب درجاته وقربه من القلب وبعده عن الروح.. أصابعي صارت تحمل لي شكلاً جديداً للعالم من حولي عندما تدرك الألوان من حولي، وتترك فيّ أثرها المطمئن أو المستفز.. فصرت أخشى أن ألمس أيّ شيء يقترب مني.. خاصة هؤلاء الأشخاص الذي أرتاح لأصواتهم وأحاديثهم خشية أن يخدش ذلك الارتياح لونٌ مستفز!
قد لا يكون للموت معناه الخاص ونكهته المعتادة داخل السجون، فهو أحياناً رفاهية يطلبها البعض للخلاص من تراكم الألم والوحدة والخوف من مصير شائك. لماذا رحل وتركني وحيداً أشارك شبحه بعضاً من ذكريات مشتركة وأخرى تشاركنا الحديث عنها؟. لماذا يفرض عليّ حضوراً يعذّبني، ويستفزني، فلا أكاد أجد السلام الذي تحاوله روحي لتكمل توغلها داخل العتمة القاتلة؟
بالنسبة لي الذي لا يموت أبداً هو ذلك الذي سيموت معي في اللحظة ذاتها، أمّا توفيق الذي مات بين يديّ، لم يعد جميلاً لأنّه ترك لي كلّ الأسى والرغبة في المحافظة على ذكرياته لتغدو بشكل ما هو، لأبقيه معي أطول زمن ممكن.
أمّا هؤلاء الذين يموتون وحيدين في العتمة والبساتين الموحشة، فيجبروننا على حمل وزر موتهم ما دمنا أحياء.. هل حقّاً وجدوا محمود وحيداً في الجبل ولم يتعرّفوا عليه إلاّ بواسطة ثيابه؟ قولي لي الحقيقة يا أمّي.. أخبريني.. لا تشفقي عليّ من الألم، لم تعد روحي المكتظة بأشباحهم تجد طاقة لألم جديد.. هل حقّاً عذّبوه حدّ محو ملامحه؟
هل عرفتِ لماذا الموت؟ وللمرّة المليون.. ولماذا لا نستطيع هنا أن نحكي عن شيء آخر في هذا التوقيت؟.
5
يا أمّي…
تذكرين ليلة الخامس عشر من آذار؟ لا أشكّ أنّها برحت مخيلتك يوماً.. لأنّها تعنيك كما تعنيني. تلك الليلة التي لم ننم فيها، أنا على حافة النهاية وأنت على حافة الانهيار من الألم. كيف أعتذر لروحك عن تلك الليلة يا أمّي؟
في الثانية عشرة ليلاً كنتِ تلفين الشوارع في جولة للتعرف على أفرع المخابرات في المدينة.. لا ألومك على ذلك، وإن كان تصرّفك قد أرهق روحي وحمّلني فوق طاقتي لأنّي لم أستطع حينها أن ألتمس وسيلة أخبرك من خلالها أين أنا. توقفتِ في البرد وهدأة الليل أمام فرع الخطيب.. أبعدتْ الريح الماطرة شالك عن وجهك.. ولسعك برد ارتجفتْ له ضلوعك.. وهمست روحك “لستُ متأكدة.. ليس هنا”.. ما الذي جعلك تذهبين إلى فرع فلسطين؟.. كلّ تلك المسافة من الترقب التي قطعتها بلهفة لم تكن ذات فائدة.. لأنّ روحك شعرت بالفراغ والبرد والصمت الذي تقطعه السيارات العابرة بسرعة جنونية لتوقظ فيك حدساً لم يخطئ “ليس هنا.. بالتأكيد ليس هنا”. حين تلكأت خطواتك ونبض القلب قريباً من “آمرية الطيران” كنتِ تشمين بقايا من رائحتي.. لم تستطيعي التأكيد أنّي موجود، لكنّ قلبك خفق بشدّة.. “كأنّه مرّ من هنا!” لم تخطئي يا أمّي.. كنت قد غادرت المكان عصر ذلك اليوم.. كنت آمل _كما أخبروك فيما بعد_ أن يفرجوا عني ذلك اليوم كما أفرجوا عن عدد من رفاقي في المعتقل. أعرف أنّك لم تستطيعي النوم في الثانية صباحاً، وأنّ قلبك بدأ يخفق بعنف، وأنفاسك تضيق، وجسدك يرتعش بقوة.. لم يكن بيدي يا أمّي أن أوقف جنونهم ليستقرّ قلبك مكانه ويرتاح.. لم أستطع أن أصعد الدرجات، وأغادر ذلك القبو القذر.. للأسف يا أمّي ما شعرتِ به كان حقيقة، نعم.. كنت أخطو إلى الغيبوبة تحت التعذيب في اللحظة التي شعرتِ فيها بالاختناق وشهقتِ ولم تستطيعي التقاط أنفاسك.. شعرتُ بهذا يا أمّي.. قاومت الغياب لأجلك.. قاومت الموت لأجلك.. خرجت من غيبوبتي، امتلكت الصحو في الثالثة صباحاً لأمسح الدّمع عن عينيك، وأربّت قلبك لتهدئي وتنامي.
6
سمعتك يا أمّ نور
وصلني عتابك الشجي مخترقاً جدران الزنزانة وقلبي!
سمعتك يا أمّي تعتبين عليّ أنّي لم أزرك في المنام منذ خمسة أشهر! ..
لا أدري يا أمّي كيف استطعتُ التسلّل قبل ذلك التاريخ إلى أحلامك.. ولا أشكّ أبداً أنّني حاضر في قلبك وروحك.
لكنّي لا أجد تفسيراً لعدم استطاعتي زيارتك.. هل أخشى على قلبك من التبدلات التي طرأت على جسدي؟ هل أخاف نظرة الفزع في عينيك ؟ أم أخشى عدم تصديقك أنّي أنا .. أنا !
تكثرين لومي يا أمّ نور وأنتِ على يقين أنّي لا أملك من أمري شيئاً .. أعرف أنّ ذلك حقّك .. أعلم يا أمّي أنّك تمنيت لو أخبرتك بكلّ شيء منذ البداية .. لكن عذري الوحيد أنّي خشيت عليك من الألم، وخشيت أن تمنعيني ! ربّما لم أعرفك جيداً يا أمّ نور مع أنّي اختبرت صلابتك مراراً .. عندما اعتقلوني في المرّة الأولى وأغلقت هاتفي لمدة خمسة أيام .. عرفتِ بحدسك كلّ شيء ولم تصدقي كذبتي الصغيرة بأنّ هاتفي معطل ! وعندما احتجزوني في المرة الثانية ليومين في عربين .. أيضاً كشفت كذبتي الصغيرة على الرغم من أنّك لم تنظري في عينيّ!
تذكرين يا أم نور ؟ كنتُ كلّما كذبت عليك، تنظرين في عينيّ، وتقولين لي : لا تكذب عليّ ، عيناك تشفان عن روحك وتقولان كلّ شيء.
أعرف أنّك منذ اعتقالي تكتبين لي مسجات لا تصلني، لأنّ هاتفي خارج نطاق التغطية .. وأعلم أنّهم منذ التاريخ الذي افتقدني فيه الحلم “حلمك” .. قطعوا الخط وحرموك وهم تخيّل أنّ تلك الرسائل تصلني وأقرؤها ولا أجد وقتاً للردّ!
سامحيني يا أمّي إن لم أمر بك في منام ..
ذلك لأنّي أرجو الله أن أمرّ بكِ في الواقع .. لأقبّل يديك طويلاً، وأبكي كما لم أفعل وأنا طفل صغير.
7
يا أمّي…
أعرف أنّها ليست المرّة الأولى التي أتسبب لكِ فيها بالهلع .. ربّما هي المرّة الرابعة! أم أنّ العدد أكبر يا أمّ نور؟
اعذريني لم أقل لك “صباح الخير يا أمّي” ربّما لأنّي لم أعد أشعر أنّ لهذه الكلمة معنى.. ربّما لأنّ الجدران الرمادية
هذه المرّة أطبقت بقوة على روحي ولم تعد تترك لي مجالاً حتّى لأستعيد أيّ صورة ملونة عن العالم.
يا أمّي .. يا أمّ نور .. سامحيني فالطفل ابن السنة والنصف الذي هرب منك يوماً حين فتحتِ باب الدار لأمر ما.. امتلك أجنحة منذ تلك اللحظة.. أعاده الله إليك بقدرته.. لا أشكّ أنّك تذكرين.. وتتندرين بهذه الحادثة، فقد كنتِ تفعلين ذلك دائماً.. تعيدين رسم المشاهد وقصّ حالات الهلع التي عشتها وأحداث ذلك السبت المشرق من كانون شباط 1990 يومها توغلت في زحام “البازار” وبقيتِ مع العائلة تبحثين عني طيلة اليوم.. مارويته بعد أن وجدوني آخر النهار أمام دكان “شعبان” آكل كعكة اشتراها لي، أثار ذعرك، لكنّي يومها كنت مستمتعاً بتلك المغامرة.. بدخولي بيتاً لا أعرفه، ولعبي مع أطفال لم أرهم بعد ذلك ثانية وربّما التقيت بهم لكنّي لم أعرف أنهم هم أنفسهم .. البيت ذو الحديقة الكبيرة، والحمار ، والشبّاك المحاط بقضبان حديدية! وأعرف أنّ سلسلة الهرب من البيت والضياع كانت تؤرقك دائماً لأنّي فعلتها بعد سنة ونصف أيضاً وكنتُ في الثالثة، ثمّ أعدت الكرّة وأنا في العاشرة حين غضبتُ من أولاد عمتي فعدت ماشيا من سراقب إلى أريحا.. آه يا أم نور .. كم احتمل قلبك من لوعات .. لكنّي أدرك أنّ اعتقالي كان أقساها .. !
أمّي .. كنتِ دائماً تقولين لي إنّ هروبي الأول حدث في يوم مشمس من شباط، وكان يوم سبت.. هل كان ذلك في الحادي عشر من شباط أيضاً يا أمّ نور؟
8
صباحك نور يا أمّي ..
صباحك أنا
أعلم أنّي تأخرت عليك كثيراً.. وأدرك حجم الجرح الذي تسببت لك فيه وأنت تعدين الأيام بانتظار عودتي..
هل أعتذر لروحك يا أمّ نور على تسرعي في إخبارك أنّي آتٍ إليك خلال شهرين! ؟
مضى الشهران ولم أصل.. لا أعرف كيف أشرح لك ما يجري الآن.. لا أعرف كيف أعبّر عمّا بي، لكنّي على يقين أنّك تعلمين وتحسين بي..
تذكرين عندما أنهيتِ كتابة روايتك “المعراج”؟ كنّا نتناول فطورنا في المطبخ.. أذكر عندما حدّثتني عن يوسف وكيف عاد إلى أمّه على الرغم من موت جسده.. عاد ليجدها راكعة قرب قبره تقرأ القرآن، وقد صفّت أصص الزرع” الحبق والريحان والعطرية” حول قبره ، كما كانت ترتبها على درجات بيتهم في “عين كارم” حينها توقفت عن المضغ، ووضعت قطعة الخبز من يدي.. وتأملت اللهب المتصاعد من كأس الشاي.. خشيت يا أمّي أن أرفع رأسي لأنظر في عينيك.. انقبض قلبي للحظات… وأنت تروين لي ما حصل ليوسف.. تقلّصت روحي قبل أن تندفع عبر النافذة لترى تلك العودة تومض وكأنها حقيقة.. كنتُ أراني هناك.. وكنت أراك “صفية” نعم رأيت تلك اللمعة الحزينة في عينيك.. ونهضت مغادرا بحجة أنّي شبعت..
لماذا خشيت لحظتها أن أكون يوسف .. وأن لا أستطيع العودة إليك بجسدي؟ لماذا تجسدتِ أمامي يا أم نور “صفية” أم يوسف؟
لم أدرك وقتها السبب بما حدث.. وخرجت من الحالة بسرعة بتفسير بسيط وهو أنّي تسببت لك بتعب روحي ونفسي مضاعف وأنت تعيدين الكتابة من جديد حين طيّرت لكِ ملف الرواية من الكمبيوتر!
تذكرين يا أمّي؟ يومها خرجت من البيت.. وبقيت أتمشّى على طريق الجبل لساعة متأخرة من الليل، وأنا أفكر بحجم الإحباط والألم الذي تسببت لكِ فيه .. تذكرين “المسج” الذي أرسلته لكِ (لو كان الدمع يعيد الأوراق الميتة إلى الشجر لبكيت حتّى الصباح). ربّما ظننتني يومها بلا إحساس ، وأنّي أتفكّه وأمزح معك..
لكنّي حقّاً بكيت يا أم نور .. لأنّك أيضاً بكيت أمامي التعب والجهد الذي بذلته خلال سنة كاملة في الكتابة ..
تعلمين يا أمّ نور.. يوسف عاد إلى صفية لأنّك استطعت كتابة الرواية مرّة ثانية بإرادة ودأب أذهلاني.. فأحببت أن أعود إليك لأخبرك كم تعلّمت من تلك التجربة يا أمّي !
سامحيني يا أمّي .. ليس بيدي أن أعود..
ليس بيدي أن أصدق الوعد..
ليس بيدي أن أحمل إليك فرحة صغيرة..
يذبحني حزنك.. ويبكيني .. كيف لي أن أمتلك مقدرة يوسف على العودة يا صفية؟
9
صباح الخير يا أم نور.. صباحك قلبي.. كيف حالك بعدي؟
… مرّ عيد الثورة، وعيد الأم، ومازلت ألملم جسدي في مربع لا يتسع لطفل في السادسة.. أتذكر كيف كان هذا الجسد يتمدّد على أرض الصالة في بيتنا الذي تسطع ملامحه مخترقة دماغي للحظات ثمّ تنطفئ فلا أستطيع القبض عليها ثانية.. مجرد رماد في حلقي، مجرد رماد بين أصابعي.. أيعقل أن أتحوّل إلى مستحاثة كهؤلاء الذين يحيطون بي؟ ما شكل وجهي يا ترى؟ أحاول أحياناً أن أرسم شكلا لوجهي لأستطيع أن أعرف على أيّ هيئة صرت؟ على مرّ الأيام التي أحصيها بمنتهى الدقة تحوّل هذا الجسد الذي كثيراً ما عشقت كماله وانحناءاته واستقامته إلى شكل بدائي يجعلني أعتقد أنّ دارون لم يخطئ في نظريته.. قد لا أعرف بالضبط من خلال انحنائي وأنا في طريقي إلى التحقيق إن عدت إلى هيئة القرد التي كان عليها الإنسان البدائي، لكنّي ألمحه من نظرة جانبية إلى هؤلاء الذين يسيرون أمامي في الممرات الضيقة القذرة..
أستيقظ كلّ يوم.. لاشيء يشير إلى الزمن، أصواتهم وحدها من يعطي شكلاً ليوم جديد، تحضرين أمامي كما دائماً، تحثينني على النهوض: “نور، كفاك نوماً.. أريدك أن تشتري لي بعض الأغراض من السوق” أغفو من جديد ليوقظني صوتك: “نور.. انهض.. أريد بطاقة انترنت.. الهاتف مقطوع.. نور استيقظ.. كفاك كسلاً، انهض أريد أن تصلح لي الحنفية.. نور.. نور.. نور…”.
لون الشمس، وشوارع دمشق، وجبل الزاوية.. رفاق المدرسة والجامعة.. والحلم.. المستقبل الذي بترت ساقاه و.. الانتظار ..
أنتظر صوت السجّان ينادي اسمي لأذهب إلى المحاكمة من دون جدوى! أعلم أنّ ملفي عندهم مليء بكلّ التهم التي تثبت إنسانيتي وولادتي حرّاً.. مع هذا آمل أن يكتفوا باعتقالي _ كما حدث لبعض رفاقي_ ستين يوماً…
أرسم كلّ صباح _في مخيلتي_ شجرة خضراء، أوزّع عليها لافتات صغيرة “الأمل.. سوريا.. المستقبل”. يمرُّ الوقت ثقيلاً.. محتشداً بأصوات الجلّادين وشتائمهم ولسع سياطهم على أجساد عارية تنزف في سمعي أنينها وألوان الدّم الحار.. بركة من دم، تتسع وتتسع.. وتنقلب صحراء واسعة.. في وسطها يلوح سراب يعشي العين.. ما بين ضوء وظلّ يتشكّل النهار.. لا أحتاج إلى مخيلة لأراه فثمّة أشياء تبقى أقوى من ذاكرتنا ومخيّلتنا، ثمّة أشياء تسكننا، وتتجسد خارج ذواتنا كما الحقيقة لا لبس فيها..
يصرخ السجان يأمر السجناء بالنوم مع ملايين الشتائم يوزعها على كلّ المهاجع.. نهار آخر قد ولّى مخلّفاً وخزة في القلب وحسرة تحرق الحلق.
يجافيني النوم، صورٌ جديدة تستيقظ في رأسي المثقل بالماضي.. ما قبل العتمة.. الطريق إلى بيتنا، رائحة الأمكنة، شكل الأبواب المفتوحة على لحظة الشروق، النهر لحظة الفيضان، وصوتك لا يني يناديني.. يا نور…
*خاص بالموقع
مجلة أوراق