مصطفى تاج الدين الموسى
كاتب سوري مقيم بتركيا، من مواليد 1981 تخرج من جامعة دمشق كلية الإعلام. حازتْ قصصه ومجموعاته القصصية ومسرحياته على عدة جوائز أدبية محلية وعربية، وترجم بعضها إلى عدة لغات عالمية. وكتب عنها الكثير من المقالات والدراسات.
أوراق 11
أوراق القصة
على الرغم من أنها تكبره بأحد عشر عاماً تقريباً، إلا أن جارته الجميلة، استطاعت خلال شهر من سكنها أمام بيت أسرته مع زوجها، أن تغويه ليسقط في غرامها، هو الذي لم يتجاوز عامه السادس عشر.
أدمن مراقبتها، متلصصاً عليها من شباك غرفته المطل على شرفتها، لساعات طويلة من اليوم، حتى أنه حفظ عن ظهر قلب مواعيد قهوتها، وأوقات نشر غسيلها، هي التي لا تعرف جيداً أوقاتها تلك، لكنها انتبهت منذ يومها الأول في هذا البيت، إلى ذلك المراهق، ابن الجيران، ذي العينين الخجولتين، ومراقبته الصامتة لها، شيءٌ غامض داخلها جعل مشاعرها تميل إليه، فصارت تمنحه وقتاً جيداً خلال اليوم، ليشاهدها ويتأملها بينما تتصرف بشكلٍ اعتيادي، وكأنها لا تعرف أن أحدهم يراقبها من خلف تلك النافذة، بخبث أنثوي تجيد ممارسته بنعومة شهية بالنسبة للمراهقين.
بعد مرور شهر تقريباً، شعرت أنها بدأت تحب ذلك المراهق الخجول.
أخبرها زوجها بصوته البشع قبل خروجه صباحاً إلى العمل، أنه مضطر للنوم خارج المنزل بسبب طبيعة عمله، ومضى دون أن يكلف نفسه عناء الشرح لها، وهي لم تسأله متى يعود، لأنها منذ زواجهما تشعر أن أيامها مع زوجها ذي الطباع السيئة أشبه بعقوبة.
تسلت بترتيب البيت منذ الصباح حتى المساء، مرّت الساعات عليها بملل هائل، تمنت لو بقيت مع زوجها في حارتهم البعيدة، حيث يسكن أهلها وأقاربها وصديقات طفولتها.
ذهبت إلى مرآتها، فجلست أمامها تزين نفسها بأدوات التجميل، وتسرح شعرها، وتغني، وترش العطر على نفسها، مع أنه ليس لديها زيارة لأحد أو من أحد، وزوجها لن يرجع هذا المساء من عمله كعادته اليومية.
زيّنت نفسها دون سبب، أكثر مما تزين نفسها عادة عندما يأتيها زوار، أو عندما تذهب لزيارة الآخرين، أو من أجل زوجها.
أمام مرآتها استنتجت وهي تمرر أقلام الزينة على عينيها وشفتيها وأظافرها، أن المرأة تتزين بشكل أفضل، عندما لا يكون لديها سبب لذلك.
خرجت إلى شرفتها مع فنجان قهوة، وهي تدندن بلحن أغنية تحبها، شعرت أن غياب زوجها عن البيت، هو مناسبة جميلة تستحق أن تحتفل بها مع نفسها، وتهدي مزاجها فنجان قهوة.
انتبهت إلى ذلك المراهق وهي ترشف القهوة، كان يراقبها من خلف شباكه، تحت الإضاءة الخافتة لمصباح الشارع الصغير الفاصل بينهما.
أشارت له بأصابعها أنها تريد لفافة تبغ، انتبه لها لكنه لم يحرك ساكناً، عبثت بخصلات شعرها بدلع أنثوي جميل، أشارت له مجدداً بأصابعها أنها تريد سيجارة، وهي تمط شفتيها بشكلٍ مغرٍ.
نجح المراهق بالسيطرة على ارتباكه وخجله، فتح شباكه وقذف لفافة التبغ إليها، فسقطت بحضنها، ابتسمت له، ثمّ أشارت إليه أنها تريد قداحة، كاد أن يرميها إليها، لكنها غمزته بخبث، وأشارت له بأصابعها أن يجلب لها القداحة إلى هنا.
ارتعش جسد المراهق، سرعان ما حزم أمره ومشى ليخرج من بيته، ويدخل باب العمارة على الرصيف الآخر، ليقف أمام باب بيتها في الطابق الأول.
فتحت له الباب فمد يده الحاملة للقداحة إليها، لم تأخذ القداحة، إنما التقطت معصمه وشدته إلى الداخل، ثمّ أغلقت الباب خلفه، ازداد ارتباكه ووجهه يتلون، بينما الأحرف المتلعثمة تضيع على شفتيه، عانقته فعانقها بشدة… سقطا معاً على الأرض، ودخلا معاً في حمى قبلات سريعة، وتقلبا فوق بعضهما في عاصفة حميمية اشتعلت فجأة.
أخذته إلى الغرفة، طلبت منه أن يجلس، ثمّ جلست في حضنه وأطبقت بشفتيها على شفتيه، وأنفاسهما الحارة تتسارع، لم ينطقا بأي حرف منذ أن فتحت له الباب.
داخ المراهق، ولم يعرف تحديداً ما الذي جعله يدوخ، لعابها الذي امتصه عن شفتيها ممزوجاً بالحمرة؟ أم رائحة عطرها؟ أم ارتطام صدرها من تحت الدانتيل الناعم به؟ أم جمالها وحرارة أنفاسها؟
فجأة، قطع عليهما دقائق القبلات التي لم يتذوق كلاهما مثلها في الحياة، صوت الدراجة النارية لزوجها وهو يدخلها إلى ممر العمارة.
شهقت بخوف، والفزع يحول وجهها إلى وجه آخر، وقد شوهته شاحنة رعب بعد أن دهست ملامحها، طلبت من المراهق وهي ترتجف خوفاً أن يندس أسفل السرير، فاستلقى بهلع على عجل، وحشر جسده ليختبئ تحت السرير، شعر أنه في ورطة حقيقية لن تمر على خير، خصوصاً أنه يعرف زوجها وطبيعته الشرسة.
دخل زوجها وصراخه يعلو، فهمت من شتائمه أنه تعرض لمشكلة في العمل، وتشاجر مع آخرين ثمّ رجع إلى البيت، أمرها أن تعد طعام العشاء له، كان أشبه بثورٍ هائج، جلس على السرير فتضايق المراهق من رائحة قدمي الزوج، وهو يحبس أنفاسه خوفاً من اكتشاف أمره.
عادت الزوجة سريعاً لتسأله إن كان يريد الشاي مع العشاء أم بعده، وهي تراقب بطرف عينها بداية العتمة تحت السرير، وقلبها يخفق بشدة ويكاد ينخلع عن صدرها.
انفجر زوجها مثل بركان وهجم عليها بغضب وهو يشتمها، ضربها بقسوة فسقطت أرضاً وهي تتوسل أن يرحمها، نزع حزام بنطاله وانهال به عليها وهو يركلها.
كانت مرمية على الأرض، تبكي مقهورة وتتألم تحت ضرباته القاسية، نظرت في عيني المراهق المختبئ تحت السرير، كان بينهما متر أو أقل، بكاؤها مزق قلبه، أراد أن يمد ساعده إليها ويلتقط يدها، ثمّ يشدها إليه تحت السرير، فيحميها من هذا الوحش… لكنه كان عاجزاً عن ذلك.
توقف زوجها عن ضربها بعد أن تعب، ليجلس على حافة السرير ويشعل لنفسه لفافة تبغ، ويتابع شتم زوجته.
على الرغم من أوجاعها نهضت بصعوبة وتوجهت إلى المطبخ لتتابع إعداد الطعام له.
تناول طعامه بسرعة وكان متعباً بشدة، سرعان ما أمرها بإطفاء الضوء حتى ينام، استلقت في عتمة الغرفة على سريرها من جهة الجدار، وجانبها استلقى زوجها… وسرعان ما غط بنوم عميق، وشخيره يعلو في الظلام.
بعد أن تأكدت من نوم زوجها، حشرت يدها بين الحائط والسرير، انتبه المراهق فالتقط كفها بين كفيه، وقبَّل أصابعها بصمت، وكأنه يعتذر منها لأنه لم يستطع إنقاذها منذ قليل، ظلت أصابعها بين أصابعه وقتاً طويلاً، وكأنهما يتبادلان الكلام بحركات أصابعهما المتشابكة، ثمّ مررت أصابعها على وجهه وعينيه، تحسس رأس إبهامها بقايا دموع على خديه، فاكتشفت أنه بكى بصمت منذ قليل لأجلها، مسحت على وجهه بحنان، سرعان ما التقطت كفه لتأخذه إلى الأعلى، وبمجرد أن طلع كفه من الفراغ بين السرير والحائط، راحت تقبله بصمت وتمسح به على وجهها، وتحطه تحت خدها وتشمه لتشعر بالأمان.
لم يناما في عتمة الغرفة في تلك الليلة، هي من فوق سريرها بجانب زوج يشخر بشكلٍ غليظ، وهو تحت السرير.
تارة هي تأخذ يده إلى الأعلى لتمضي معها لقاء رومانسياً يرمم روحها المهشمة، وتارة يأخذ هو يدها إلى الأسفل، ليترك أصابعها تتجول بحنان على ملامح وجهه.
حتى الصباح ويداهما تهبطان وتصعدان بين السرير والجدار، تتبادلان الأدوار، والكلام الصامت للأصابع، في عتمة الغرفة.
شعرت الزوجة أن يد المراهق هي غصن شجرة، تتعلق به خوفاً من السقوط في كابوس، له شكل زوجها.
والمراهق تحت السرير، كان متأكداً في كل مرّة تمشي فيها أصابعها على وجهه ببطءٍ، من الأعلى إلى الأسفل، أن وجهه آلة موسيقية وملامحه أوتار، وأصابع الزوجة تعزف على وجهه موسيقى جميلة، يسمعها جيداً.
في الصباح، انتبها لاستيقاظ الزوج الذي نهض وأسرع إلى الحمام، عندئذ قفزت عن سريرها، وانحنت لتشير إلى المراهق أن يخرج بسرعة.
أسرعا معاً بصمت إلى باب البيت، خرج المراهق وقبل أن يعبر بوابة العمارة، استدار إليها، تأملها وتأملته لثوان قليلة… ثمّ مضى.
لم يذهب إلى بيته، تمشى في ذلك الصباح في الشوارع وهو يدخن، كان يمشي مثل تائه… مستعيداً تلك الساعات التي أمضاها تحت سرير جارته.
وهو جالسٌ على الأرض شارد الذهن، رسم بأصابعه على التراب في الحديقة وجهاً يشبه وجهها، أيقن أن أصابعه خلال ساعات العتمة في الليلة السابقة، قد حفظت جيداً ملامح وجه جارته، تأكد أن لأصابعه ذاكرة تحتوي فقط على ملامح جارته الحلوة.
بعد أيام قليلة انتقلت جارته إلى حارة بعيدة، وقد عثر زوجها على بيت آخر قريب من عمله… من يومها لم يشاهد المراهق جارته الجميلة ثانية، جارته التي دخلت حياته لشهر فقط، ولكنه لن ينساها أبداً، وسيتذكرها كل يومٍ خلال السنوات التالية.
بعد سنتين حصل على الشهادة الثانوية، ولم ينقطع عن التجول في شوارع المدينة، على أمل أن يعثر عليها، هنا أو هناك، في السوق أو في هذا الحي أو ذلك المكان، لكن دون جدوى.
سافر إلى العاصمة ليدرس سنوات في الجامعة، ثمّ انتقل بعد تخرجه إلى قرية ريفية، ليعمل فيها موظفاً حكومياً لسنة ونصف.
في كل هذه الأمكنة، وفي تلك السنوات، وبكل الغرف التي عاش فيها، لم يغير عادته، سنوات مرّت وهو كلما أطفأ ضوء الغرفة في كل ليلة، وبدلاً من استلقائه على السرير، يحشر نفسه تحت السرير وينام، لعل وعسى خلال نومه تنزل أصابعها إليه، تماماً… كما حدث في تلك الليلة.
انقضت آلاف وآلاف الليالي، من غرفته في بيت أهله، إلى غرفٍ كثيرة في العاصمة، إلى غرفة في قرية بعيدة، وهو ينام تحت الأسرّة، وأصابعها التي يسميها في سرّه “أصابع السماء” لا تنزل إليه، من بين الجدران والأسرّة.
بعد أشهر قليلة من بداية الحرب، اعتقل مع شبان آخرين، وفي السجن عذبوه خلال أيام قليلة بشكلٍ وحشي، كسروا عظامه وشوهوا وجهه وأصيب جسده بجراح عميقة.
قبل أن يلفظ أنفاسه جروه من قدميه إلى غرفة المحقق، على أمل أن يعترف بشيء، هو الذي لا يعرف أيّ شيء، تركوه ممدداً على أرضية غرفة المحقق يلفظ أنفاسه الأخيرة.
انحنى المحقق عليه لكنه لم يسأله أيّ سؤال، تأكد من أنه يحتضر، ثمّ خرج بلا مبالاة من مكتبه وذهب إلى الحمام.
ظل وحيداً مستلقياً على أرضية غرفة المحقق، والموت يقترب منه، فتح عينيه بصعوبة فانتبه إلى سرير المحقق في تلك الزاوية، جرّ جسده متألماً، زحف ببطءٍ وأوجاعه تعوي كقطيع ذئاب في جسده، على الرغم من عظامه المكسورة، وجراحه، ودمائه المتخثرة، إلا أنه استطاع أن يحشر نفسه تحت السرير، حيث استلقى بهدوء.
بعد قليل… بدأت أوجاعه تتلاشى رويداً رويداً، ابتسم عندما لمح تلك اليد الأنثوية الرقيقة تنزل إليه من بين الحائط والسرير، لتبدأ أصابعها الناعمة بمداعبة وجهه.
شم أصابعها في شهيق طويل فانتشت روحه، وقلبه يخفق سعيداً خفقاته الأخيرة.
مسحت أصابعها الدماء المتخثرة عن وجهه بحنان، وأعادت ترتيب ملامحه التي شوهها التعذيب بحب، وكأنها أصابع سحرية، وبعد أن لمست شفتيه برقة، وكأنها تقبّل ابتسامته، تسلقت الأصابع الأنثوية وجهه إلى عينيه… وأغلقت جفنيه إلى الأبد.
سوف يحكي المحقق للكثيرين من معارفه، في سهرات ولقاءات مشتركة، عن ذلك السجين الغريب الذي تركه يحتضر في مكتبه، وذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة، عندئذٍ جرّ السجين جسده ليموت تحت السرير بشكلٍ غريب وغامض.
لكن المحقق لن يخبر أحداً من معارفه… أنه بعد رجوعه ودخوله مكتبه، كيف صرخ مرتعباً، عندما شاهد امرأة لا مثيل لجمالها في العالم كله، مستلقية على وجهها فوق سريره، لتستدير وترمقه بكراهية في ثانية واحدة، قبل أن تختفي فجأة… وكأنها لم تكن موجودة.
إسطنبول: 16/7/2019
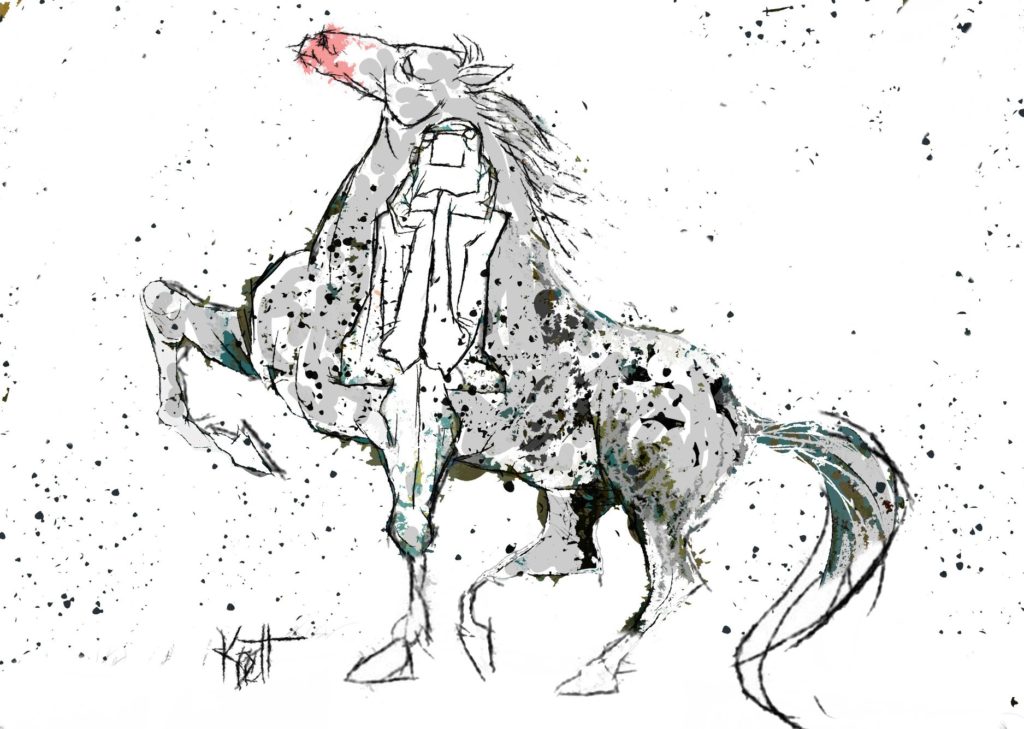
كم هم لطفاء
لدي معاناة حقيقية مع شعري عمرها عشر سنوات, أُطيله دائماً ونادراً ما أقصه إلا بشكلٍ طفيف.. لكنه جعد وأنا أريده أن يكون ناعماً كالحرير, وقد جربت معه خلال تلك السنوات العديد من الكريمات والزيوت, لكنه ظلّ جعداً, وعندما أكون في الشارع نسمة هواء بسيطة تكفي لأن تحولني إلى غول, فيهرب الأطفال من أمامي وكأنّ وجهي هو وجه (ميدوسا) ذو الأفاعي, آه ٍ من شعري الطويل أتعبني كثيراً ولم يصبح مثلما أريد.
اعتقلوني مساء البارحة, رئيس الدورية أمام باب البيت رحّب بي على طريقته الخاصة, استغربت منه.. فبدلاً من أن يصافح يدي, صافح وجهي بحرارة ليطير سنٌّ من فمي ويسقط على الشارع . ثمّة شعوب ــ كما قرأتْ ــ لديها عادات غريبة بالمصافحة كتقبيل الأنف، خمَّنت في سري أن يكون رئيس الدورية من تلك الشعوب.. ثمَّ ركلني بمحبة إلى السيارة وذهبنا إلى فرع الأمن, حزنتُ كثيراً لأجل سنّي المخلوع وتخيلتُ كيف سيدوسه أحد أطفال الحارة فيهرسه وهو يلعب بالكرة.
في الفرع رموني بمودة في زنزانة ضيقة فيها عشرات الشبان, استطعتُ بصعوبة أن أجلس في الزاوية.. كانت صرخات هائلة تقتحم جدران زنزانتنا من كل الجهات, حظهم جميل نزلاء الزنازين المجاورة, لديهم تلفزيونات وهم الآن يتابعون مباراة ريال مدريد وبرشلونة ويشجعون بصخب.
مرتْ ساعة وأنا أراقب من تلك الكوة في سقف الزنزانة, تسلُّل الليل إلى الفضاء, وثمّة ضوءٌ طفيف للقمر يعبر الكوة ليتناثر بين أجسادنا. صدفة ً.. لمحتُ على جدار ٍعن يساري عبارة (أنا أحبك يا لينا), كلمة (أحبك) جعلتني أتنهد, فتحتُ فمي والتقطتُ منه سنّاً آخر كان على وشك السقوط, ثمَّ نحتُّ بسنّي أسفل تلك العبارة ما يلي: (هذا الرجل يحبك يا لينا, عليك اللعنة, يجب أن تفهمي هذه الحقيقة, وعليك اللعنة أيضاً يا سميرة.. لأنني أحبك, لكنك تشبهين لينا ذلك الرجل). ثم رسمتُ قلب حب وثمة سهم غير مدبب مغروس به، انتهيتُ فوضعتُ سني بجيب قميصي.
آهٍ من الصبايا, إنهنّ لا يؤمنّ أبداً بأنّ (الرجل نصف المجتمع). كدتُ أن أختنق بسبب صمت الشباب, استدرتُ إلى يميني ثم شهقتُ وأنا أقول لجاري:
ـــ علي عقلة عرسان..! أنت هنا؟!. مرحباً..
ـــ يا هلا.. لكن أنا لست علي عقلة عرسان..
طبعاً هذه حيلة من إبداعي, كنت أمارسها دائماً في باص (الدوار الجنوبي) لأفتح حديث مع من يجلس إلى جواري. عندئذٍ فُتح باب الزنزانة وصرخ العنصر باسمي، شعرتُ بالسعادة نهضتُ وأنا أتمتم:
ـــ حان موعد العشاء..
مشيتُ نحو الباب, وقبل أن أخرج سألتُ الشباب:
ـــ أَ تُوصونني بشيء ؟.
بصراحة, خفتُ أن يطلب مني أحدهم كيلو برتقال أو كيلو تفاح أو كيلو ميشيل, فالسوق قد أُقفل منذ ساعات. لم ينبس أحد بحرف، تنفَّستُ الصعداء وخرجتُ. عندها ركلني العنصر على رجليّ فسقطت.. أمسكني هو من رجل, وزميله أمسكني من الرجل الثانية ثمَّ جرّاني وبسرعة في هذا الممر الطويل والمعتم. كم هما لطيفان.. لا يريدان أن أمشي حتى لا أتعب رجليّ, فعلاً أخجلني لطفهما.
في غرفة المحقّق, كان على الأرض شابٌ نحيلٌ وعار ٍ مضرج بدمائه ومغميٌّ عليه، وكان المحقق يصوره بعدسة جواله, عندما انتهى حمله أحد العناصر إلى الخارج. نظر إليَّ المحقق فابتسمتُ له, صاح بي:
ـــ لماذا شعرك طويل يا وغد ؟..
يا لله كم هي لطيفة هذه الـ (وغد) كلمة فيها موسيقى لبيانو حنون, إنها الكلمة المفضّلة لدى زوج خالتي, يدلعني بها عندما أكون شريكه بلعب الورق مع الأصدقاء.
ـــ لأن حلاق حارتنا معارض, وأنا أقاطعه منذ بداية المؤامرة الكونية على البلد..
ـــ معارض ؟!.. أعطني اسمه وعنوانه..
ـــ اسمه (تاج الدين الموسى) وهو يسكن في القبر الرابع عن يمين شجرة الزيتون في المقبرة الجنوبية..
المحقّق أعطى العنوان للعناصر وأمرهم بجلب المدعو تاج حالاً، فرحتُ كثيراً.. لديّ يقينٌ بأنّ الأجهزة الأمنيّة وحدها فقط تستطيع الوصول للعالم الآخر لتعيد لي أبي الذي توفي منذ عام.
ابتسم المحقّق بخبث وهو يربط يديّ إلى خلف ظهري, ثم التقط شعري الطويل وجمعه في كفه وربطه بحبل ثخين. بعد ذلك مرَّر هذا الحبل من حلقة معدنية في السقف، ثمَّ شدَّ الحبل هو والعنصر فارتفع جسدي للأعلى لأصير معلقاً بالسقف من شعري.. وااااااااو.. أدهشتني هذه الفكرة الظريفة وكأنني أرجوحة، صار المحقق يدفع جسدي إلى العنصر, والعنصر هو الآخر يدفع جسدي إلى المحقق وهما يضحكان كطفلين صغيرين. ضحكتُ معهما أعجبتني جداً هذه اللعبة, رحت أغني لهما أغنية (يارا) لكن، بعد دقائق تثاءب المحقق ثمَّ خرج هو والعنصر من الغرفة ليناما قليلاً. بقيتُ وحيداً هنا معلقاً بالسقف من شعري، حزنتُ، لماذا لم يبقيا ليلعبا معي؟. ماذا يخسران ؟. اللعبة كانت ممتعة لنا نحن الثلاثة، كم هو لطيف هذا المحقق.. لكنه ــ لسوء حظي ــ نسي أن يصورني بعدسة جواله, وبهذا خسرتُ فرصة نادرة لا تتكرر لأصير مشهوراً, تطاردني نظرات المعجبات حيثما ذهبتْ.
بعد بضع ساعات بدأ دمي يسيل من أعلى جبيني على وجهي, عندئذ ٍ.. اقتربتْ من وجهي بضع ذبابات وحطتْ على جبيني لتشرب دمي بنهم. ثمّة ذبابة منهن وبعد أن شربتْ طارتْ لتحط على أنفي، ابتسمتْ وقالتْ لي:
ـــ شكراً لك.. دمك نبيذ ٌلذيذ..
ـــ تكرم عينك صديقتي, أنا بخدمة الحلوين..
ـــ ممكن سؤال؟..
ـــ تفضلي..
ـــ هل تؤمن بوجود الله ؟..
ـــ ممممم.. بصراحة, وأنا معلق بهذا الشكل لا أستطيع أن أؤمن بأي شيء..
ـــ يعني أنتَ ملحد..
ـــ أتذكر أنني كنت مؤمناً يوم الثلاثاء الماضي..
صمتنا لدقيقة أنا وهي, زفرتُ ثم أردفتُ لها:
ـــ بصراحة صديقتي أنا لا أحب الإيمان من طرف واحد, أحب الإيمان والإيمان المضاد, ومنذ طفولتي أشعر بأن الله لا يؤمن بي..
ـــ ممممم…..
فجأة ً دخل المحقّق إلى الغرفة, فطارتْ الذبابات عن وجهي مذعورة, تلك الذبابة همستْ لي وهي تبتعد:
ـــ باي حبيبي..
المحقّق أمر العنصر بإنزالي وإرجاعي للزنزانة, كنت أريد أن أسأله بخصوص العشاء, لكن العنصر ركلني على رجليّ فسقطت, ليلتقطهما على عجل ويجرّني في هذا الممر الطويل والمعتم.
من باب إحدى الزنزانات على طرَفي الممر, تناهى لأذني صوت صرخات تشبه صوت والدي, فرحتُ جداً وصرختُ عليه :
ـــ كيفك بابا ؟.. لا تهتم, الشباب لطفاء جداً, اطمئن.. بعد قليل سيرسلوننا إلى تلفزيون الدنيا لنتحدث أمام الكميرا عن تجاربنا القصصية المهمة, ثم سنحصل على صورة تذكارية مع مذيع فقرة (التضليل الإعلامي) وبعدها سنرجع للبيت لنشرب عرق الريان.. لا تهتم, أ معك دخان ؟. سيجارتان فقط، برحمة الاتحاد السوفييتي, يستر على عرضك، خرمااااااان….
على ما يبدو أن أبي لم يسمعني بسبب صراخ مشجعي ريال وبرشلونة, كان العنصر يفتح باب زنزانتي وأنا مستلق ٍعلى الأرض أفكر بعمق:
ـــ عملية إرجاع والدي من العالم الآخر على يد الأجهزة الأمنية ستضع الفقهاء بموقف محرج للغاية أمام المؤمنين، أتمنى أن يلهمهم الله التفسير المناسب.
ثمَّ حملني ذلك العنصر الرومانسي بين ذراعيه كأنَّني عشيقته، ورماني بلطف إلى جوف الزنزانة.
على ضوء القمر الخافت والمتسلل من تلك الكوة بالأعلى, رحتُ أبحث عن علي عقلة عرسان, لكن أحد الشباب نقر على كتفي وهو يهمس لي :
ـــ هل لديك ثقافة جيدة بالجثث ؟..
ـــ نعم، فأغلب أفراد أسرتي ماتوا بين يدي..
ـــ إذا سمحت حاول أن تتأكد إن كان هذا الشاب قد مات أم لا, لأن نظري ضعيف. نظرت إلى حيث أشار لي, فلمحتُ ذلك الشاب النحيل والعاري، انحنيتُ إليه وحضنتُ رأسه وأنا أرفعه نحو ضوء القمر, اقتربتُ بوجهي من وجهه حتى لامس أنفي أنفه وأنا أمعن النظر في عينه, ثمَّ كان أنّ شاهدتُ وجهي بوضوح في عينه.
شهقتُ.. شعري الذي كان جعداً وكأنه قد صار ناعماً كالحرير. لم أصدّق, تركتُ رأس الشاب ليسقط ثمَّ تحسستُ شعري بكفيَّ.. عندئذٍ تأكدتُ أن شعري صار ناعماً كالحرير.
طار عقلي من الفرح, فوقفتُ في منتصف الزنزانة وأنا أضحك كمجنون, وصرتُ أصفق وأتمايل بطرب, الشباب صفقوا لي, حتى لينا وسميرة ــ من فوق ذلك الجدار ــ صفقتا لأجل رقصتي البدائية, رقصتُ طويلاً بجانب جثة الشاب النحيل, رقصتُ منتشياً كمهرجٍ مخمور.
بينما القمر، من هناك.. وعبر تلك الكوة الضيقة, راح يبكي علينا مزيداً من ضوئه.














