لا يخلو عالمنا العربي، من قصص وتجارب ملهمة لكاتبات عربيات، صاحبات أقلام شجاعة تحدين بطش السلطات، فكان مصيرهن الاعتقال السياسي والتعذيب والسجن لشهور أو حتى سنوات.
تختلف الدول والأنظمة السياسية وتتشابه تجارب الكاتبات المعتقلات اللاتي كانت أرواحهن عصية على الكسر وأقلامهن سلاحهن الوحيد في مواجهة قضبان الزنزانة وبطش السجان، فحولن قصصهن إلى أعمال أدبية رائعة، ضمن “أدب السجون”، خلدتها الذاكرة لتكون شهادات عن حقب فارقة من تاريخ أوطانهن.
تسع سنوات في جحيم سجون النظام السوري بلا ذنب!
وكان لسوريا نصيب الأسد من تلك الشهادات المرعبة والملهمة، ولعل أشهرها ما جرى مع الكاتبة السورية هبة الدباغ، الناجية من مجزرة حماة الكبرى في عهد حافظ الأسد عام 1982؛ حيث قتلت كل عائلتها، بينما كانت معتقلة بتهمة أنّ لها أخاً ينتمي للإخوان المسلمين، لتقضي 9 سنوات في سجون النظام.

وكتبت الدباغ بعد خروجها مذكراتها في روايتها “خمس دقائق وحسب”، على مدار ستة فصول تمثّل المراحل التي قضتها بالسجن، وتقول:
” اصطفت سيارات المخابرات على طول الشارع في منتصف الليل، وسألني رئيسهم أن أذهب معه خمس دقائق وحسب، فانتزعوني من الحياة تسع سنوات كاملات، دون أن أعرف سببا لذلك إلى اليوم”.
وتحكي الدباغ عن مشاهد التعذيب، قائلة: “تقدم العنصر مني وطرحني على لوح من الخشب له أحزمة، طوّق بها رقبتي ورسغي وبطني وركبي ومشط رجلي، ولما تأكد من تثبيتي، رفع القسم السفلي من لوح الخشب فجأة، فبات كالزاوية القائمة، ووجدتني، وأنا بين الدهشة والرعب، مرفوعة الرجلين في الهواء، وقد سقط الجلباب عنهما، ولم يعد يغطيهما إلا الجوارب والسروال الشتوي الطويل، ولا قدرة لي على تحريك أي من مفاصل جسمي”.
وتضيف: “أرى واجب الحديث عن مظالم النظام وانتهاكات الحقوق، حتى لا يضيع الكثير الذي بذلناه والكرب الجلل والعذاب الشنيع الذي نلناه… لقد عشت في جحيم سجون النظام السوري تسع سنوات رهينة بلا ذنب… لا أقدر أن أصف كيف تكون السنوات التسع من العمر حبيسة قمقم ملعون”.
السجن أخذ معظم سنين شبابي
أما الروائية السورية حسيبة عبد الرحمن، فتعرضت للاعتقال السياسي لأكثر من مرة، أمضت في سجون النظام أكثر من تسع سنوات بشكل متقطع، وبعد خروجها كتبت عن تجربة الاعتقال في أعمالها.

وتقول حسيبة لرصيف22: “الاعتقال جزء من حياتي، فقد تعرضت للاعتقال مرات عديدة، جلتُ معظم فروع التحقيق والسجون في دمشق، كان أطولها 6 سنوات، السجن أخذ معظم سنين شبابي.
كان اعتقالي الأول عند الحدود اللبنانية السورية، وأنا أحمل بعضاً من أدبيات حزب العمل الشيوعي، أخذتني دورية أمن الدولة ووضعتني بسيارة نمرتها أمنية، وكان إحساسي بأن الطريق الممتد من الحدود إلى مبنى أمن الدولة في كفرسوسة يعادل بعد الأرض عن القمر، تجول فيه سيناريوهات لا حدود لها، وتصورات عما ينتظرني وصور التعذيب المتوقعة، لكن الاعتقال بالنسبة لي متوقعاً بحكم انتمائي لحزب العمل الشيوعي المحظور، فالاعتقال في حالتي قدر كالموت المنتظر”.
وتضيف حسيبة: “وسائل التعذيب تطورت كثيراً من الدولاب والضرب بالخيزران في الاعتقال الأول، إلى دولاب وكبل رباعي وكهرباء في فمي وأصابعي بحيث فقدت الذوق ستة أشهر.
الكرسي الألماني والمقص، عدا عن المنفردة، ولهذا فهو الكابوس الأطول في حياتي ومرارته معجونة بطعم العلقم والدفلى معاً، فقد حفر أخاديد في الوجدان وندبات ثاوية في الذاكرة، بسبب تعذيبي المكثف وأيام العذاب والخوف والترقب المترافقة مع أصوات التعذيب للرفاق، المدماة أجسادهم و”المتكورين” حول أنفسهم، الزاحفين أرضاً لأن أقدمهم وأرجلهم لم تعد تحملهم، وصراخهم المقلوب عويلاً ذئبياً يخرق الأذن والوجدان، ودماؤهم عالقة على جدران وبلاط غرف التحقيق.
إذا استثنيت لحظات وساعات التعذيب تبقى وفاة والدي هي الأقسى عليّ، خصوصاً وزيارتي كانت ممنوعة، وأيضاً عندما مُسكتْ رسالة معي من الحزب أثناء زيارة والدتي الطاعنة في السن وأختي شبه الضريرة، واعتقال أختي لبضع ساعات ثم الإفراج عنها، وعندما ضربني مدير السجن المدني لتلاسني معه حول منع الزيارة، أحسست بالإهانة كونه خارج التحقيق، وأنا في سجن مدني! رددت له الصفعة بصفعتين، وأعلنا إضراباً عن الطعام استمر لـ10 أيام حتى وعدنا بفتح الزيارات من جديد”.
وتتابع: “الفرحة المفاجئة وشبه الإفراج فهي النقل للسجن المدني، بينما السجينات غارقات بهموم الحاجات الأساسية والقراءة والكتابة وحياكة كنزة صوفية، بينما الشارع حلم بعيد المنال، إلى أن نصبح خارج السجن، عندئذ نصدق أننا نطير بأجنحة نحو الريح.
وكانت أهم طرق مقاومة السجن بالنسبة لي الأعمال اليدوية والقراءة والكتابة وأن أفرغ دموعي العالقة على الورق، وهو ما دفعني بعد خروجي من السجن للملمة أوراقي، وكتابة روايتي (الشرنقة) عن سجن النساء، ثم المجموعة القصصية (سقط سهواً)، فحاولت إفراغ بعضاً من أثقال السجن على الورق، كي أمضي في حياتي”.
الوطن بالنسبة لي ليس مجرد حجر
وفي سوريا أيضاً كانت تجربة الكاتبة رغدة حسن، مع الاعتقال في سجون حافظ الأسد، وملاحقة بشار الأسد لها ليجبرها على الموت في الغربة.
دخلت رغدة، عالم المعارضة السياسية منذ الثمانينيات وانضمت لحزب العمل الشيوعي، واعتقلت في التسعينيات لمدة عامين ونصف، لتترك سوريا بعد نفي زوجها وتقيم معه في لبنان، ولم تعد إلا بعد وفاة حافظ الأسد.

وكشفت رغدة عن تجربة اعتقالها وأوضاع المعتقلات بسوريا في روايتها “الأنبياء الجدد” والتي تعرضت للمصادرة قبل نشرها، واعتقلت بسببها للمرة الثانية في عهد بشار الأسد عام 2010، وواجهت المحكمة العسكرية بتهمة نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة؛ لتسجن ثلاث سنوات، وأطلق سراحها بعفو عن معتقلي الرأي في 2011.
وتحكي الكاتبة في روايتها ما تعرضت له بعد القبض عليها، وحفلات التعذيب واقتلاع الأظافر، ثم نقلها إلى المشفى وإعادتها للسجن من جديد؛ قائلة: “جاء الجلاد الذي كان يعرف واجبه جيداً، فقام به على أكمل وجه، وراح يتفنن بتعذيبها باستخدام الكابل الرباعي مع الكرسي الألماني، كانوا يتقنون العمل عليها بحيث يصل المعتقل لدرجة الإغماء من شدة الألم المركّز في الظهر والطرفين السفليين حدّ الإحساس بالشلل، لكن إتقانهم لعملهم كان يحول دون حدوث ذلك”.
انخرطت بعد ذلك رغدة في أحداث الربيع العربي، و”اعتصام الداخلية” واعتقل زوجها وأحد أبنائها، فهربت الأسرة إلى لبنان، لكن رغدة عادت لسوريا تهريباً، وشكلت منظمة “شباب الحرية لقيادة الثورة من الداخل”. صدر بحقها حكم إعدام فاضطرت للعودة إلى لبنان، ثم فرنسا وتركيا، وكانت تردد: “أريد ان أموت في بلدي، الوطن بالنسبة لي ليس مجرد حجر. وطننا لم يتخل عنا نحن تخلينا عنه”.
قصة رغدة حسن كانت مصدر إلهام للمخرج البريطاني شون مكاليستر، حيث صورها في فيلمه “قصة حب سورية”، الذي حاز على جوائز كثيرة.
النقل إلى “سجن العواهر“
وفي العراق إبان حكم صدام حسين، تتشابه قصص معاناة الكاتبات المعتقلات مع مثيلاتهن بسوريا، وهو ما عكسه إنتاجهن في أدب السجون.
وتقدم الروائية العراقية هيفاء زنكنة شهادتها حول سجنها أثناء حكم البعث، بعد انتمائها إلى الحزب الشيوعي العراقي، عبر كتابها “بنات السياسة”.

وقدمت زنكنة في روايتها شهادات ست، إلى جانب أسباب سجنها ومدة محكوميتها، طرق التعذيب الوحشية التي تعرضت لها ومحاولة إذلالها من خلال نقلها إلى “سجن العواهر”.
أفلتت زنكنة من عقوبة الإعدام، بعد خروجها من السجن، هاجرت في 1975 إلى لندن، لتستمر بالكتابة وحث السياسيين العرب على تخليد تجاربهم في السجن والتعذيب، حيث أصدرت ثلاثة كتب جماعية تجمع نصوصاً لأكثر من 30 امرأة فلسطينية وتونسية، وهي: “حفلة ثائرة”، “دفاتر الملح” و”بنات السياسة”.
وتطرقت الروائية لتجربة اعتقالها في روايتها “في أروقة الذاكرة”، التي هي من روايات أدب السجون الأبرز بالعراق. تقول هيفاء زنكنة في روايتها: “علمنا بأنك اتصلتِ أثناء وجودك في السجن، بعدد من الكلاب والقوادين الذين تعرفينهم… ألا تدركين أننا نعرف كل ما تفعلونه! هل تظنين بأنك أكثر من قحبة عادية؟”.
ثم يطلب منها توقيع الاعتراف الأخلاقي الذي ظلت سلطة البعث تمارسه مع كل معتقل كي ترى السماء وتشم الهواء؛ حيث تقول: “أعطها ورقة وقلماً… اقتربي أكثر واكتبي: أنا الموقعة أدناه… عنواني… انضممتُ بتاريخ… وألقي عليّ القبض بتاريخ… وقد عثر على مجموعة القنابل والمتفجرات والمنشورات المضادة للحكم الثوري والجبهة الوطنية بحوزتي.
أعترف بكامل إرادتي، بأنني لم أنضم إلى الحزب لأسباب سياسية بل لمصاحبة وممارسة الجنس مع عدد كبير من الرجال. وأن علاقتي بمن تعرفت عليهم كانت لا أخلاقية. أعترف بأنني مارست الجنس مع فلان ولم تربطني بفلان أي علاقة تنظيمية. أقر أيضاً، بأنني لم أكن فتاة عذراء لحظة دخولي القصر وأنني عوملتُ معاملة حسنة من الجميع. وقعي الاعتراف وضعي التاريخ في أسفل الصفحة”.
شعبي كله فاقد لحريته
وتعتبر الكاتبة عائشة عودة أيقونة للنضال الفلسطيني، لكنها لم تكتب عن تجربة اعتقالها إلا بعد مرور 33 عاماً عليه؛ حيث أصدرت سيرتها الذاتية بجزأيها: “أحلام بالحرية”، “ثمناً للشمس”. وتقول عودة: “أدركت أن من لا يروي روايته بنفسه، فإنه يسمح لآخرين صياغتها على هواهم”.
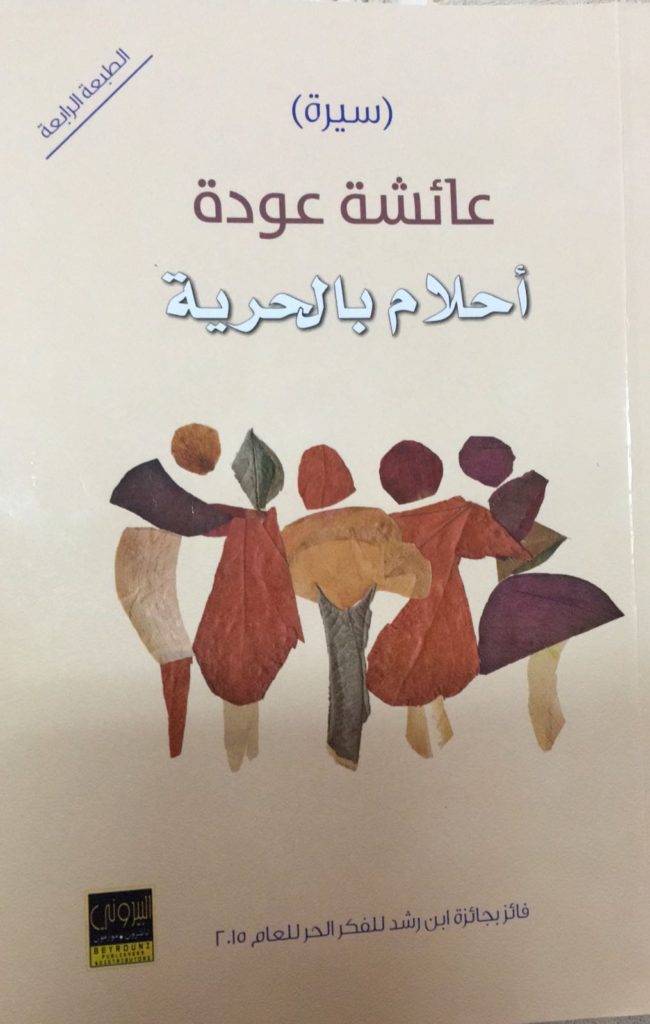
في كتابها “أحلام بالحرية” تحكي عائشة عن يوم اعتقالها في 1969، وكيف فضلت المواجهة عن الهرب حين عادت لبيتها وهي تعلم أن الجيش الإسرائيلي يحاوطه لاعتقالها، وكيف فقدت جزءاً من سمعها من كثرة الصفعات التي تلقتها والضرب بالعصى على رأسها، وتعرضت لأنواع الذل والإهانة وحرمت من النوم والأكل، حتى اضطرت تحت الضغط للاعتراف: “نعم أنا وضعت القنبلة… إنه أقل شيء أستطيع عمله من أجل وطني وشعبي”.
وتسرد عودة كيف كانت مترددة بين إنكار اعترافها أم تثبيته ودلهم على مكان الأسلحة، تعرضت للعزل الانفرادي، حتى فجرت فتاة قنبلة بالجنود. فأخذوا ينكلون بـعائشة، وجردوها من ملابسها وعذبوها حتى فقدت وعيها ونقلت للمشفى. وتحكي أيضاً قصص مجموعة من الفتيات المناضلات وكيف حرمن من أبسط الحقوق.
إذن هي الزنزانة
الروائية مي الغصين، إحدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات، وقد قدمت شهادتها في سيرتها الروائية “حجر الفسيفساء”.
تروي الغصين كيف تم اعتقالها على درج باب العامود بالقدس عام 1991، لتقضي عامين في السجون الإسرائيلية، قبل أن يتم الإفراج عنها في 1997، قائلة: “باغتني جندي من حرس الحدود وأمسكني بقوّة، وسحبني نحو الجيب العسكري، وأنا ذاهلة عما يحدث حولي، ثم دفعني بشدّة داخل الدورية العسكرية.
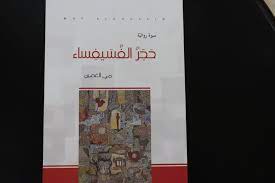
ارتطم جسدي بالكرسي، ما أدى لسقوط نظارتي الطبية على أرضية السيارة، حاولت التقاطها فلم أفلح، القيود تعيق حركتي، قدماي مقيّدتان، ويداي أيضاً مقيّدتان للخلف، حنيت جسدي جانباً، وبدأت أزحف على الكرسي ببطء حتى اقتربت منها… توجّه جندي نحوي مسرعاً، ليسحبها ويكسرها نصفين، وأخذ يدوسها إلى أن أصبحت حُطاماً. اقترب مني وانهال عليّ بلكماتٍ قويّةٍ مغلّفةٍ بسيلٍ من الشتائم البذيئة، ألم الدنيا بأسره تجمّع على وجهي… لم أعُدْ أشعرُ بأيّ شيء”.
وتقول: “مقيّدة اليدين والرجلين، مثبّتة كمسمارٍ فوق الكرسي لا أستطيع الحراك، كلما حرّكت يداي زاد ألمهما من القيد البلاستيكي. اقترب أحدهم منّي، لم أستطع تحديد ملامحه، لكنّي شعرت بنظراته الحادّة وكأنّه يحاول اختراقي، أنفاسه الكريهة تلفح وجهي، وسيلٌ من الأسئلة بدأ ينهمر كشلّال.
طلب من السجّانة تفتيشي، أظلمت الدنيا أمامي بعد أن وضعت كيساً قماشياً سميكاً على رأسي، ليس له لونٌ محدّد من شدّة قذارته، آثارٌ لبُقعِ دم قديمةٍ عليه، رائحة العذاب تفوح منه”.
وتضيف: “إذن هي الزنزانة… إذن هو اللقاء الأوّل وجهاً لوجهٍ مع الزنزانة في مركز تحقيق المسكوبيّة، والذي يُطلق عليه الأسرى اسم ‘المسلخ’ لما يُلاقونه من ويلات التعذيب النفسي والجسدي”.
وتوثق الغصين أنواعاً شتّى من التعذيب الجسدي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، كالضرب الوحشي، الهزّ العنيف، الشبح، الضرب على مؤخّرة الرأس، الحرمان من استخدام المرحاض، عدم السماح بالنوم، التهديد بهدم البيت أو اعتقال الأهل.
وحول كيفية تغلبها على أيام الأسر تقول: “كنت أرسم لوحات وتقوم زميلاتي بتطريزها، وكنا نصنع بطاقات معايدة من أوراق الرسائل ونرسلها إلى أهالينا خلال الزيارات. فالألوان تصنع بهجة في السجن، وعدت لهواية الرسم خلال فترة سجني، وبعد خروجي التحقت بكلية فلسطين ودرست الفنون الجميلة لمدة عامين، وصرت أشارك في المعارض الفنية، وشاركت في تأسيس مكتبة مع غيري من المتطوعين.
قبل السجن كنت أعيش في أحلام اليقظة، وبعد خروجي صرت قادرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بشكل أفضل وأشعر بأن لدي طاقة لعمل أشياء كثيرة”.
متآمرات ضد الوطن ومصالح الشعب
شهدت مصر في الفترة من الخمسينيات وحتى مطلع الثمانينيات، اعتقالات طالت كاتبات مصريات تحولن لاحقاً لأيقونات للنضال والحركة النسوية. وتعد الكاتبة الراحلة فتحية العسال، رمزاً للتحدي والصمود؛ حيث اعتقلت ثلاث مرات بسبب كتاباتها ودفاعها عن قضايا المرأة.

كتبت العسال تجارب اعتقالها وسجنها ضمن سيرتها الذاتية “حضن العمر” المؤلفة من جزأين، وتقول عنها الكاتبة الراحلة: “إن اللحظة الأجمل في حياة الإنسان هي التي يقفُ فيها أمام حقيقته عارياً، فيقبلها ويحبُ ما يشعر”.
وتحكي العسال كيف توجهت إلى الرئيس محمد نجيب لتطالب بتعميم المعاملة (أ) على المعتقلين، ولكن ينتهي الأمر بالزج بها في تخشيبة قسم المطرية لاسبوعين مع طفلها الرضيع. وتكشف تفاصيل سجنها عام 1954 لتظاهرها ضد الأحكام العرفية، ثم سجنت قبل العدوان الثلاثي في عهد السادات، بسبب معاهدة كامب ديفيد.
أما الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، فقد أصبحت رمزاً للحركة النسوية في العالم العربي بسبب نضالها الذي بدأ منذ الخمسينيات لأجل حقوق المرأة وضد ختان الإناث، حيث خسرت عملها بوزارة الصحة بسبب كتابها “المرأة والجنس”، ثم ُسجنت عام 1981.
تحكي السعداوي في كتابها “مذكراتي في سجن النساء”، تجربة اعتقالها وسجنها لبضعة أشهر، وأنها كانت منهمكة بكتابة رواية جديدة، في 6 سبتمبر 1981، حين سمعت طرقاً على الباب، وفوجئت بقوات الأمن تريد تفتيش المنزل دون إذن من النيابة، وحين رفضت فتح الباب، خلعوه واقتحموا المنزل، قائلة: “سمعت صوت انكسار الباب كأنه انفجار. أحذيتهم الحديدية تدق الأرض بسرعة كجنود جيش انطلق نحو القتال. هجموا على الشقة كالجراد الوحشي، أفواههم مفتوحة تلهث، وبنادقهم فوق أكتافهم مشهرة”.
وتسرد كيف تم اقتيادها إلى سجن النساء في القناطر، والتقت مجموعة من صديقاتها المعتقلات وفقاً لقرار التحفظ الذي أصدره السادات، بتهمة التآمر ضد الوطن ومصالح الشعب.
وتقول السعداوي: “لأنني ولدت في زمن عجيب يساق فيه الإنسان إلى السجن لأنه ولد بعقل يفكر. لأنه ولد بقلب يخفق للصدق والعدالة. لأنه يكتب الشعر أو القصة أو الرواية. لأنه نشر بحثاً علمياً أو أدبياً، أو مقالاً ينادي فيه بالحرية. أو له ميول فلسفية.
لأنني ولدت في هذا الزمن لم يكن عجيباً أن أدخل السجن. فأنا اقترفت الجرائم جميعاً.. الجريمة الكبرى أنني امرأة حرة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد”.
سنوات الجمر والرصاص
بينما شهدت المغرب في عهد الحسن الثاني، اعتقالات طالت كاتبات من أصحاب الرأي، وصارت سنوات حكمه الـ 38 تعرف بـ”سنوات الجمر والرصاص”.
وبعد رحيل الملك صدرت عشرات الكتب والأعمال الأدبية التي تتناول تجربة الاعتقال السياسي بالمغرب، وأشهرها: رواية “السجينة” للكاتبة مليكة أوفقير.
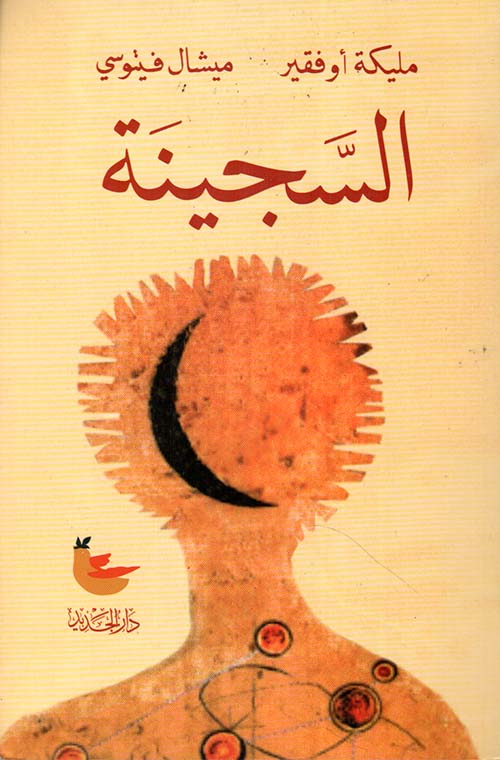
وتتناول الرواية سيرة مليكة، ابنة الجنرال المغربي أوفقير الذي كان مقرباً وزوجته من قصر الحكم، لكنه يقوم بمحاولة انقلاب فاشلة على الحكم، فيُقتل وتعاقب عائلته بالسجن عشرين عاماً، يقاسون فيها أشد أنواع الاضطهاد والألم.
بعد هروبها التقت مليكة بالكاتبة ميشيل فيتوسي، وبدأتا الكتابة معاً عن تجربة السجن عام 1998.
تقول أوفقير: “إني لأرثي لحال هؤلاء البشر الذين يعيشون خارج قضبان السجن ولم تتسنّ لهم الفرصة ليعرفوا القيمة الحقيقية للحياة”.
وتتساءل مليكة: “كيف لأبي أن يحاول قتل من رباني وكيف للأخير الذي طالما كان لي أباً آخر أن يتحول إلى جلّاد؟”.
تقص الأديبة المغربية زوليخا موساي الأخضري في روايتها “الحب في زمن الشظايا”، تجربتها الذاتية مع الاعتقال السياسي وكذلك فترة سجن زوجها.
وتقول الأخضري لرصيف22: “التقيت بزوجي ونحن طلبة، كان القطاع الطلابي بقيادة نقابته الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مرجلاً يغلي بالأفكار والمبادئ الثورية. كنت أعرف أن زوجي ينتمي إلى منظمة سرية تسمى ‘إلى الأمام’ قيادتها في السجون.
ولكن جاء اعتقال زوجي والحكم عليه باثني عشر سنة سجناً نافذاً قلب حياتي رأساً على عقب، ولكن اكتشفت أن قوة خارقة كامنة في أعماقي فتسلحت بها وأكملت مشواري.
وبعد سنوات من شدّ وردّ، من خوض إضرابات متعددة عن الطعام، في إحدى زيارات زوجي للطبيب وفي غفلة من الحراس استطعت أن أصبح أمّا للمرة الثانية.
كنت حاملاً في شهوري الأخيرة حين كتب أحد المخبرين تقريراً يتهمني فيه بالإساءة لشخص الملك، فاعتقلت بتهمة المسّ بالمقدسات التي كان الحكم فيها من سنة إلى خمس سنوات. اعتقلت أنا ورضيعي الذي لم يكن يتجاوز الأربعين يوماً”.
وتضيف: “يختلف الشعور حين يجد الإنسان نفسه وراء القضبان، ما جعلني أشعر بالضياع والحزن الشديد هو وضعية أبنائي، كنت أفكر في مصير ابني الأكبر والرضيع الذي سيتربى معي في ظروف السجن القاسية ولا أدري من سيتكفل بأطفالي، فأبوهم في السجن وأنا بدوري قد اعتقلت بتهمة خطيرة. ليس أمامي أي حل سوى الجنون أو الموت.
لم أكن قد استوعبت بعد فكرة وجودي في زنزانة ضيقة عفنة من دون فراش ولا أكل ولا إحساس بالأمان. الخوف من المجهول كان يشل قدرتي على التفكير ووجدت نفسي أعيش اليوم بيومه، كان إحساساً فظيعاً حين تغلق الأبواب ويعمّ السجن سكون المقابر”.
وتتابع: “حين غادرت أبواب السجن تلقفتني أمواج من الأحبة، استقبلوني بالورد والزغاريد وأنا أمشي بينهم مذهولة أحمل رضيعي بين يدي.
مرّ أسبوع وأنا لا أتذكّر أي شيء عن فترة التي السجن، ثم فجأة ذات صباح تذكرت كل شي: باب الزنزانة الحديدي الثقيل حين يفتح فجأة فيحدث صريراً تنقبض له النفس، صراخ النساء وبكاء الأطفال، الحارسات اللواتي كن يتفنن في تعذيب السجينات، نظرات الأطفال الجوعى الذين يتسللون لزنزانتي في غفلة من الحارسات. فجلست على أقرب كرسي وانخرطت في بكاء مرير. حينها أدركت أني تجاوزت محنة كانت أكبر مني”.
وتختم الأخضري قائلة: “أستذكر بعض الأشعار التي كانت الشهيدة سعيدة المنبهي تكتبها في زنزانتها، ومنها: تذكروني بفرح، فأنا وإن كان جسدي بين القضبان الموحشة فإن روحي العاتية مخترقة لأسوار السجن العالية وبواباته الموصدة، بأصفاده وسياط الجلادين الذين أهدوني إلى الموت”.
(رصيف 22)














