يصعب على المرء أن يستوعب قلق الفيلسوف الدانماركي سورن كيركغارد (1813-1850) أو كيركغور، كما ينطق به الدانماركيون، من دون الالتفات إلى الأنظومة النظرية الضخمة التي بناها هيغل في اجتهاداته الاحتوائية التي شاء بها أن يضم جميع تجليات الحياة طوال مسرى التحقق التاريخي الذي اختبره الروح في تضاعيف الزمان. هال كيركغارد الصرح الفكري الهيغلي الشاهق، فآثر الانزواء في كوخ يتيح له أن يصون ذاته المضطربة، المهجوسة، القلقة، المرتبكة، المتسائلة في غير اتجاه، السائرة على غير اهتداء. ناهض المذهب التاريخي الهيغلي، إذ اعتبر أن التاريخ ضرير النظر، أعمى البصيرة، لا يملك أن يستولد معنى الوجود الإنساني. ومن ثم، ليس للتاريخ أن يحكم على حياة الإنسان الفردية في عمق معاناتها الخاصة.
من عيوب البناء الجدلي المثالي الهيغلي أنه يلغي الإنسان الفرد، الموجود بذاته، المختبر خفقان الحياة في أضلاعه، المضطرم بحثاً مضنياً عن الخلاص، الملتهب خوفاً وارتعاداً. ما استطاع فيلسوف الذات الحائرة والوجدان القلق أن يستهضم الأتون الصاهر الذي قذف فيه هيغل تفاصيل الوجود، ومشاعر الباطن، وجزئيات الإحساس، وارتهافات الوعي الفردي. فناهض الكلية التاريخية القاهرة، وعارضها بإيمان الفرد التائق إلى التسامي الإلهي الخلاصي. ليس من نجاة يفوز بها الإنسان، وقد انعتق من أثقال الاجتهادات التنظيرية، إلا باحتضان نسمة الإيمان الجواني والاستسلام لسكينة الحقيقة الإلهية تنفخها فيه رحمة الله الواسعة.
نشأ كيركغارد في بيئة مسيحية بروتستانتية متدينة، متحفظة، متشددة، تهيمن على وعي أفرادها أثقال الخطيئة التي تضرب منعة الكيان الجواني. اختار في البداية سبيل اللاهوت، غير أنه ما لبث أن انغمس في ملذات الحياة، يغترف من الأطايب والمباهج والاستمتاعات ما وفرته له ثروة والده. أوشك أن يقترن بخطيبته رجين أولسن، غير أنه قطع علاقته بها في عام 1840 لأسباب غامضة قد يرتبط بعضها بالاختبارات الروحية التي استغرقت وجوده كله، وديدنه الوحيد الفوز بسلام الحياة الأبدية. في إثر ذلك، انكفأ إلى صومعته يتأمل في مقام الذات الإنسانية الفردية في كينونتها، المنفردة باختباراتها، المتفردة بخصوصيتها.
الإنسان كائن القلق
غير أن الإنسان يظل عرضة لاختبار القلق الكياني الأعمق الناجم عن تعطل الحرية الوجدانية. يقلق الإنسان ويضطرب من شدة خوفه وارتعاده، وقد أغمي على وعيه بسبب من جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. الإنسان مقلاق بطبعه. غير أن القلق الوجودي الذي يتناوله كيركغارد إنما يرتبط بالحال النفسية التي تسبق الشعور بالخطيئة الفردية السحيقة. ثمة قلق في توجس الشر، وثمة قلق في استشراف الخير. قلق الصلاح المرتسم في أفق الوجود يهذب الوعي ويقوم المسلك. ولكنه أيضاً قلق التطهر الذاتي من الأوهام الزائفة والضلالات الخداعة. وعليه، كانت المسيحية، في نظر كيركغارد، ديانة صون القلق التهذيبي الذي يدفع بالإنسان إلى إدراك معطوبيته الكيانية، والاضطلاع بمسؤولية حياته المشرعة على آفاق اللامحدود واللامتناهي.
خلافاً لسارتر، لا يربط كيركغارد القلق بالحرية، بل بالحرية المتعطلة التي تستبد بها الحرية عينها: “ليس القلق مقولة من مقولات الضرورة، ولا هو في المقدار عينه مقولة من مقولات الحرية. إنه الحرية المعرقلة، إذ إنها ليست حرة في ذاتها” (كيركغارد، مفهوم القلق، ص 73). ومن ثم، فإن القلق يقترن باختبار الدوخ أو الدوار الذي تستثيره الحرية في الذات الإنسانية حين تطل على اللانهاية المرتسمة في المدى الأبدي المشرع. في قلق الشر، يختبر الإنسان المؤمن ثقل الخطيئة في حياته، فيعتصم بالتوبة سبيلاً إلى التطهر. أما في قلق الخير، فيختبر المؤمن الخوف والارتعاد من الأبدية والرحابة اللامتناهية.
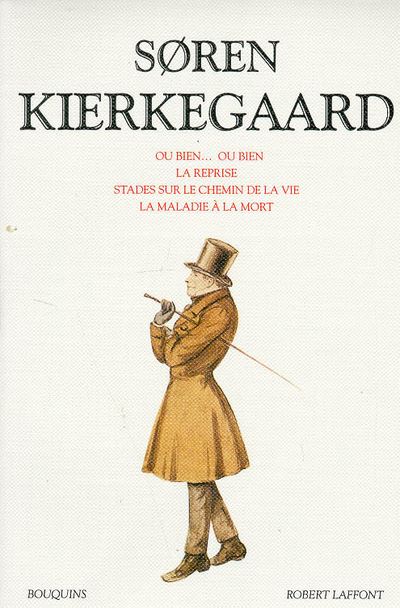
حين يدرك التائب أنه يستطيع أن ينعتق من سلطان الخطيئة، لا بد له حينئذ من أن يختبر قلق الخير والصلاح وجمال الإيمان بالله. لذلك يعتقد كيركغارد أن الإنسان يستطيع أن يحول القلق إلى خلاص بالإيمان الحر، إذ إنه كائن ثنائي القوام، تتساكن فيه الحيوانية والملائكية. فلا الحيوان قادر على اختبار القلق، ولا الملاك بحاجة إليه. وحده الكائن الحيواني- الملائكي يحيا حياة الإنسان المقلاق الذي يحول قلقه إلى طاقة استنهاض واستصلاح: “القلق إمكان الحرية. وحده هذا القلق ينشئ بالإيمان الإنسان على الإطلاق، إذ يلتهم كل المحدوديات ويعري كل الخيبات. وأي مفتش عظيم كالقلق يملك هذا القدر من التعاذيب الفظيعة؟ وأي جاسوس يعرف بهذا المقدار من الحيلة أن يهجم على المتهم في لحظة ضعفه عينها أو يغريه بمصيدة تأخذه على حين غفلة، على نحو ما يتقن القلق فن الإغراء؟” (كيركغارد، مفهوم القلق، ص 224). رأس الكلام أن القلق وجه سني من وجوه اختبارات الإنسان الأصيلة. لا يحمله كيركغارد حصراً على معنى السقم النفسي، بل يستجلي فيه أبعاد المعنى الوجودي الحق. لذلك استعارته المذاهب الفلسفية المعاصرة، كوجودية سارتر وأنطولوجيا هايدغر، ونصبته في صميم مبانيها مفتاحاً تأويلياً مغنياً.
في مواجهة المباني العقلية النظرية ينتهج كيركغارد سبيل الاختبار الوجودي الذاتي الفردي. في البدء كان الوجود الفردي، وجودي أنا بلحمي وعظمي، لا الأنظومة النظرية المجردة. والحال أن الوجود الإنساني يتلوى بآلام القلق والارتباك والضياع، تضنيه أسقام النفس الحائرة. لذلك لا يكف وجودي عن التعضل والتمزق والإعياء. من شدة اضطرابه، لا يملك أي كلام نظري أن يمسك به، إذ إنه كيان فريد، نسيج وحده، لا يمكن أن يغلق عليه في مفاهيم الاختزال والرد والقبض. ليس من سبيل نظري إلى ملاقاة التسامي الإلهي. وحده الاختبار الوجداني الباطني الشفاف يستطيع أن يختبر تجليات الرحمة الإلهية.
ومن ثم، يوقن كيركغارد أن الوجود الفردي لا ينسلك طوعاً في أنظومة نظرية مجردة، إذ إن العقل يعجز عن التفكر في فرادته، واللسان عن المجاهرة به. من صميم الذات الإنسانية تنبثق الإشارات الخفرة التي تحمل إلى كل إنسان حقيقته الوجدانية الخاصة التي تتيح له أن يفهم نفسه فهماً سليماً. وعليه، ليس الذاتية الفردية لحظة مؤقتة من لحظات الجدلية التاريخية الشاملة التي ينادي بها هيغل، بل هي حقيقة قائمة بذاتها يستحيل على العقل أن يهيمن عليها تنظيراً وتجريداً وإسقاطاً في عابرية حركة التصارع بين الكائنات.
أطوار الوجود الثلاثة
حين ينظر كيركغارد في مسرى الوجود الإنساني، يعاين ثلاثة أطوار يجتازها الإنسان قبل أن يبلغ اختبار الخلاص الأصدق والأجدى والأنقى. على طريقة فلاسفة تطور الوعي الذاتي، يستجلي الحال الأولى في اختبار الجانب الجمالي الحسي، حيث يطلق الإنسان العنان لرغبة الملذات المباشرة، تأخذ بمجامع فؤاده وتضرم في ضلوعه نار الاستزادة المنهكة. إنه حال الإغراء الذي شرد عقل دون خوان (دون دجيوفاني) المتهالك على اقتناص متع الحياة الزائفة. من الجماليات الحسية يمضي الإنسان إلى حال التخلق بأخلاق المبادئ والالتزام والرصانة، فيحث نفسه على الانضباط واعتناق مسؤوليات الحياة في وعي وتبصر ومواظبة. من أشد قرارات الحال الأخلاقية هذه إلزاماً عقد الزواج الذي يربط الرجل والمرأة ربطاً حازماً في سياق الزمن المنظور. غير أن الحال الأخلاقية الثانية المتزنة باليقين والثبات لا تستطيع أن تنجي الإنسان من اختبار انعطاب الوجود وزائلية الكائنات. فإذا به، في وثبة وجدانية أخيرة، يعزف عن اليقينيات المهتزة والبينات المريبة، ويرمي بنفسه في لجة المغامرة الوجودية الأصعب، زاهداً في حقائق الأرض ووقائع التاريخ، معتصماً برجاءات السماء المربكة ومفارقات الإله الذي يرتضي أن يتجسد في هيئة إنسان كامل القوام. مستنده في اختبار الحال الدينية هذه القلق البناء الذي يهذب وعيه ويشذب وجدانه ويطهر باطنه، في امتحان الخوف والارتعاد واختبار الإيمان المبني على التصديق العبثي.
حاله في هذه الوضعية القرارية حال إبراهيم الذي قبل بأن يضحي بابنه الخاص، من غير أن يفوز بيقين المعنى الأبعد الذي ينطوي عليه مثل الفعل العبثي هذا. ومن ثم، كان إيمان كيركغارد في الحال الثالثة، على غرار إيمان إبراهيم، منغمساً في اختبار العبثية الضاربة في جوانب الحياة. كلما احتدت عبثية الحياة على وجوده، سطعت حقيقة الإيمان الأبهى في وجدانه.
تنطوي أحوال الإنسان الثلاث على إمكانات الاختيار والقرار المتاحة المفتوحة. فإما أن يحيا الإنسان في ضيق اللحظة الراهنة (الطور الأول الجمالي)، ويخضع لوطأة اليأس من غير أن يبلغ في بحثه الوجودي شاطئ اليقين والأمان، إذ إن تناقضات الحياة لا تترك له سوى حرية ممارسة السخرية الفضاحة؛ وإما أن يقرر، في الطور الثاني الأخلاقي، أن يبسط كيانه ويحقق ما سيؤول إليه وجوده حتى يتبين له الفرق الشاسع بين الخير والشر، وذلك من بعد أن يعتصم بالقيم الأخلاقية، ذاهباً إلى أقصى درجات الاعتبار والاتعاظ، وقد طغت عليه سمات المزاح والفكاهة؛ وإما أن يعي وعياً حاراً، في الطور الثالث الديني، مقدار الخطيئة الشاملة التي تعطب الإنسان في صميم كيانه، فيلوذ بنعمة الخلاص التي يهبه إياها المسيح من على خشبة الصليب.
الخلاص بالإيمان الحر
في الطور الديني الأخير هذا، يتعين على الإنسان أن يقذف بنفسه في الخواء المقلق، أي أن يضطلع بمسؤولية التناقضات والمفارقات والتنازعات الأليمة التي تعتصر وعيه. بذلك يهيئ كيركغارد فكر الأزمنة المعاصرة الذي يروم صون الفرادة المنبثقة من وعي الأفراد. إذا كانت المسيحية، في نظره، تنطوي على أقصى ضروب التناقض في حقائق التجسد والفداء والخلاص والتأليه، فإنها أيضاً تهب الإنسان القدرة على تجاوز المعثرة واليأس، لكي يستشرف آفاق الرجاء المنغرس في صميم العبثيات التاريخية المتدافعة. ليس للذاتية الفردية من قوام حق بمعزل عن النعمة الإلهية. لذلك ينبغي الحرص على رعايتها وصونها حتى لا تسقط في محنة الانعزال والتعسف والافتخار الاعتباطي. إنها الصراط المستقيم والضلال المبين في الوقت عينه. في نور السمو الإلهي، تستطيع الذات الإنسانية أن تتجنب ظلمات الانغلاق وانحرافات الانطواء النرجسي.
كل حقيقة لا تخترق الإنسان وتهزه وتنعشه ليست بحقيقة على الإطلاق، إذ إن الإنسان وجود ينبض بالقلق، يبحث عن حصن يحميه من قرف العالم ودناءته الخسيسة. أخذ كيركغارد عن الفيلسوف الفرنسي باسكال اختبارات الذات القلقة والوجدان المضطرب والوعي الخطأ المستضعف، فألهم المذاهب الوجودية المعاصرة كلها، وألهبها بأنوار الباطن المهجوس برغبة الانعتاق والخلاص. ذلك بأن الوعي ليس كياناً صلباً منجزاً محققاً، بل هو مسرى مضطرب من الاختبارات الوجدانية والتمزقات الشعورية والتنازعات الروحية. وحده التناول الوجداني المباشر قادر على رعاية قلق الوعي الإنساني ومصاحبته في منحدراته وتسلقاته، في انقباضاته وانبساطاته. إذا كان القلق واليأس يحركان وجود الذات الفردية ويستجليان المسافة القاهرة بين الذات وعينها، فإن مغامرة الانفتاح الرضي على الإلهيات الغافرة والأبديات المتلألئة تتيح لكيركغارد أن ينعم بقسط من السكينة الوجدانية والسلام النفسي.
*اندبندنت














