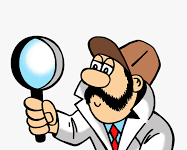ولدتني أمي ودخلت في غيبوبة، ثم لازمت الفراش لشهور لا تقوى فيها على إرضاعي. بعد ولادتي بثلاثة أيام ولدت جارتنا المصرية، فانتهت مشكلتي، إذ تولّت المصرية إرضاعي مع ابنها فيصل، فصارت أمَّاً لي، وصار فيصل وإخوته لاحقاً إخوتي في الرضاعة.
كنت أكبر ويكبر استيعابي لأحاديث أمي عن فضل أم فيصل عليها وعليّ، وهكذا صار لي أمّ بالدم وأمّ بالحليب، وكان يسعدني أنهما صديقتان حميمتان.
عرفت من أمي المصرية أن اسمها فهيمة أبو السعود، من مواليد بور سعيد عام 1917، وأنها تقرأ وتكتب، وقد كانت في ذلك استثناءً وحيداً بين نساء قريتنا، كما كانت استثناء في لباسها، وخبرتها بتزيين العرائس، وشالها الشفّاف الأبيض الذي تلفّه حول رأسها بطريقة سهلة على غير ما تفعله نساء القرية بأعصبتهنَّ وأغطيتهن السوداء السميكة.
مرة كانت تغنِّي “طار في الهوا شاشي.. وانتَ ما تدراشي”. سألتها عن معنى “شاشي”، فأشارت إلى غطاء رأسها.
أمّا كيف وصلت المرأة العظيمة فهيمة أبو السعود إلى قريتنا، فتلك قصة ولا الأفلام.
في فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في 8 حزيران عام 1941، قامت القوات البريطانية، مدعومة بقوات من “فرنسا الحرة”، بغزو الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة قوات فرنسية تابعة لـحكومة “فيشي” الموالية لألمانيا النازية. كان ذلك للحيلولة دون سماح حكومة فيشي بإنشاء قواعد عسكرية لألمانيا ودول المحور.
في ذلك الحين كان في منطقتنا شاب أسمر رمحيّ القامة يدعى محمد الكوسا، دخل مع من دخلوا في عِداد الجيش البريطاني، وقد ساقته المقادير بعد شهور إلى مصر، وهناك شاءت الظروف أن يلتقي بفهيمة أبو السعود وأن يتزوجا، ثم تسبقه إلى سوريا.
***
بعد قرابة عشرين عاماً من مجيئها إلى سوريا، ذهبت في أول زيارة إلى أهلها في مصر. تركتْ أولادها فيصل ونعيمة وأكرم عند أبيهم، وأخذت معها ابنتها الصغرى فقط.
حين كبرتُ وأصبحتُ موظفاً وقبضت أول راتب، سألت أمي إن كانت تفضل أن آتي لها بهدية أم أعطيها نقوداً لتشتري هديتها بنفسها، فقالت إنها تريد أن تشتري مخملاً يكفي لثوبين تقوم هي بتفصيلهما وخياطتهما، أحدهما لها والآخر لأمي الثانية أم فيصل.
وحين صار في قريتنا مدرسة للبنات، كانت أم فيصل، في بداية كل عام دراسي، تسارع في الذهاب إلى المدرسة ولقاء المديرة وبقية الآنسات، وتبلغهنَّ:
– زيّي زيّكم.. أنا برضو متعلمة، وعندي ابن شاعر قدّ الدنيا، وبينشر في الجرائد، ولازم تيجوا تتعرّفوا عليه.
مرة قالت لي:
– تفتكرني مش واخدة بالي.. المديرة برضو شاعرة، وغرقانة لشوشتها بيك. بسّ أمك خدّوج ماسكَهَالي حنبلي.
محبتي لأمي المصرية دفعتني لكتابة الشعر بالمحكية المصرية، بل دفعتني لحب مصر بأهلها ورواياتها وأفلامها.
في إحدى زياراتها لنا سألتها عن أعز الأمنيات التي تتمنى أن تحققها، فقالت:
– أزور بور سعيد. ما ظنِّش ألاقي أهلي، إنما يمكن أزور ترابهم وبعض قرايبي.
وعدتُها أن أتكفَّل بزيارتها لبور سعيد، وأن أذهب معها.
غير أن الحال، انتهى إلى الاعتقال، الذي امتدَّ وطال كما تقول الحكايات.
كانت أمي تحمل لي أخبارها إلى السجن:
– أمك المصرية بتسلِّم عليك، وبتقلّك ان زيارة بور سعيد بتتعوض. المهم أنك تكون بخير وتصبر وتشد حيلك وترجع لنا بالسلامة.
في العادة أنا لا أحتفل بيوم ميلادي. للحقيقة نشأت ضمن بيئة لا أحد فيها يعير بالاً للاحتفال بذلك، بل يندر أن يكون أحد قد سجّل أبناءه في الدوائر الرسمية بتواريخ مواليدهم الحقيقية، فالأمر مرهون بنزول الآباء إلى المدينة بين أسبوع وآخر أو شهر وآخر، وهناك يرمون نرد التواريخ التي يلهمها الله لهم، أو يساعدهم الموظّف على مقاربتها.
ورغم عدم معرفتي بتاريخ ميلادي الحقيقي إلا أني كنت أنوي أن أحتفل به لمرة واحدة، عندما أبلغ الأربعين وفق ميلادي المسجَّل في القيود الرسمية.
للأسف بلغتُ الأربعين وأنا في ذلك السجن الصحراوي الرهيب “تَدْمُر”، حيث لا مجال للاحتفال بغير بقائنا أحياء، ولكني رغم ذلك احتفلت بفكرة خطرت لي ويمكن أن توصلني إلى معرفة تاريخ ميلادي الحقيقي. كيف لم تخطر لي الفكرة من قبل؟!
لا بدّ أن أمي المصرية تعرف بالضبط تاريخ ولادة أخي فيصل، أعني لا بدّ أنها سجّلته في دفتر ما أو في ذاكرتها أو حتى دائرة النفوس. بيني وبين أخي فيصل ثلاثة أيام، فإذا عرفت يوم ميلاده عرفت يوم ميلادي.
كان عليّ أن أنتظر أعواماً طويلة قبل أن يُفرج عني، وأطرح السؤال على أمي المصرية:
– ماما بتتذكري بالضبط إيمتى ميلاد أخوي فيصل؟
– أمّال يا عين أمك.. أنا مش زيّ نسوان ضيعتكم.. أنا عارفة ميلاد كل واحد من ولادي.
– وهل مواليدهم مسجّلة في الهوية بالضبط كما هي؟
– بالطبع.. لا يوم زائد ولا يوم ناقص.
– طيب أخوي فيصل إيمتى؟
– أربعطعشر فبراير ألف وتسعمية وواحد وخمسين.
– إذن ميلادي 11 فبراير
– أيوه.. احْدَعْشَر بالظبط.
جميل أن يعرف المرء تاريخ ميلاده الحقيقي بعد أن أتمّ الخمسين من عمره، وقد كان أجمل لو استطعت تحقيق وعدي لها بأن آخذها لزيارة بور سعيد.
للأسف أني حين خرجت من السجن وجدتها مقعدة، ثم بعد سنتين رحلت، غير أن زيارة بور سعيد تبقى حلماً ووعداً عليّ.
*تلفزيون سوريا