قبل ستين سنة، وفي صفحات مجلة “الآداب” البيروتية، كتب الأديب السوري فاضل السباعي الذي رحل قبل أيام، مقالاً بعنوان “مأساة الكاتب العربي”، تحدث فيه عن مقومات وجود المبدع، فاشترط عليه الموهبة والثقافة والممارسة أو التجربة الحياتية، لكن جوهر ما أراد قوله تمحور حول ضرورة أن يتفرغ لفعل الكتابة، وألا تحاصره أقوال الآخرين بأنه يخسر الممارسة الحياتية عندما يفعل ذلك، فالتفرغ لا يعني انعزاله عن مجتمعه.
وفي سياق القصة كان على السباعي أن يتحدث عن قلة عدد القراء، وعن نوعية أولئك الذين يقرأون، فمستوى هؤلاء سيتحكم بشكل أو بآخر بمستوى الكتابة ذاتها! كما أن انكماش الناشرين عن النشر، لا بد سيؤدي بالإضافة على ما سبق، إلى توجه الكاتب إلى ممارسة أعمال لا تليق به وبإبداعه ورسالته!
الأديب اللبناني عبد اللطيف شرارة، تصدى للسباعي في مطالعته لمواد عدد المجلة، فاتهمه بالتغرب عن وسطه الأدبي، وأعلن أن سبب ذلك يعود إلى عقد المقارنات بين “أوضاع لا تقارن وأشخاص لا يقارنون”! كما انتقد تفكيره بعدم حصول أي أديب عربي –حتى ذلك الوقت- على جائزة نوبل للآداب، فهذه الجائزة، وبحسب شرارة إنما “تعطى لمن يخدم الغرب، والحضارة الغربية (…) ولم يسبق لشرقي أن نالها سوى طاغور، وقد نالها لأنه كان يحارب الفكرة القومية من جهة، ولأنه نقل منظومته من البنغالية إلى الانكليزية، وبهذا، انتفى عنه وصف الأديب الهندي، أي أن للاعتبارات السياسية واللغوية والمبدئية يداً طولى في منح جائزة نوبل، فلا يصح اعتبارها شهادة نهائية على سمو أدب من ينالها”! وفي نهاية رده يقول شرارة: “لا! ليس في حياة الأديب العربي المعاصر ما يدعو للرثاء والألم، ولا هو في واقع أمره في مأساة، فالمجتمعات العربية تتجه في طريق صحيح نحو الإفادة من الأدب، وإعلاء شأن الأديب، لكن عليها أن تمر بالصعوبات والمتاعب والمشاق التي مرت بها جميع الأمم المتحضرة الحديثة، وعلى الأدباء أن يتحملوا مما يتحمله غيرهم من ابناء الشعب وفئاته في جميع الحقول والميادين”!
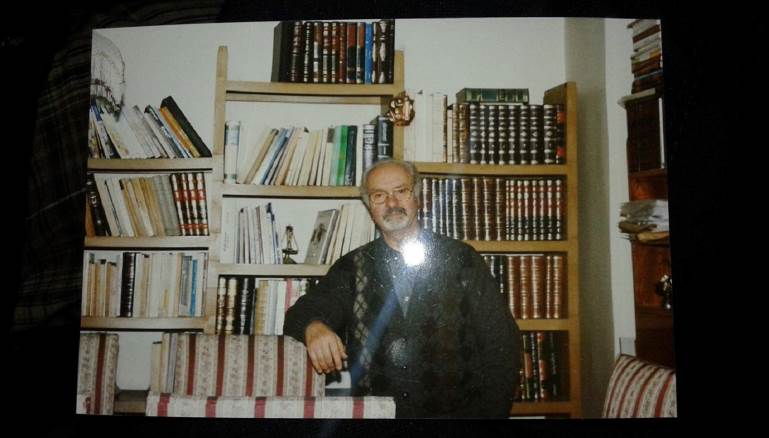
لكن رد فاضل السباعي لم يتأخر إذ كتب في العدد اللاحق، مقالاً مطولاً لم يخلُ من الحدة، فنَّد فيه حجج صديقه شرارة ووصف كلامه بأنه “نقد اتسم بطابع السطحية من جهة، وبالتعالي والتأستذ من جهة أخرى”، ثم ختم رده بالإشارة إلى صلب الخلاف فقال: “إن الأدباء العرب، يا صديقي عبد اللطيف يعيشون في مأساة، ومن بعض المأساة أن ينكرها أديب كنت أحسب أنه عارف بالأمور. وأما رميك إياي “بالغربة عن الحياة الأدبية” فذلك من بعض “الإرهاب الفكري” الذي يعانيه الأديب العربي المعاصر”.
وبعد 32 سنة سيرحل عبد اللطيف شرارة، بينما سيرحل فاضل السباعي عن عالمنا بعد ستين سنة من ذاك النقاش، وقد تغربت موضوعة جدلهما هذا عن واقع كليهما، وبينما كانت مفصلاً من مفاصل معاناة الكتاب العرب، سيشهد السباعي قبل رحيله كيف أن حياته ككاتب لم تعد محدودة بسقف الإبداع الذي كان مهجوساً به آنذاك، بل إنها ستتدحرج شيئاً فشيئاً في المنحدر ذاته للأنظمة المتتالية التي حكمت بلده وشعبه، وكذلك فعلت الأنظمة الأخرى، حتى بات الجميع أفقياً وعامودياً صرعى على خشبة مآسي المنطقة برمتها!
وبين موقف المطالبة بحقوق الكتاب وضرورة أن تتعاطى الدولة معهم، وكذلك المجتمع، على أنهم فئة يجب أن تتمتع بحقوق خاصة تضمن لهم توفير متطلبات الفعل الإبداعي، وهو ما كان يطالب به السباعي، وبين ضرورة ألا ينفصل هؤلاء عن واقعهم، وأن يعيشوا معاناة أفراد مجتمعهم وهذا ما كان يراه شرارة، كانت المسافة تتسع، إلى درجة أنها باتت تحتوي كل المفردات، التي تؤدي إلى انسحاق الجميع، تحت وطأة انهيارات الأوطان ودمار المجتمعات.
تُظهرالسيرة الذاتية للسباعي أنه كان مخلصاً لفكرته، إلى درجة تضحيته بالمواقع الوظيفية المهمة التي شغلها، في سبيل أن يحصل على فسحة احترام لما يراه أهم وأبقى، أي موقع الكاتب. لهذا سنرى أنه، وبعد تخرجه في كلية الحقوق-جامعة القاهرة، عمل محامياً ومدرساً في ثانويات حلب، ثم موظفاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبعد انتقاله إلى دمشق العام 1966، عمل في المكتب المركزي للإحصاء، ثم مديراً للشؤون الثقافية في جامعة دمشق. وفي العام 1982 طلب إحالته إلى التقاعد من آخر وظائفه في الدولة، كمدير في وزارة التعليم العالي، ليتفرغ للكتابة.
غير أن حساباته لم تكن دقيقة تجاه المعوقات التي يمكن أن تعطل الكاتب عن كتابته، وكذلك قد تمنع ابداعه من الوصول إلى جمهور القراء المحدودين عددياً. فعلى هامش مسيرته الوظيفية، كانت تتكشف أمامه حقائق أن عالم الكتاب ومؤسساتهم لا يمكن أن ينفصل على العلاقة مع السلطة، والتي ستتحول خلال عقود الستينيات وحتى الثمانينات من مجرد آلة لحكم الدولة والمجتمع إلى أن تلبسهما فتصبح هي الواجهة وهي الإثنين في الوقت نفسه.
وحول العلاقة بين الكاتب وبين المؤسسة النقابية (اتحاد الكتّاب العرب) التي ساهم في تأسيسها العام 1968، والنظام من خلفها، سيتحدث السباعي للصحافيين السوريين الذين كان يلتقيهم، ويجهر أمامهم بما يعتمل في دواخله، من غضب. فقد تم تجاهله طويلاً، كما أحيلت مؤلفات له مرات عديدة إلى الرقابة الرسمية، التي كان يتكفل بها وبشكل غير مقبول، زملاء له في الاتحاد نفسه، كما أن المواقف المتتالية كانت تكشف له أن القائمين على هذه المؤسسة تماهوا مع النظام ومؤسساته الأمنية حتى باتوا على يمينها!
فكم من كتاب رفضت رقابة وزارة الإعلام (وهي رقابة الإتحاد فعلياً) منحه تصريح الطباعة، قامت وزارة الثقافة بطبعه. فالمؤسستان بلغتا عتبة أن تكون كل منهما “دولة ثقافية”، لها قراراتها الخاصة، المختلفة عن الأخرى، لكنهما لن تحيدا عن كونهما أداتين للسيطرة بيد الدولة البعثية ذات القرارات والقوانين والتقديرات الخاصة! ومن ضمنها أن تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال السباعي في العام 1980 إثر لقاء طلابي في جامعة حلب، قرأ خلاله قصته الأشباح (ضمّتْها في ما بعد مجموعته: “آه يا وطني!”).
وعن هذه القصة سيروي السباعي تفاصيل في لقائه مع “القدس العربي” فيقول: “اعتقلت لأنني اجتمعت بطلاب كلية الآداب في جامعة حلب، مساء الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر1980، في (لقاء) على أحد مدرّجاتها، أتلقى منهم الأسئلة وأجيب عنها. وفي الختام قرأت عليهم قصة ضئيلة البراءة. اقتادوني يومها إلى زنزانة منفردة في معتقل (باب مصلّى) في دمشق، نمتُ على البلاط ونحن في عزّ الشتاء، بطانيّة تحتي وملتحفًا بأخرى، وكانتا في غاية القذارة، بعد الإفراج عني قلت، في إحدى الإذاعات الناطقة بالعربية: “فكأنهم يريدون لسجين الرأي أن يموت من القهر والبرد والجراثيم! وقد خرجت من الاعتقال أحمل في صدري فكرة قصة، كتبتها، وحفظتها في أوراقي، إلى أن آن لي – بعد 12 عاماً – أن أنشرها في كتاب عنوانه “بدر الزمان”.
وبالإضافة إلى هذه العلاقة المتوترة مع المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية، سيجد السباعي نفسه في مواجهة مع السياسات التي تتبعها دور النشر، إن كان في قضية حقوق الكاتب، أو قضية التسويق، ولهذا سيجد نفسه مضطراً لأن يقوم بدور الناشر فأسس دار إشبيلية العام 1987، التي نشر عبرها مؤلفاته التي كانت قد تجاوزت حتى ذلك الوقت الثلاثين كتاباً، ولم يمض سوى وقت قصير حتى بدأت الدار بنشر كتب مؤلفين آخرين، بعدما لفتت الانتباه بالشكل الفني الفخم الذي صنعته لمنشوراتها!
ظل السباعي، وحتى انطلاقة الثورة السورية، ضيفاً مرغوباً من قبل الوسائل الإعلامية السورية، رغم أن خطابه في غالبية الحوارات التي أجريت معه كان حاداً ضد اتحاد الكتاب العرب، وضد وزارة الثقافة، وضد السلطات الممنوحة لهما. وبينما كان محاوروه يحاولون إقناعه بأن مسألة التصرفات الفردية لهذا المسؤول أو ذاك، تشوه صور النظام أمام الوسط الثقافي، كان السباعي يحاول بلغته الأنيقة أن يمرر وجهة نظره المختلفة، وهكذا سنقرأ أجوبته في غير مكان إذ يقول: “السلطة لها وجوه وأيدٍ عديدة، يعني عندما يكون مسؤول ثقافي في مكان ما، مضى عليه عشر سنين أو عشرين أو ثلاثين سنة وهو يمارس، فهو ابن السلطة والدليل أنه لم يتغير تصوري، عندما أريد أن أطبع كتاباً عليّ أن آخذ موافقة الرقابة… لكن قبل ثلاثين سنة، أصبحت الوزارة تحيل المصنفات الأدبية إلى اتحاد الكتّاب العرب، هؤلاء ليسوا موظفين رسميين، لكن تلعب هنا العواطف الشخصية، يعني ممكن أني قدمت مرة مخطوطة إلى وزارة الإعلام من أجل أن تحال إلى الاتحاد حتى أنشرها على نفقتي، فالذي حصل أن الاتحاد رفض لأن هذا الكتاب جريء جداً، والذي حصل أنني تركته.. وما هو رأيك في ما بعد جاءني موظف محترم في وزارة الثقافة، أخذ هذه المخطوطة ونشرتها وزارة الثقافة، فكان هذا من التناقض الفاضح أن المؤسسة الشعبية التي من المفترض أن تدافع عني أنا الكاتب اعتذرت عن طبع الكتاب أو الموافقة على نشر الكتاب، لأنه جريء، في حين أن الحكومة، وهي أقسى علينا من المنظمة الشعبية، توافق على نشر الكتاب وينشر، وهو الألم على نار هادئة. إذن هذا التناقض لست أنا المسؤول عنه. لكن السلطة هي التي تجعل الاتحاد قاسياً علينا بهذا الشكل، وإلا فمن أين جاء الاتحاد برقابته القاسية وأحكامه الشديدة، لأن هذا الرجل معين من قبل السلطة، هل من المعقول أن مسؤولاً ثقافياً في الاتحاد يمضي عليه ثلاثون عاماً ولا يتغير”.
لم يتأخر فاضل السباعي في إعلان موقفه المعارض للسياسة الأمنية لنظام بشار الأسد تجاه الاحتجاجات الأولى العام 2011، وسرعان ما فُرز من قبل المثقفين المؤيدين للنظام، ضمن خانة الكتّاب المعارضين، فغاب عن الشاشات، وقل حضوره في الصحافة. لكنه، تحت ضغوط العائلة، وبعدما غادر أولادها البلاد، سافر العام 2013 إلى الولايات المتحدة، لكنه عانى هناك الغربة وعدم التأقلم، فعاد العام 2015، وكتب عن رحلته هذه في مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة!
لكن شكواه الدائمة من تفاهة مؤسسة اتحاد الكتّاب العرب، وتجاهلها له، رغم شهرته العربية والعالمية، جعلته في وسط دائرة التسديد والرماية لعدد من الإعلاميين والأدباء المؤيدين الذين لم يوفروه في صفحات التواصل الاجتماعي، وعرضوا به وبمواقفه مطالبين إياه بمغادرة البلاد والتوجه إلى إسطنبول للالتحاق بـ”المعارضين الخونة”. لكن الرجل لم يكن يخشى أحداً، حتى الموت. “أنا لا أخاف الموت”! هكذا قال فاضل السباعي، في واحد من أواخر اللقاءات الصحافية التي أجريت مع في سوريا، لكنه أضاف:” أتوقّعه في كل لحظة؛ لكنني لا أخافه… الشيء الوحيد الذي يرعبني هو أن أصاب بالزهايمر، أن أفقدَ قدرتي على الكتابة بسبب تهتّكِ الشبكيّة في عينيّ، وما يؤلمني أكثر هو أن أحداً لا يهتم من أحفادي أو أولادي بإكمال مسيرتي”.














