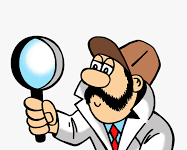في رحلة ما دون الشتاء والصيف، وجدتني بقافلة من الأفكار، أطل من نافذة في اليمن السعيد على مساء أرجواني، ونوافذ شاحبة بلا ضوء، لبنيان متقاعس عن النهوض، جالس كركام، عظامه بارزة، رغم أنه كان يكتنز يوما بالقاطنين. رأيتها هناك لا تزال صامدة! ذاكرتي مخاتلة وضعيفة، إلا أن للجمادات سطوة، تستفزها دون سلطة مني. فأنا ألمحها في ركن من العمر، لاهية بين شد وجذب، خفيفة وشفيفة، تغب النور والعتمة. وإن كان للذاكرة ما تؤمن به، فهو أن الشيء بالشيء يذكر.
في المبنى المقابل، استندت الستائر شامخة لكن وهنة، تفتتح مشهدًا على مسرح الذاكرة. لم تكن ترعبني الستائر، وكسائر الأثاث المنزلي، لم تكن في مقدمة أي مشهد يعبر ذاكرتي، حتى أدركت أن للنسيج قدرة أن يعاند حين يرضخ الحجر.
أدرك الآن بأن لها وجهًا آخر لم نكن نراه، ربما كانت للشبابيك المقدرة على تمييزه، يرعبني هذا الوجه، بعد أن أدركت بأن الستائر وحدها، من تصمد حيت تدركنا الفواجع.
في مخيلتي، كانت دومًا بيضاء واهنة، مثخنة بالضعف من وقوفها في وجه الشمس كل تلك السنين، يأكلها الضوء ورواياتنا التي لا تنضب. كنا نعلقها بسلك معدني أو بجسر، بضفتين منفصلتين، نفتتح النهار بفرق الضفتين قسرًا صباحًا، والعبور من ضفة إلى أخرى يعني أننا نحتجب عن المساء، وشفقةً نجمع الشتيتين.
كنت أسأل أمي: ما فائدة الستائر يا ترى؟ ولمَ نُسيّج أنفسنا بالنسيج؟ وتجيبني بأنها تحجبنا عن العيون المتلصصة، إلا أن العيون المتلصصة لم تكن إلا حجةً حتى لا نسقط ضحايا دارمتنا الذاتية، فالأعين المتلصصة يغبها الملل، أما الستائر لا يغبها شيء، تصر على حجب الرؤية عن الخارج، ولم أكن أعلم أن كانت تحجبه لؤمًا أم حبًا. لكنني كنت أنصت لحفيفها، أسمعها تكرر، شنقًا حتى الموت، نحن أم هي؟ لم أكن أعرف! إلا أنني، ببراءة، كنت أحاول أن أجد لها حاجة أو دورًا، فأسلمها رقبتي طوعًا! ألفها كرداء، وأركض خطوتين للأمام، وأصرخ: “أنا سوبرمان” حتى تثبتني في مكاني، وتطبق بقوة على نفسي. كيف كنت أسلمها رقبتي طواعية!
بل كيف كنا جميعنا، حين يجمر الصيف، ونقع ثملين من الحرارة، نستجدي نسيمًا عليلًا، نستلقي أنا وأخوتي تحت النافذة نحيط بوالدي، ونتبارك بالنسيم الذي مر به، نستجدي المزيد، والستائر مكرًا تحاول اعتراضها، فنحثه على أن يروي لنا قصة “تبرد على قلوبنا”. فيخبرنا أن هذا الشاش الأبيض من صنع جدتي، كانت تلقن كلَّ درزة “بسم الله”، بأنامل اعتادت الشهادة، وأننا اليوم نحلق في أثير مبارك وهكذا تقاس البركة بالمتر، أغمضوا أعينكم، وافتحوا قلوبكم، فنفعل، ونرفع أكفنا، نتشبث بطرفها، وندعو ألا تحملنا وزر المغيب، ولا فجاجة الشروق.
وتمتد القصة، عن أميرة اسمها ربى، قررت يومًا أن تلعب “الاستغماية” يوما، لا لتختبئ عن أعين الناس، بل ليجدها أحد ما، لتلتهمها الستارة مبقيةً على قدميها، لنستدل عليها. وينهي أبي القصة، بأني خرجت من الستارة كالشرنقة، وأنا أدرك أنني، حتى اليوم، لم يعثر عليّ أحد!
هل كانت، في تلك اللحظة، تحتضني لا تلتهمني، هل كان لا بد أن أنصت لها أكثر! هل تراها تفقه الحب؟ لا شك في ذلك. فهي طرف في علاقة دائمة مع النوافذ، لكن، هل كان حبًّا أم لقاء مدبرًا؟ ما أعلمه أنها شهدت الحب، وهي قادرة على أن تفضح عاشقين أو تسترهما.
في قول فيروز: “شباكي بعدو مفتوح، والبرداية عم تلوح، عرفوا بغيابي أهلي” كيف لم ندرك أنها من وشت بفيروز حين تسللت لعيد “العزابي” وحين كانت تلوح، كانت تنبه أهل البيت لهروبها. رغم ذلك، علينا أن نغفر لها صمودها بعدنا، كيف لا وقد مررنا خلالها دون أن نلاحظها، هي لا تزال واقفة على الأطلال، لتخبئ حبًّا جديدًا وتحتضن تائهًا آخرًا.
طال الموكب، حتى استيقظت النوافذ، منصتةً لبقايا الحكاية، وحزينة تنبهني بأن الستائر فارقتهم منذ مدة طويلة، وبأن النوافذ التي ثكلت زجاجها، غشيتها أقمشة من مستجيرين جدد، لا داع لإسدال أوجاع تحاول كل يوم تناسيها.
*الترا صوت