ترجمة عن الفرنسية: ابراهيم محمود
لا يمكن إنكار أن أنطوان ووترز وقع مع محمود أو صعود المياه إحدى أعظم روايات هذا الموسم الأدبي. الروعة الحقيقية للغة ، ملحمة ساحقة لرجل حوصر في أكثر من نصف قرن من التاريخ السوري ، أغنية عارية عن الطبيعة ترتجف أمام الإنسانية وغضبها من الدمار: هذه هي الكلمات التي جاءت لمحاولة نسخ القوة الحية لـ قصة تأخذ كل شيء في طريقها. نادراً ما يتم استدعاء التاريخ في الحاضر بهذه القوة والنعمة التي لا يمكن تجربتها إلا في التمزق المستمر. لم يستطع التشكيل أن يفشل ، خلال مقابلة مهمة ، في مقابلة أنطوان ووترز الذي يؤكد عدد كتابنا المعاصرين الرئيسيْن.
-يتعلق سؤالي الأول بنشأة محمود الرائع والظلام أو صعود المياه التي ظهرت للتو. كيف جئتَ بالرغبة في سرد قصة محمود الماشي ، الشاعر الذي عاش أكثر من سبعة عقود من تاريخ سوريا الحديث؟ أنت تشير منذ البداية إلى أن “أفكارك تمضي إلى المخرج عمر أميرالاي ، الذي كان لدورته الوثائقية حول سد التقبة أثر قوي عليك”: كيف ألهمك عمله؟ أخيراً، إلى أي مدى كان الشعر السوري الذي تستحضره خلال قصتك ، ولا سيما مختارات الشعر السوري المعاصر لصالح دياب ، من مؤثرات عملك؟
-في عام 2017 ، بدأت البحث عن سوريا. أردت أن أفهم ما كان يجري هناك ولماذا ، بعد 6 سنوات من رياح الحرية هذه التي عبَرت البلاد ، كان الناس لا يزالون يعيشون في الجحيم. لم تكن نيتي حينها أن أكتب رواية ، بل أن أغوص في هذا الواقع دون أن أبتعد. شيء يقود إلى شيء آخر ، ركزتُ في بحثي على سد الطبقة ، ربما أقوى رمز للنظام ، منذ أن أقامه حافظ الأسد فور تولّيه السلطة في عام 1970. الطبقة ، الشمال السوري ، تهيمن عليها اليوم القوى الديمقراطية والكرد. في ذلك الوقت ، سيطر داعش على المنطقة. لقد استولوا على السد وعبَّئوه بالمتفجرات ولم يتمكن أحد من القيام بأعمال الصيانة. ونتيجة لذلك ، صعود المياه. سوى أن بحيرة الأسد خزان مائي بمليارات الأمتار المكعبة. لذلك نقيس سخرية الوضع: المنطقة التي دمرتها الحرب كانت أيضًا تحت تهديد طوفان هائل. أثناء توثيق تاريخ السد اكتشفت سينما أميرالاي، الذي خصص ثلاثة أفلام لـ “مشروع الفرات” ، حيث عمده حافظ إلى رغبته في “تحديث” البلاد. ويعود تاريخ الفيلم الأول إلى عام 1974 ، أي بعد عام من الافتتاح ، والغريب أنه فيلم اعتذاري. نرى كيف أن السد سوف “يطوّر” الناس ويجلب لهم التقدم والازدهار. ثم تراجع أميرالاي عن انتقاده لسياسة البعث التي كان يؤيدها بسذاجة ، وكل أعماله ستدين دعاية الحزب. وفي فيلم “طوفان في أرض البعث ” ، هناك مشهد يروي فيه رجل عجوز ، على متن قارب ، كيف أغرق إنشاء البحيرة حياته. وولد هناك “محمود”. وبقي صوت الرجل العجوز معي ، لقد تعلَّق بي ، لدرجة أنني أخبرت نفسي أنني سأكتب لإطالة كلماته ، لأجعله يتحدث عن حياته ، وحبه ، وهذه سوريا العزيزة والمؤلمة للغاية على قلبه. وتوفي عمر أميرالاي في شباط 2011 ، على أعتاب الربيع العربي. مما يعني أنه لا يستطيع تصوير الفيلم الذي سيظهر ما تمر به سوريا الآن.
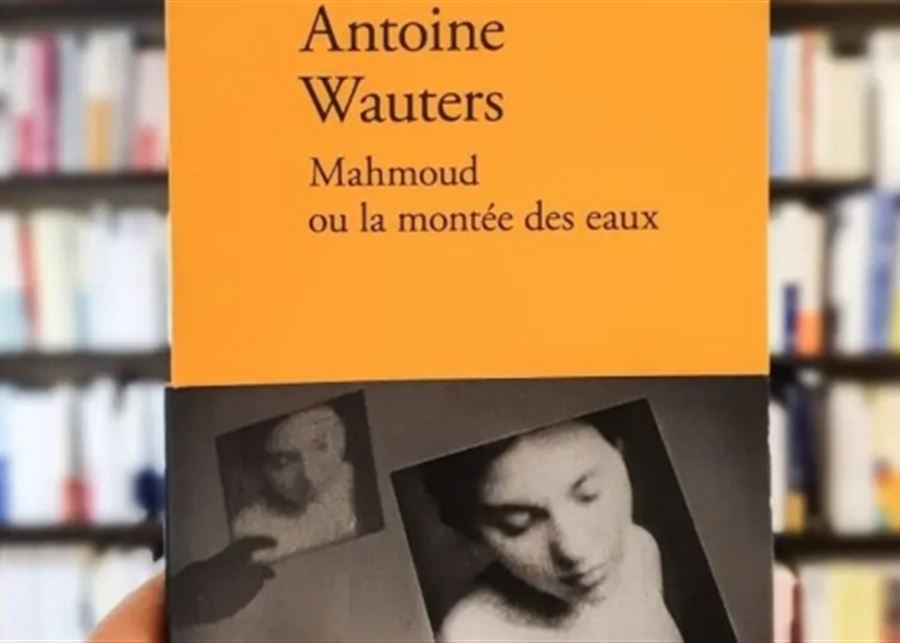
وعندما علمت بوفاته ، قلت لنفسي إن علي أن أنهي فيلم “محمود أو المياه الصاعدة” في ذاكرته.
أما بالنسبة للشعر ، فأنا مدين حقًا بالكثير لصالح الشاعر والمفكر السوري صالح دياب الذي يعيش الآن في فرنسا والذي أتيحت لي الفرصة لمقابلته خلال إقامته في بيت الشّعر في أماي. كانت المقتطفات التي نشرها لدى كاستور نجمي هي التي دفعتني إلى الاهتمام بالشعر السوري المعاصر. ويرتبط شعر نزيه أبو عفش ارتباطًا وثيقًا بما يحدث منذ عام 2011. وبعد ذلك كل هؤلاء الشعراء الذين حبسهم النظام وعذبهم والذين لسوء حظهم الوحيد أن يكتبوا ما كان في قلوبهم. .
-وللوصول إلى قلب روايتك دون تأخير ، يروي محمود أو صعود المياه قصة رجل ، مسن الآن ، يتذكر حياته الماضية ، يجدف على متن قارب في بحيرة الأسد ، منذ عام 1973 ، تغطي قريته التي غمرها بناء سد الطبقة. ولكن إذا كشف محمود أو صعود المياه قصة محمود المعذبة ، فإن القصة هي أيضًا قصة تاريخ بلد ، واضطرابها ، وحروبها ، وكرهها وحبها. ونشعر أكثر من أي وقت مضى أنه في قلب هذه القصة ، يستحيل الفصل بين الحميمي والسياسي بحيث يُعطى محمود أو المياه الصاعدة كنهضة نحو التاريخ العاري للأمة السورية ، حيث حياة لا يفشل محمود في أن يمزقه مصير البلد الذي يتزوج منه رغم كل الآلام. “من الذي ليس له سوريا في دمائهم؟ “، يمكن أن يكون هذا هو نقش قصتك. سيكون سؤالي كالتالي: بأي طريقة ، من خلال قصة محمود ، كان السؤال بالنسبة لك أن تقترح ، من خلال رشقات نارية وانفجارات ، نوعًا من الرواية المضادة لسوريا ، والتي يمكن أن تستحضر بالضبط ما هو الشعر أو الأدب الرسمي النظام لا يقترح أي أن هذا البلد “إعلان عن الموت”؟ أخيرًا ، هل رواية قصة سوريا كما تندمج مع هذه الملاحظة الواردة في قلب الكتاب والتي ربما توفر الحاجة الشديدة لها: “التاريخ لا يحتاج إلى أن يُروى”؟
لن أقول إن كتابي عبارة عن سرد مضاد. وأعتقد أنه يملأ الفراغ في الغالب. من يتحدث عن سوريا اليوم؟ من يهتم بمصير الأطفال؟ نقص الماء والطعام؟ بالطبع ، إذا اعتبرنا أن كل شيء في أداء عشيرة الأسد مخفي وسري وخطأ ، فإن كتابي هو بالفعل رواية مضادة. حافظ وجهازه الاستخباري القوي للغاية ، بشار وانتخاباته الوهمية الحرة والديمقراطية ، أسماء وابتسامتها الحلوة. محمود يعلم. إنه يعلم أنه حتى عندما تبتسم لك بكل أسنانها البيضاء الجميلة ، فإن الديكتاتورية تظل ديكتاتورية. تحتل سوريا في إعلامنا الغربي مكانًا صغيرًا فقط.
وعندما نتحدث عنها ، على سبيل المثال في الذكرى العاشرة للصراع (كما لو كانت ذكرى سنوية …) ، فهي في وضع بارد ومنفصل: حقائق ، أرقام ، وفيات ، مدن مدمرة. ثم ننتقل. لقد كتبت هذا الكتاب لأن الأرقام ليس لها ذاكرة وتولد النسيان. أردت أن أخترع قصة على هوامش قصة وسائل الإعلام ، والتي من شأنها أن تخلق الإنسانية والتعاطف. إن الطريقة التي يتم إخبارنا بها عن العالم أمر بالغ الأهمية ، وهي موجودة ، ولهذا السبب يجب على الأدب أن يقدم رواياته المضادة. وكلمات أخرى ، لجعل الأشياء تبدو مختلفة. للتحدث إلينا. ولهذا أردتُ أن أخبر سوريا بكلمات شعرية. وكلمات بسيطة يومية للتحدث عن الأشياء بشكل مختلف. وهذا بالضبط ما يفعله محمود. إنه مثل الجد الذي يخبرنا عن حياته دون أن يحاول تجميلها. قلت لنفسي إنه ربما يترك فينا المزيد من الآثار ، وأن الشعر في بعض الأحيان يذهب إلى أبعد من الصحافة. وأما الارتباط بين الحميمي والسياسي فلا مفر منه على الإطلاق: من المستحيل فصل حياة محمود عن حياة سوريا. بعد كل شيء ، هم في العمر نفسه. منذ وجود سوريا ، رأى محمود أنها تتغير. ورأى ثورات ودعوات للحرية وأحلام ثم هزائم. وأعطتها سوريا كل شيء وأخذت منها كل شيء. إنه رجل محطم ولكنه يستجيب للألم بلطف. إنه على قاربه ، وهو يغوص ، ويجدف ويتحدث مع المرأة التي تطارد أفكاره ، إلى سارة. ويفعل ذلك بالضبط. وهي رسالة حب. وتحدثوا إلى موتانا حتى لا يموتوا بموتهم. ولا تنسوا الذين تعرضوا للضرب قبل السقوط: عبد الباسط ساروت (حارس مرمى سابق أصبح شخصية احتجاجية وقتل في المعركة) ، إبراهيم قشوش (الذي كلفته أغنيته المعادية لبشار حياته) ، مقاتلون كرد… إلخ.
-بعيدًا عن السيرة الذاتية السياسية للبلد ، ما هو ملحوظ أيضًا ، منذ البداية ، في قصتك هو أن قصة محمود لا تتخذ سوى مقياسها الكامل في العلاقة الحيوية والمتوترة التي يحتفظ بها ، كشاعر ، بكتاباته الخاصة. وفي محمود أو صعود المياه ، تُعطى كتابات الشاعر كبديل لتاريخه الشخصي ولكن أيضًا لعلاقته بتاريخ بلده. والكتابة هي أولاً وقبل كل شيء مكان الثقة الساذجة والعمياء في الكتابة نفسها ، حيث إنها بالنسبة للشاعر سؤال ، في سنوات شبابه ، عن التقدم الاشتراكي للنظام. ولكن ، شيئًا فشيئًا ، تتعقب شفافية الكتابة نفسها بسبب التعتيم المتزايد حيث تصبح الكتابة موقعًا لانعدام الثقة أو بالأحرى تثبيطًا للشاعر للنجاح في إخبار العالم أو مجرد “فك رموز كلمات بحيرة “. كيف كان من الضروري أن تحكي قصة محمود من خلال هذه العلاقة ، وكلها في حالة توتر وإحباط وفرح وإحساس ، يتعايش معها بالكتابة؟
إنه سؤال صعب .. ما أستطيع قوله هو أن محمود أحب الكتابة. لجأ إلى كوخه بالقرب من البحيرة وكتب هناك. لقد وثق بالكلمات. ولم يستطع العيش بدونها. كانت الكتابة حرية على هامش مهنة التدريس. وكان يكتب حياً. وبينما عندما كان يعلّم ، لم يكن في فمه سوى كلمات النظام ، كلمات الدعاية ، كلمات الموت. لم أر قط رئيسًا حكيمًا مثل الرئيس الأسد. ولم أر قط قائدًا مثله طوال حياتي. لم أرَ شخصًا مثله من قبل “. وبالنسبة له ، الكتابة مكان للمقاومة. وتتحدث قصائده عن الحياة اليومية ، لكنها طريقته في القتال ، مقاومة لطيفة. لنرى ما لا يراه أحد ، ليجد ما يبقى خفيًا جميلًا ، ضفدعًا تحت حجر ، وبعد ذلك ، على الرغم من كل ما سلبه هذا السجن ، لا يستسلم: البقاء على قيد الحياة. لكنك على حق ، تتغير علاقته بالكتابة. إنه حذر من ذلك. لم يعد لديه القوة والشجاعة لكتابة الكلمات. وقال في نفسه: ماذا لو كانت الكتابة مجرد اندفاع متهور مثل الآخرين؟ المزيد من الجبن؟ يشك. إنه شيء يناسبني أيضًا ، يجب أن أقول. لم تعد علاقتي بالكتابة كما كانت في الماضي. كأنني أردت المزيد والمزيد من الصمت. مثل محمود ، نعم ، كلما تقدمت في السن ، كلما أجد أجمل ما في الكتابة ، هذا كل شيء ، إنه صمت أحتاجه. ثمة مكان لا يحدث ضجيجًا ولا ألمًا ، لا نقص ولا ندم. إنها مفارقة بالطبع: الكتابة لتنتج الصمت … لكن هذا صحيح. وعندما يغوص محمود أو يتجاذب الصفوف ، يحل محل كل من يكتب (أو يمشي ، أو يحلم ، أو يرسم ، أو يصلي). مكان صمت على مفترق طرق العوالم. في الواقع والخروج منه. وجدت الصورة بسيطة وجميلة. ولأنه عندما تقضي كل هذا الوقت في الكتابة ، ينتهي بك الأمر حتمًا إلى العيش مثل محمود. وهذا يعني ، أسفلنا المنزل الغارق لطفولتنا ، حيث تسبح جميع أنواع الأسماك والبرمائيات. وفوق هناك السماء ، الأشياء هنا والآن ، مادة ، صرخات ، عنف ، طيور. في الواقع ، كانت بحيرة الأسد هي المكان الوحيد الذي يمكنني فيه سرد هذه القصة بدقة. ليس قريبًا جدًا ولا بعيدًا جدًا عن الواقع. وفي الوسط كومة.
-بعيدًا عن الطريقة التي ترافق بها الكتابة الحياة وتنسجها ، بيت شعري بعد بيت شعري وقصيدة بعد قصيدة لمحمود ، تثير قصتك أيضًا السؤال الذي كان يطارد قصصك السابقة بالفعل: بأي طريقة ، بخلاف أي سيرة ذاتية ، تقدم الكتابة نفسها أعلاه كل هذا ، حسب رأيك ، كضرورة وجودية عنيفة ، والتي ، كما تقول في محمود ، “تطارد الظلال”؟ ما هي الظلال بالضبط؟ أخيرًا ، بأي طريقة ، كما يفعل محمود ، على مضض تقريبًا ، التجربة المزعجة ، فإن الكتابة هي النقيض الدقيق للسيرة الذاتية ، حيث إنها ممكنة فقط بشرط اختفاء الموضوع لأنه ، كما تقول ، “الكتابة : أشعر بأنك غير موجود “؟
الكتابة تصطاد وتحافظ على الألم. وتساعد على العيش وتقتلك. إنها شيء غامض. الكتاب كله يدور حول فكرة التخلص من الألم والنقص الذي يعود باستمرار ، لأنه من المستحيل ألا يعودوا. كيف تنجو من غياب أطفالك؟ كيف نعيش في عالم ينجو من موت الأطفال؟ كيف لا تغضب من الألم؟ هذا هو السؤال الذي يطارده. ويحلم به. إنه مهووس بوجوه ابنيه وابنته التي يراها مرة أخرى عندما كانا صغيرين. أليس هذا هو التقدم في السن؟ أن تطاردك الأمواج العائدة من الماضي؟ مليئة بالماضي فلا مجال للحاضر؟ “أشعر بعدم وجودك”. بالفعل. للكتابة ، تحتاج إلى عجز في الوجود. عدم القدرة أو عدم الرغبة في قول “أنا”. على أي حال ، بالنسبة لمحمود ، من الواضح أن الكتابة هي فعل استماع أكثر من كونها وسيلة للتعبير عن وجهة نظر. بالنسبة له ، الطبيعة لديها ما تقوله عنا أكثر مما تقوله عنها. البحيرة تراقبه تسمعه. إنها ذكرى. بالنسبة له ، الكتابة ليست نشاطاً. إنه بلد. الأرض التي ما زال فيها الموتى يتشبثون بك ، مثل الأعشاب البحرية. تكتب وتتخلص منها. تتوقف عن الكتابة وتفوتك لمسة الأعشاب البحرية. أرض الحنين. أنت تغوص ، أنت مرغِم عليه. وتكفي بضع ثوانٍ لتحويل الرجل العجوز الذي دمرته الحرب أنك ، إلى طفل في السابعة من عمره ، بالقرب من شجرة البرقوق حيث صعد والدك بمساعدة السلم ، في الضوء ، أصوات والدتك في الحمام ، إلخ. هذا هو جمال اللفتة. تسمح لك الكتابة بالانتقال من حالة إلى أخرى ومن جلد إلى آخر. موت. للتغيير. أن لا تكون أثقل من سحابة ، لا أهم من زنبور. إنها طريقة للتعرف على بعضنا البعض واحترامهم. ممارسة التعاطف في بيئة مغلقة.
-ولعل من المناسب الآن التركيز على أحد أسس القصة التي تعطي الرواية جزءًا من عنوانها ، ألا وهو صعود المياه. وبالفعل ، فإن هذا الاستكشاف لذكرى رجل وتاريخ بلد ما يحدث على طول عبور مساحة لا نهائية من المياه ، بحيرة الأسد التي شكلها سد الطبقة الذي يسافر محمود على متن قارب. مياه الكارثة هذه التي يعبرها الشاعر تُعطى دون انحرافات كقصة رمزية لأنها تمثل الماضي الذي يبحثه محمود ، حرفيًا ورمزيًا. هكذا تقول أن “الصور ترتفع مثل البحر”. ومع ذلك ، وبعيدًا عن كونها مصدرًا للحياة ، فإن هذه الصورة للمياه تشير بشكل متناقض إلى ماضٍ مرادف للموت وخيبة الأمل: هل توافق؟ ألا يوجد أخيرًا القليل من صانع عجلات ستيكس في قارب محمود هذا؟
فكرت بشكل خاص في نوح ، لقول الحقيقة ، نوح حديث ، رجل عجوز من شأنه أن يسد الفجوة بين بدايات الإنسانية (سوريا هي الهلال الخصيب ، بدايات الزراعة والكتابة) وشيء من شأنه أن يستحضر نهايته. سوريا كرمز لعالم يتألم بشكل متزايد ، مدمر ، بدون شفقة. الحرب كدفن وغرق. وهذا هو السبب في أن قصة القرى المغمورة كان لها صدى قوي معي. عندما أطلق حافظ مشروع السد هذا وكانت البحيرة تغطي كل شيء (11000 أسرة) ، فإنه يعتقد أنه يفعل شيئًا كبيرًا ، بينما يغرق الناس ، وذاكرة الأماكن ، والثروات الأثرية والتراثية ، كل هذه الطبقات من الزمن مكثفة من أول ما قبل. – المدن الإسلامية لهذه القرى الصغيرة شبيهة بتلك التي ولد فيها محمود. تظاهر بفعل الخير ، ولكن زرع الموت. هذا ما يفعله بشار اليوم. كيف نرى أن الشخص الذي كان مقدرًا لمهنة طبيب العيون قد تدرب تمامًا على يد والده ، وأن الكلاب لا تصنع القطط. ويقول إنه ينقذ البلاد ، لكنه ينقذه فقط ، أسنان أسماء البيضاء وأطفاله ، بمن فيهم حافظ الأسد الصغير ، الذي أصبح مستعدًا بالفعل لتولي المسئولية. قارب محمود ، رمزياً ، هو المكان الذي ما زالت البشرية تعيش فيه ، حيث تتشبث. غصن الزيتون الذي جلبته الحمامة إلى نوح. أمل ، حلم ألا يكتسح كل شيء ويطغى عليه الغباء البشري. وقناعة محمود هي أنه يجب عليك التحدث ومخاطبة من تحبهم ، حتى لو لم تعد تراهم أو تلمسهم. نسعى جاهدين لتكون جيدا. ضد الحرب التي تدمر الماضي والحاضر والمستقبل ، يريد إنقاذ ما هو جيد في الإنسان. ولكن سؤاله هو: مع تصاعد العنف والظلم والانهيار العام ، هل سيكون لدينا وقت؟
-ومع ذلك ، مهما كان الأمر مجازيًا ، فإن صعود المياه هذا يشير أيضًا إلى قوة مادية ، القوة التي لا رجعة فيها للطبيعة التي يجب السيطرة عليها والتي يريد الإنسان أن يصبح سيدها من خلال السد هنا. ويمكن لمحمود أو صعود المياه ، بهذا المعنى ، أن تأخذ بعدًا يجب أن يقال أنه سياسي بيئي ، وهو ما يشهد على رغبة كل جزء من الإنسان في تقييد الطبيعة. وهذا هو العنف الذي تتعامل معه روايتك ، والتي تتحدث دون انتظار عن “ثورات تريد استعباد الطبيعة” ، تلك التي تجعل الإنسان “سيدًا وامتلاكًا للمياه”. هل هذا دفاع عن الطبيعة حيث كتبت محمود أو صعود المياه؟
شكرًا لك على قراءتها من هذا القبيل لأنه من الواضح ، في هذا “صعود المياه” ، أن هناك شيئًا يتجاوز سوريا ويمكننا اعتباره ، بشكل مجازي ، بمثابة العد التنازلي الذي ستوجهه الطبيعة إلى الذكر. إن هيمنة الطبيعة ، لتصبح سيدًا وامتلاكًا لما يحيط بنا ، من النباتات إلى الأراضي والتربة ، هو شيء ظل دائمًا عالقًا بجلد الإنسان ، قبل ديكارت بوقت طويل ، ولكنه يأخذ اليوم أبعادًا دراماتيكية نعرفها. كولومبيا البريطانية تحترق. سخونة سيبيريا. فيضان واسع الانتشار. لقد سئمت مثل محمود من رؤية هذه “الأشياء” التي لا تقول شيئًا ولا تطلب شيئًا تبيدها أوهام الإنسان بجنون العظمة. جيف بيزوس ورحلاته الفضائية! من يخبره أن هناك القليل منا في مأزق خطير هنا؟ محمود لا يحمل رسالة ، لكن لديه فلسفة شنتوية غير عنيفة. يرفض أن “يثقل كاهل العالم”. فراشة ، يحفظها من الغرق. الهندسة المعمارية البسيطة والمتقنة للزهرة مهمة بالنسبة له. لقد رأى عبر التاريخ مدى تأثير هذيان الطغاة والتعطش للسلطة على حياة البشر ، ولكن أيضًا على الحياة الحيوانية وغير الحيوانية ، والغابات ، والمساحات الخضراء ، والتربة ، والمياه. اليوم 90٪ من الناس في سوريا لا يملكون مصدرًا للمياه! لذلك لم يجعل هذا السد الشهير من الممكن تطوير الزراعة فحسب ، ولكن بسبب الحرب التي جعلت البيئة ضحية لها ، وبسبب الانسداد الذي تشغله تركيا في المنبع ، فإن مستوى نهر الفرات منخفض بشكل كبير والناس يموتون من العطش. محمود رجل عجوز تعهد بالبساطة والتعلق الصامت بالأرض. وبالنسبة له ، يأتي الشر من عدم قدرتنا على عدم القدرة على العيش دون السيطرة على “الآخر” ، أياً كان.
– يبدو أن هذا الاهتمام المستمر بالطبيعة يشير هنا إلى إحدى السمات التأسيسية لكتابتك ، تلك التي تشع من أمهاتنا ، وهي كتابة الحساس والحي. على الرغم من الموت الذي يطارد الشخصيات ، إلا أن جثث الثورة التي ترتفع إلى سطح الماء ، تقدم كتابة محمود أو صعود المياه قصة حساسة ، سريعة لإخراج المتناهية الصغر ، من أكثر المعاني هشاشة ، حركة العالم. كل شيء يحدث كما لو أن الكتابة ، التي تفشل أحيانًا في التحدث إلى الرجال ، والتي يعاني منها محمود ، يمكن أن تجلب الأمل في مخاطبة الطبيعة وكأنها تجعلها تهتز مرة أخرى ، كما لو أن كلمة القصيدة يمكن أن تذوب في الهواء لتعطي العالم. النفس الذي كان سيأخذه الإنسان منها. “أنا أهمس قصيدة للحشرات Je murmure un poème aux insectes ” ، هل يمكن أن نقرأ. هل هذه الرواية الحساسة هي التي تتصدر كتاباتك هنا؟
نعم. إنه شيء لا أستطيع العيش بدونه. أكتب برائحة الماضي ، وذاكرتي الحسية ، وكل شيء عالق بي عندما كنت طفلاً. ولقد جئت من قرية مليئة بالروائح الكريهة. أنا محاط بهم عندما أكتب. التبن ، الطين ، الروث ، منزل أجدادي. أعود إلى ليلة الطفولة عندما أكتب. مثل محمود عندما يغوص. أقوم بتحريك الأرض التي رأتني أنمو ، وأبحث عنها وتبدأ جميع أنواع الصور في التحليق. لكن من الواضح أنها أيضًا مسألة عزلة. أعني ، كلما تقدمت في السن ، كلما أميل إلى الانغماس في الغابة وفصل نفسي عما هو إنسان. أستمع إلى الأشجار والريح. لا حاجة للإذاعة. الريح في زقاق من أشجار الحور ، يبدو أننا قادمون إلى البحر ، أن البحر قادم إلينا! لا حاجة للتحدث بعد الآن. لاحظ أن هذه الكتابة الحساسة تقع في قلب الشعر السوري والشرق أوسطي. عندما تقرأ شخصًا مثل سهراب سبهريSohrab Sepehri ، حاضر جدًا في الكتاب ، تدرك أن شعره يصل إلى الأشياء الصامتة والصغيرة في الطبيعة. هذا ما أحبه في هذه التقاليد الشعرية ، حقيقة أنها تستحضر صورًا وأحاسيس رائعة بوسائل ساخرة. “سأزرع القرنفل على كل جدار. عند أسفل كل نافذة سأغني شاعرًا. سأقدم لكل غراب شجرة تنوب. أقول للثعبان: ما روعة الضفدع! سوف أتصالح. سوف أدعك تعرف. سأمشي. سوف أبتلع الضوء. أود ذلك. »
-أخيرًا ، سؤالي الأخير يتعلق بالمرونة العامة التي يتميز بها محمود أو صعود المياه. إذا كان النص ، كما يشير الغلاف ، يقدم نفسه كرواية ، ويكشف عن رواية ملحمية وقصة نادرة من القوة المذكرة ، فيجب الاعتراف بأن محمود قد أُعطي كقصيدة ، قصيدة عريضة ذات شعر حر ، على جمل تتخللها الأوامر والرفض. لماذا كان هذا الشكل الشعري ضرورياً؟ هل كان من أجلك أن تجد ، بطريقة الإلياذة ، ملحمة تعيد بناء تاريخ شعب؟ أخيرًا ، كيف كان الشعر السوري مصدر إلهام لك هنا؟ تقتبس أيضًا ماياكوفسكي: هل أثر شعره فيك؟
هذا غريب. بقدر ما وثقت نفسي كثيرًا قبل أن أبدأ ، على المستوى الرسمي ، كان الأمر بديهيًا للغاية. لم أفكر في ذلك. قلت لنفسي إن هذا النموذج ، مع هذه القفزات والإصدارات ، سيجعل من الممكن الشعور بواقع بلد متأرجح. كان لا بد للقارئ أن يدخل حياة محمود في قلبه ، لأنه من هناك ، إذا تأثر بقصته وقصة زوجته سارة ، فلن يكون بعد الآن غير حساس لما يحدث في هذا الجزء من العالم الذي لا يتم الحديث عنه كثيرًا. ولم يعد قادرًا على إغلاق عينيه. هذا هو المكان الذي يكون فيه الشعر (للروس والسوريين وما إلى ذلك) ثمينًا. تخبر العالم في تحولاته الصغيرة ، تجعلنا نشعر بذلك. وبالتالي ، يدفعنا إلى المزيد من الإنسانية والتفاهم. كان هذا هو الانحياز لهذا الكتاب. كان بإمكاني تجاوز الخيوط السردية ومضاعفة الشخصيات وإنشاء بنية معقدة ، لكن لا ، أردت البقاء مع محمود. فقط هو.
إنسان واحد، شوهد عن قرب. لمحاولة جعل مصير الآخرين حقيقة. هذه بالنسبة لي “مهمة” الأدب الوحيدة. اقترح قصصًا تسمح لنا برؤية ما اختفى فينا والشعور به ، إما لأننا رأيناه كثيرًا ، أو لأنه قيل لنا بكلمات فارغة تمامًا ، كلمات لا تعني شيئًا. إن إعادة الكلمات إلى قوتها “السحرية” ، قوة التعبير عن العالم الخارجي وحقائقنا الداخلية بكل تعقيداتها وغموضها وتناقضها ، هو ما فعله محمود وما يفعله الشعراء منذ ذلك الحين .. من فجر الزمان. وهم يفعلون ذلك لماذا؟ لكي لا تصاب بالجنون. نصاب بالجنون عندما نسمع بشار الأسد يتحدث عن الديمقراطية. ونصاب بالجنون عندما نسمع قادتنا يتحدثون عن البيئة. والعالم المعاصر عبارة عن طريق سريع مكون من عشرة حارات للتداول الحر للخوف والجنون. ولذا فإن حفظ الشعر لا ينقذ أي شيء. إنه لحفظ القوة لمعارضة هذه الحكاية التي يسميها المرء “الواقع” حقيقة أخرى ، أو على الأقل استبداله بمكان أكثر إنسانية ، ومزيدًا من التعاطف والحب الأكبر. إذا لم أتوقف عن الكتابة ، فهذا فقط من أجل ذلك ، لأنني ما زلت أعتقد أنه يمكننا مداواة المستقبل ، لكننا سنقوم بمعالجته فقط بالكلمات التي تربطنا ببعضنا البعض. كلام سلام.
أنطوان ووترز ، محمود أو صعود المياه ، فيردير ، آب 2021 ، 144 صفحة ، 15 يورو و 20
*-Antoine Wauters : « Pour écrire, il faut un déficit d’être. Ne pas pouvoir ou ne pas aimer dire je » (Mahmoud ou la montée des eaux)
*انطولوجيا














